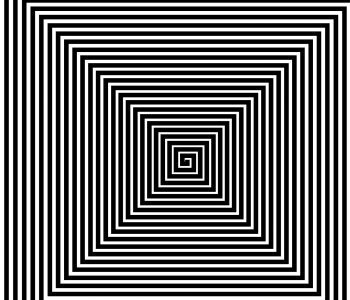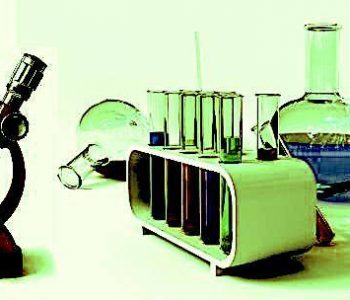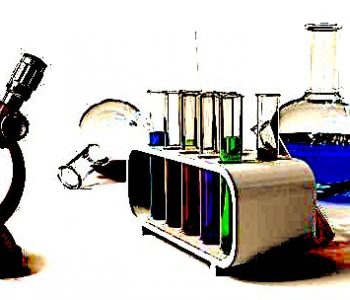في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
هل يمكن أن تتسبب رفة جناح فراشة في البرازيل في إحداث إعصار بتكساس؟
كان هذا ما اقترحه إدوارد لورنز؛ عالم الرياضيات، عنوانًا لكلمته في الاجتماع رقم 139 للجمعية الأمريكية لتقدم العلوم عام 1972. بعدها بنصف القرن، قد يكون السؤال “هل يمكن لحساء خفاش في يوهان أن يقتل الآلاف في إيطاليا؟“.. بالطبع ما يزال مصدر فيروس كورونا المستجد كوفيد–19 مجهولاً أو غير مؤكد، لكن انتشاره السريع لا بد وأن يلفت نظرنا إلى مدى ارتباط كل شيء على وجه الأرض.. والأوبئة على مر الأزمان كان لها الأثر نفسه؛ فالطبيعة التي تظهر من وقت إلى الآخر بكارثة من هذا النوع لها شريك أساسي، وهو الإنسان.. فالأمراض لا تصيب المجتمعات بطرق عشوائية وفوضوية، كل الأحداث مرتبة سلفًا؛ لأن الميكروبات تتوسع بشكل انتقائي، وتنتشر لاستكشاف المنافذ البيئية التي أنشأها البشر؛ فالأوبئة ليست أحداثًا عشوائية تصيب المجتمعات بشكل مفاجئ دون سابق إنذار.. بل ينتج كل مجتمع ينتج نقاط ضعفه الخاصة..
وهذا ما أكد عليه أنجيليوس تشانيوتيس؛ المؤرخ اليوناني في حواره مع جوان ليبمان المنشور على موقع معهد الدراسات المتقدمة ببرينستون/ نيو جيرسي. مع ظهور علماء من شتى التخصصات في وسائل الإعلام لمد البشر بالمعلومات الموثوقة بين سيل التقارير الزائفة التي تغرق وسائل التواصل صباحًا ومساءً..

أنجيلوس تشانيوتيس
تحدث تشانيوتيس عن الأثر طويل المدى الذي تنمو جذوره في أثناء الوباء وتمتد لتُنبت بعد انقضائه بسنوات، فيتغير سلوك البشر الاجتماعي والديني وتوجهاتهم السياسية أيضًا.. هنا أشار تشانيوتيس إلى النفوذ التي يتمتع به العلماء والمفكرون في الصحة والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس، وكذلك المؤرخون وغيرهم في أزمنة الوباء وكيف سيؤثر هذا على تحريك الرأي العام بعد انتهائه في كل الاتجاهات إن احتفظوا بتلك النفوذ.
أكد تشانيوتيس على أهمية تعزيز عمل المنظمات العالمية ودعمها والاستفادة من مميزات العولمة لمواجهة الوباء وما يتبعه من مشكلات الفقر والغذاء. حاولت جوان ليبمان في هذا الحوار معرفة المزيد عن ربط تشانيوتيس وباء فيروس كورونا المستجد بالأوبئة التاريخية، وإمكان استنباط آثاره بعيدًا عن الأرقام والإحصاءات، وآثاره على سلوك الإنسان اليومي وعلاقاته ومعتقداته وأفكاره.
جوان ليبمان: ما نوع الأبحاث التاريخية التي تقوم بها في معهد الدراسات المتقدمة، وكيف يمكن أن تنسحب على العالم المعاصر؟
أنجيلوس تشانيوتيس: الموضوعان متصلان. كباحث في التاريخ القديم، أحاول دومًا اكتشاف بعض الطرق للربط بين ما أقوم به من بحث في الماضي وما يحدث الآن. يوجد الكثير من أوجه الشبه بين ما أتوصل إليه بأبحاثي وأحداث العالم المعاصر.
– كتبتَ أخيرًا مقالاً تقارن فيه الأوبئة القديمة بوباء فيروس كورونا المستجد. هل يمكنك توضيح ذلك؟
– أول من دوَّن سردًا مفصلاً حول وباء هو ثيوقيديدس (مؤرخ إغريقى شهير، صاحب كتاب تاريخ الحرب البيلوبونيسية)، الذي كتب قبل الميلاد بـ 400 عام يروي أحداثًا وقعت في عام 430 قبل الميلاد. انتقل الوباء من مصر إلى أثينا؛ وكان مدمرًا، لكنه لم ينتشر في جميع بلاد البحر المتوسط.. وأثَّر على بعض أماكن أخرى، إلا أنه اقتصر على منطقة محدودة نسبيًّا.
– وهل أصيب ثيوقيديدس بالوباء أيضًا؟
– أجل.. وكان هذا مهمًا للغاية، لأنه وصف الأعراض؛ وبهذه الطريقة يحاول الأطباء المعاصرون تحديد نوع المرض القديم. الاحتمال الأرجح، أنه كان حمى تيفوئيد، لكن بعض الباحثين لديهم شكوك أنه ربما كان صورة مما نسميه اليوم إيبولا، وهو مرض فيروسي.
ولم يكن ثيوقيديدس – حسب علمنا – أول إنسان يصف المرض فحسب؛ بل أول من وصف أثره على السلوك البشري أيضًا، فهو يصف على سبيل المثال كيف انصرف الناس عن الاهتمام بممارسات الدفن، لكثرة الجثث. كانوا بالكاد يجهزونها للتخلص منها. وهذا بالطبع يذكرنا بالصور التي شاهدناها لقوافل نقل الجثامين في إيطاليا أو إسبانيا، بينما يعجز الناس عن توديع أحبتهم.
ما لم يصفه ثيوقيديدس، لكنه شيء سنلاحظه بعد وقوع الوباء بعدة سنوات، هو الرجوع إلى الدين. عبدة أَسْكْلَيْبِيُوس، إله الطب، ظهروا في أثينا نتيجة لهذا المرض تحديدًا، بعد ظهور الوباء بعشر سنوات. وكان رجاؤهم أن يرفع الرب الوباء ويجنبهم المزيد من الأمراض.
المثير أن الجميع تأثروا بهذا التوجه، حتى المثقفون، فمن روَّج لهذه العبادة لم يكن سوى الشاعر التراجيدي سوفوكليس؛ الذي حمل تمثال أَسْكْلَيْبِيُوس إلى منزله، واستضاف الإله الجديد، حسب زعمه، حتى ينشئ له معبدًا.
أعتقد أن هذه أمثلة لافتة لكيفية تأثير الوباء على السلوك في حالتنا المعاصرة. لستُ نبيًّا فلا أستطيع إخبارك بالأثر المحتمل، فلم ينته الوباء بعد على أي حال، لكن بالطبع سيكون له تأثير ما.
– يتحوَّل الناس إلى الأديان بعد الأوبئة، أترى هذا يحدث الآن؟
– المثير في تلك الأوبئة أنه في إمكانك رصد سلوكيات متناقضة ومتضاربة؛ بعض الناس رجعوا إلى الدين لظنهم بأن الأوبئة عقاب على خطاياهم؛ عقاب إلهي إن جاز التعبير. بينما يرى آخرون أنه لو مات الصالح والطالح بسبب المرض على حد سواء، فلا وجود لإله، لأنه لو كان موجودًا سيميز بينهما على الأقل.
بعض الناس يبدون التضامن والاهتمام. ويصف ثيوقيديدس حالات مشابهة؛ أولى الوفيات كانت من بين الذين حاولوا تقديم المساعدة، ثم لدينا رد الفعل المعاكس؛ الأنانية المفرطة: “سأموت على أي حال، فلماذا لا أستمتع بالحياة ما دمتُ حيًّا، وأبدد ثروتي في الحفلات المترفة، ومراقصة الفتيات، وما إلى ذلك، من يعلم إلى متى سأظل حيًّا!”.
هذا بالضبط ما نراه من ردود فعل اليوم؛ من ناحية، نرى عقلية الهامستر الأنانية “لأشتري كل ما يمكن من أوراق التواليت“، ومن ناحية أخرى، ستجدين حالات التضامن: “كيف يمكنني إحداث فارق في وقت كهذا؟ كيف أساعد الآخرين؟“.
– تحدثتَ أيضًا عن دور العولمة ومخاطر العزلة السياسية في زمن الوباء؟
– أعملُ على البحث في التاريخ اليوناني منذ عصر الإسكندر الأكبر، الذي غزا قسمًا كبيرًا من العالم المعروف حينها، وحتى نهايات العصر القديم المتأخر. إنه عصر يشبه عصر العولمة بصورة كبيرة. نحن نتكلم عن ست درجات من التباعد: أي أن كل فرد تفصله ست درجات عن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية على سيبل المثال. يمكننا ادعاء أن المرة الأولى التي وقع فيها شيء مماثل كان في زمن ما بعد دولة الإسكندر الأكبر.
ما يزعجني حقًا، أن الناس لا يتعاملون مع العولمة باعتبارها ظاهرة تاريخية بل كداء يمكنهم علاجه، هذا ما يخلق فكرة العزلة، كأن يبني الإنسان جدارًا يفصل به دولته عن بقية العالم على سبيل المثال؛ وهذا إهمال فادح للتاريخ، وغير مُجدٍ، فالفيروس لا يحمل جواز سفر، ولا يعنيه إطلاقًا حظر السفر أو أيًا ما كان. وأنا مؤمن جدًا بفكرة الاتحاد الأوروبي، وشعرت بخيبة أمل شديدة لرفض دول الاتحاد الأوروبي التعاون وقت وقوع الأزمة؛ هناك افتقار للتنسيق والتضامن، فبعض الدول أغلقت حدودها وبعضها الآخر لا. ارتدى المواطنون في بعض الدول الكمامات، وفي دول أخرى لا. عشوائية الإجراءات هذه تمثل رد فعل غير منسق ولا محكم لمواجهة مشكلة تواجهها جميع هذه الدول على حدٍ سواء.
– لقد أشرت إلى تكرار الموضوعات المتعلقة بالأوبئة عبر التاريخ، الطاعون الأنطوني على سبيل المثال.. هل يمكنك الحديث عنه بتفصيل أكبر؟
– حكمت الأسرة الأنطونية بدءًا من تراجان وحتى كومودوس في القرن الثاني الميلادي. لدينا الكثير من المعلومات حول الوباء التي وقعت بين عامي 165 و180م، التي وصفها أعظم أطباء ذلك العصر جالينوس. فمن ناحية، لدينا جهود التفسير العلمي للمرض ومحاولة إيجاد العلاج، ومن ناحية أخرى، قصد بعض الناس الكهنة لمعرفة ما يجب عليهم فعله لمواجهة المرض.
هناك رسائل أبوللو لكهنته منقوشة على جدران معابده في كلاروس بآسيا الصغرى. فحوى إحداها، على سبيل المثال “احضر تمثال آرتميس.. ستحرق بمشاعلها العرائس الشمعية التي صنعها الساحر الذي أطلق هذا المرض“.
لدينا إذن النهج العلمي من ناحية: “ما المرض؟ وكيف يمكنني التعامل معه؟“، ومن ناحية أخرى، النهج الديني. “ثمة خطب ما. هذا فِعل الساحر الذي صنع دمى من الشمع، ودفنها في مكان، ثم ألقى علينا جميعًا تعويذة الشر“.
في الواقع، هذا التناقض هو ما يجعل دراسة أزمات كهذه مشوقة للغاية. لا يختلف الأمر كثيرًا في عالمنا المعاصر، فنحن نشهد الآن ردود فعل متباينة تجاه الأزمة.
– أين ترى أوجه التشابه الأوضح بين العالمين القديم والمعاصر من حيث التعامل مع الوباء؟
– أظن أن أوضح أوجه التشابه هو نظريات المؤامرة. إرجاع ما يحدث إلى أمر خارج عن سيطرتك، ولم يكن بإمكانك توقعه، ومن ثَم أنت غير مسؤول عن حدوثه. ربما يمكننا القول بأنه هروب من الواقع. فالواقع يقول إن دلائل ظهور المرض كانت واضحة في وقت مبكر جدًا لكن تم تجاهلها؛ سواء تجاهلها في الصين، أو أوروبا، أو الولايات المتحدة أيضًا.
لذا فالطريقة الأسهل للتنصل من المسؤولية هي قول، “الصينيون هم من أطلقوا الفيروس من معمل.. إنها محاولة لتدمير الاقتصاد الأمريكي..” إلخ. هل بإمكاني إثبات خطأ كل هذا؟ بالطبع لا. لكن المثبت أنه كانت هناك تحذيرات مبكرة وتم تجاهلها.
هذا التعامل يمكن تفسيره سيكولوجيًّا، فردود فعل البشر تجاه كوارث كهذه يشبه إلى حد كبير تعاملنا مع الموت. في البدء، الإنكار: ترفض تصديق أن هذا قد حدث. ثم الغضب: تريد أن تعرف من المسؤول. ثم التفاوض: لا بد من إلقاء اللوم على أحد. ثم القبول في بالأمر. هذا بالضبط ما يحدث، “ما الذي يمكنني فعله؟“.. إلخ. بعدها، تشمر عن ساعديك وتبدأ العمل لمواجهة المشكلة. أعتقد أننا نشهد كل ردود الفعل تلك في مواجهة الوباء.
– ما الذي يمكننا تعلمه من العالم القديم ويساعدنا على حل مشكلاتنا المعاصرة؟
– ما نتعلمه من العالم القديم يتجاوز كيفية إيجاد الحلول الصحيحة إلى كيفية تجنب الأخطاء. العالم القديم لا يقدم حلولاً. ما يقدمه هو غذاء للفكر، إنه يثير أسئلة.
على سبيل المثال، حقيقة أنني كباحث في التاريخ القديم أنظر إلى مسألة الفيدرالية، والأزمة بين العلم والحكومة، أو العلم والخرافة، وردود الفعل المختلفة تجاه الموقف، يحكمها أنني أرى وقائع عامٍ أو اثنين من منظور تاريخ يمتد لآلاف السنين. وهذا يمنحك عادةً رؤية مختلفة. لذا، فالتاريخ لا يقدم إجابات، ولا نبوءات، ولا علاجات، إنه يقدم نهجًا، ووجهة نظر تجاه الأزمات المعاصرة.
هذا لا ينطبق على الوباء فحسب؛ بل ينطبق على الشعبوية أيضًا على سبيل المثال. لا يوجد ما يعادل الشعبوية تمامًا في العالم القديم، لكن الديماجوجية كلمة نشأت في أثينا القديمة بسبب وجود شعبويين. لا يمكننا العثور على أوجه شبه دقيقة، لكن يمكننا ملاحظة ظاهرة ونستعد بصورة أكبر لكشف ظواهر مماثلة في عالمنا الحديث.
– جزء من بحثك الأخير يركز على دور العاطفة في مسار التاريخ. ما الصلة بينهما؟
– لفترات طويلة، تجنب المؤرخون دراسة العواطف. لكن منذ نحو عشرين أو ثلاثين عامًا حدث تحوُّل ملحوظ؛ بدأ عدد من المؤرخين محاولات لفهم تأثير العاطفة على مسار التاريخ. وسيمكننا فهم الكثير مما نشاهده اليوم، ليس فقط في تصرفات الشعوب، بل في تصرفات رجال الدولة أو سوق الأسهم، في الخطاب العام أو في وسائل الإعلام، لو أننا أخذنا بعين الاعتبار العواطف وأهميتها. ما نمر به هذه الفترة يقوي اعتقادي بأن العواطف عامل مهم للغاية لفهم التحولات التاريخية الرئيسية.
– هل توجد أوجه تشابه بين دور العاطفة في التاريخ اليوناني القديم والعالم المعاصر؟
– بالطبع، خصوصًا في استغلال الخوف؛ فهو عاطفة قوية تظهر كثيرًا في الخطاب العام. الخوف هو العاطفة التي حسمت نتيجة الانتخابات الرئاسية قبل أربع سنوات؛ الخوف من المهاجرين، الخوف من الانهيار الاقتصادي، الخوف من الصينيين، وما إلى ذلك.
الظاهرة الأخرى، تتعلق بالخوف أيضًا، هي الرجوع إلى الدين: الخوف من الإله. الخوف من ارتباط ما حدث بما ارتكبناه من آثام وخطايا بشكلٍ ما. الاعتقاد بأن ما حدث هو صورة من صور العقاب. وهذا ينطبق على جميع الأوبئة. إن جزءًا من الطبيعة البشرية هو محاولة فهم شيء مرعب وغير مفهوم.
هذا توجه عام قد يتوقعه المرء في زمن العولمة. العولمة القديمة أيضًا تطرحه، لكن لماذا؟ لأن العالم يصير واحدًا، أنت تدرك مدى ضآلتك في هذا العالم. وهذا لا يخلق ميلاً إلى الاتحاد مع الآخرين، بل إلى الانعزال، تشعر بأنك وحيد في هذا العالم، فتنصرف إلى قوى أخرى يمكنها مساعدتك. قد تكون تلك القوى أيديولوجية في بعض الحالات، وفي حالات أخرى تتمثل في الدين.
هذا ما تمليه الأديان دومًا، جميع الأديان تقريبًا: الخوف من قوى علوية تُعاقِب، والأمل الدائم في أن تلك القوى العلوية ذاتها ستحفظك في هذه الحياة، وتعدك بحياة بعد الموت.
– ماذا تعني بكلمة ديماجوجية؟
– أصلها يتكون من كلمة “ديمو” بمعنى الشعب، و“آجو” بمعنى حكم، وقد تكونت الكلمة في القرن الخامس قبل الميلاد. وهي لا تعني الحكم؛ أي أن تكون قائدًا، لا، لقد استُخدِمت عادة في حالة أن تقود بغلًا، أي تسوقه. لا يحدث هذا حين تقود شعبًا كحاكم منتخب، لكن حين تسوقه باختلاق أعداء لا وجود لهم، بالتلاعب بالعواطف، باستخدام الترهيب والترغيب، والسخط على جناة خياليين، وما إلى ذلك. تلك هي السمات النمطية للديماجوجية.
يستخدم الديماجوجي وسائل إقناع تبدو منطقية، لكنها لا تستند بالضرورة إلى حقائق. سمة أخرى من سمات الديماجوجي هي محاولة خلق توازن بين زعم التواضع والمسافة الفاصلة؛ ترامب خير مثال على ذلك، إنه مليونير لكنه يدعي اهتمامه بعمال المناجم. لم يلتحق بالجيش قط، لكنه يضع أمريكا أولًا. ويمكنني سرد المزيد.
لذا، هذا هو التوازن المنشود: من ناحية، تخرج على الشعب معلنًا “أنا واحد منكم، أتفهم مخاوفكم، أنا من يهتم بكم“، ومن ناحية أخرى تبقى على مسافة كافية تبعث على الاحترام.
– هل يزداد الديماجوجيون قوة في أوقات الوباء؟
– في الأزمات، يميل الناس إلى اتباع زعيم شعبوي، لكن الشعبوية والديماجوجية موجودان في كل وقت. في أثينا، على سبيل المثال، ازدهرت الشعبوية خلال أعظم حرب خاضها الأثينيون، وخسروها، وهي الحرب البيلوبونيزية.
يمضي كل شيء بسلاسة ما دام الزعيم الشعبوي أو الديماجوجي يستطيع الوفاء بالوعود التي يقطعها على نفسه. ويستمر الأمر حتى اللحظة التي يعجز فيها عن ذلك. على سبيل المثال ادعى الإعلام التركي المؤيد لأردوغان أن الأتراك محصنون ضد فيروس كورونا بسبب حمضهم النووي، وادعى ترامب في الولايات المتحدة أن الفيروس خدعة، فلو أنهم عجزوا عن تولي الأمر، لو شهد الناس موت أقاربهم ومعارفهم، لو شهدوا انهيار الاقتصاد، لو أنهم رأوا بأعينهم تورطهم في المسألة، سيخسر الديماجوجي قناعه، بل وربما منصبه.
بطبيعة الحال، مشكلة الديماجوجية أنها تدرب الناس على حصر تفكيرهم في الخصوم والأعداء. والسلاح الأخير للديماجوجي في جميع هذه الحالات، أن يقول، “في الحقيقة هذا ليس خطئي.. إنه خطأ الآخرين.. خطأ الأطباء لأنهم لم يقدموا لي النصح اللازم.. أو خطأ الصينيين.. إنه خطأ بقية العالم.. لقد أخبرتكم بالحقيقة فعلًا، لكن الجميع مُلامون“.
هذه إحدى التنبؤات القليلة التي يمكنني تقديمها. هذا بالضبط ما سنراه في المستقبل القريب من جميع رجال الدولة الذين لم يتصرفوا بشكل مسؤول منذ البداية؛ سيحاولون العثور على كبش لفداء لإخفاقاتهم.
– ما توقعاتك لما نحن مقدمون عليه؟
– يخبرني المتشائم بداخلي أننا سننسى هذا كله بعد بضع سنوات من الآن، وسنعود إلى شؤوننا المعتادة، لن نتعلم الدرس الذي يجب علينا تعلمه، وهو تعزيز المنظمات الحكومية الدولية.
بعد نشر مقالي على الموقع الإلكتروني للمعهد، هدد ترامب بوقف تمويل منظمة الصحة العالمية. وأعتقد أن هذا يخبرنا بكل شيء. لقد طالبتُ بدعم أكبر وشكوك أقل وعدم تقويض عمل المنظمة، لكن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا. يمكننا تغيير هذا فقط لو اتخذنا الإجراءات اللازمة الآن، مع حداثة الأمر، ونحن متأثرون به بالفعل، فلا ننتظر حتى اكتشاف علاج أو لقاح، حينها لن يهتم أحد بدعم منظمة الصحة العالمية، وسينسى الناس ما حدث.
يذكرني العالم الحديث بأحد أفلام الكوارث من إنتاج هوليوود، إذ يتوقع العلماء حدوث شيء مروع، ربما بركان أو سقوط نيزك على الأرض، ويتم تجاهلهم. تأتي أفلام هوليوود دائمًا بنهاية سعيدة. والناس يدركون ذلك ويعلمون بوجود تعاون دولي لمواجهة الكائنات الفضائية أو أيًا ما كان.. في التاريخ، النهايات السعيدة غير مضمونة.