في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

شروط اللياقة الاجتماعية
كمال في العشرين من عمره.. هرب من إحدى مدارس الأيتام بحثًا عن مسكن، وبعد طول عناء وجد ملاذه في سطح أحد محلات التليفونات المحمولة.. لكن هذا السطح الذي يقع في حي راق، لم يعجبه. فدفعه فضوله إلى الدخول عبر الحديقة إلى مطبخ المنزل المجاور، حيث وجد ضالته وكل ما كان يفتقده؛ من طعام وقصص عائلية.
في البداية كان يعمل في سوق للخضار، ثم اكتفى بملذة العيش في هذا المنزل الواسع، يأكل مما يجد في الثلاجة، ويعد الشاي بعد أن ينام أفراد العائلة الخمسة: الوالدان وثلاثة فتيات.
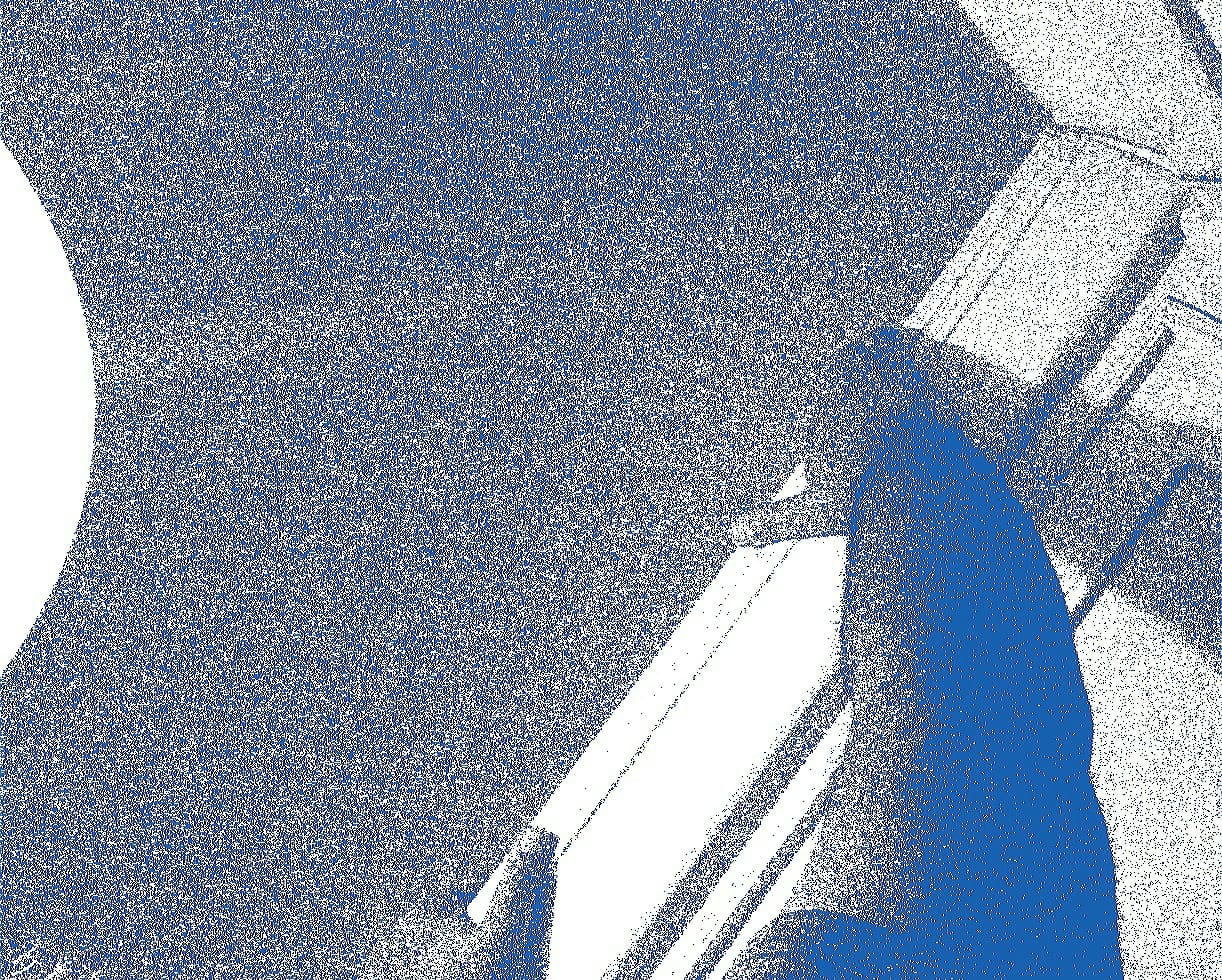
كمال كان مهووسًا بالمخللات، وهذا السبب وراء إقامته نهائيًّا في المنزل.. لأن التهامه جميع قطع المخلل في الثلاجة قاده إلى الإقامة في علية (سندرة) المطبخ، والعيش معظم الأربعين يومًا التي أمضاها في المنزل.
شعرت الأم بأن الثلاجة تفرغ سريعًا، لكنها أرجعت ذلك إلى سن المراهقة الذي تعيشه بناتها الثلاثة ويجعل شهيتهن مفتوحة للطعام.
تجرأ كمال ذات مرة وغسل الصحون المتسخة، وذلك بعد أن قرر غسل صحن أكل فيه، لكن كرم أخلاقه دفعه إلى غسل كل الصحون، الأمر الذي قابلته الأم بامتنان لبناتها، معتقدة أنهن غسلن الصحون محبة لها.
في إقامته لساعات طويلة في “السندرة” استمع كمال إلى قصص العائلة وتفصيل حياتها وأسرارها.. وأوشك أكثر من مرة على التدخل لحل مشكلات بين أفراد العائلة، لولا ضيق الحال وظروف الضيافة الغريبة.
كان من الممكن أن تستمر إقامة كمال مع العائلة لفترة أطول، لولا مصادفة اللقاء بينه وبين أصغر البنات (13 سنة) في المطبخ. ذلك أنه اعتقد أن هدوء مساء الخميس يعني أن الأسرة خارج المنزل، فنزل من مخبئه.. وتمشي على راحته، ليتفاجأ بالفتاة في أحد الممرات..
وعلى الرغم من محاولته إزالة الخوف.. او تهدئته، وعلى الرغم من حالة الألفة التي يشعر بها تجاه الأسرة من طرف واحد؛ طرفه، سارعت الفتاة بإبلاغ أبيها الجالس على جهاز كمبيوتر. وهنا تعقدت حياة كمال؛ فالأب كرجل عادي أبلغ الشرطة، والضباط أعدوا كمينًا لاصطياد كمال الذي هرب بعد أن أفزع الفتاة وأبيها. إلا أن الحنين دفعه بعد ساعات قليلة للعودة إلى مكان ما بالقرب من العائلة.
قال كمال لمحققي الشرطة “لم أكن أنوي السرقة..”، لكنهم لم يفهموه حين حاول الشرح “لقد شعرت خلال الأربعين يومًا التي قضيتها هناك بأنني واحد من العائلة.. لقد كانوا يتركون في المطبخ بعض الأموال والخواتم.. لكنني لم أسرق شيئًا.”
كمال أصر في التحقيقات على عدم نيته السرقة “كيف أسرق أهلي!”، لكن الشرطة أصرت، من جانبها، أنه كان يخطط لـ” ضربة العمر”. .
حدث هذا في القاهرة منذ سنوات ليست قليلة..(2002)

كمال .. يصلح بطلاً لأفلام فى السينما وحلقات تليفزيون.. وروايات فى الأدب … ليس بطلًا مأساويًا مثل سعيد مهران في رواية نجيب محفوظ “اللص والكلاب”.. ولا بطلًا شعبيًّا مثل روبن هود.. أو أدهم الشرقاوي في الحكايات الشعبية.. بل هو أقرب إلى أبطال يحدثون صدمات خفيفة الظل.. تكشف عن الخلل الاجتماعي والسياسي.. فالسرقة هنا اقتناص حق ضائع.. أو أمنية محروم.. وليست مجرد جريمة يعاقب عليها القانون.. كمال يشبه أبطال الكاتب التركي عزيز نيسين الذي يمتلك مهارة في استخدام السخرية.. سلاح الضعفاء في مجتمعات العدالة المهزوزة.. والحرية الغائبة.
كثيرًا ما كتب عزيز نيسين عن اللصوص؛ في إحدى قصصه كان اللص: قطة.. نعم قطة ألتقطها عجوز صاحب مقهى في قرية صينية.. يعيش أغلب سكانها من صيد السمك.. لم تكن القطة محبوبة العجوز وحده.. بل محبوبة زبائن المقهى كلهم.
لكن القطة كان عندها عادة سيئة وهي السرقة؛ كل الجيران شكوا منها وهي لم تبلغ بعد شهرها السادس.. كانت تخرج إلى عملها كل صباح، مثلها مثل أي موظف شريف، ولا يأتي الظهر إلا وتكون قد زرعت الفوضى في أرجاء الحارة.. لم تترك مطبخًا لم تدخله ولا نملية لم تلخبطها.
ولم يمر يوم دون أن تفتح غطاء قدر يغلى على الموقد لتأخذ منة قطعة سمك ساخنة.
وعلى الرغم من أذى القطة كان الجميع يحبونها.. إذ كانت تقوم بسرقات محبوكة يقدرها السكان لسبب بسيط؛ أنها لم تقم أي اعتبار للشخص الذي يسرق في تلك القرية.. وفى عرف هذه القرية: السرقة بذاتها ليست أمرًا معيبًا.. المعيب أن يُضبط اللص في أثناء قيامة بالسرقة.. إذ ينتج عن ذلك أن يُهان اللص أمام أهل البلدة ولا يستطيع أن يتحمل نظراتهم لأنه لم ينجح في عمله. ووصل الأمر إلى أن سكان القرية لا يزوجون بناتهم للشاب الذي لا يسرق.. لأنه لن يستطيع الإنفاق على بيته.
وهكذا أصبحت القطة الحرامية رمزًا للقرية.. ومع مرور الزمن تحولت إلى كائن أسطوري. وعندما بلغت الرابعة عشرة نزلت ستارة على عينيها.. فتابعت مهنتها بعينين لا تبصران.. وفي يوم من الأيام وجدوا جثة القطة أسفل أحد الجدران العالية.. فقد أسلمت روحها في أثناء عملها. بكاها أهل القرية وأعلنوا الحداد.. وأقيمت لها مراسم جنائزية ضخمة.. واجتمع على قبرها الأطفال والشيوخ والشبان.. وبعد موتها غطى الصمت القرية.. لكن بعد مرور شهرين حدثت المعجزة: ارتفع بناء ضخم فوق قبر القطة المسكينة.. وفوقه لافتة كبيرة: مصلحة الضرائب.. وهنا شعر السكان بأن روح القطة الحرامية بعثت من جديد!
كتب عزيز نسين حكاية قطة الضرائب ضمن مجموعة قصص نشرت بين 1955 و1957، وصادفت مرحلة عجيبة في تاريخ الحرية بتركيا.. ونشرها، كعادته، باسم مستعار لكاتب صيني، وكأنها قصة مترجمة!
كان عزيز نيسين كاتبًا مناسبًا لدول تنمو فيها سلطة جبارة تمتلك العالم وتصادره.. ثم تحوِّله إلى ملكية خالصة.. وهي فكرة من العصور الوسطى.. لكنها ما تزال تقيم في مجتمعات تبدو مثل سيرك كبير يشاهد العالم فيها ماضيه دوريًّا، كي يضحك. والضحك في هذه الحالة أقرب إلى الكوميديا السوداء.. مخلوط بالمرارة.. والسخرية هي سلاح الممنوعين من الكلام والتعبير وإبداء الرأي في مواجهة دولة السلطة الجبارة.. في هذه الدول؛ الحكام قساة القلب، وجبروتهم لا يمكن الاقتراب منه.. وهذا ما يجعل الكتابة الساخرة سلاح الضعفاء في مواجهة الطغاة.. وهو ما جعل عزيز نسين زائرًا دائمًا للسجون؛ إذ وصل مجموع زياراته للسجون إلى خمس سنوات ونصف السنة.. من بينها ستة أشهر بسبب الملك فاروق؛ الذي قدم شكوى للحكومة التركية ادعي فيها أن عزيز أساء إليه هو وشاه إيران في مقالاته!

لا أعرف أين كمال الآن.. وبعد ثورة تكسرت فيها الهندسة الاجتماعية ويعاد بناء حطامها .. أو الممرات المسدودة في الحياة.. لا أعرف ماذا ترك كمال من ذكريات لدى العائلة.. لكنني تذكرت الحكاية كلها عندما قرأت عن طالب الحقوق المتفوق الذي رفضت أوراقه التي قدمها للعمل في النيابة، لأنه”غير لائق اجتماعيًّا”، وعدم اللياقة التي سدت الممرات أمام المتفوق كانت عائلته التي لم يحصل فيها الأب، ولا الأم بالطبع، على شهادة جامعية..
هل كان مطلوبًا من المرفوض أن يبحث عن عائلة أخرى؟ وهل الممرات مفتوحة فقط أمام طبقة نموذجية يهندس المجتمع نفسه حسب شروطها.. وتقام حولها الأسوار والقوانين وشروط اللياقة؟
ممرات مسدودة.. ترسم المصائر وتحدد المستقبل.. وقبل أن تتخذ الحكاية نقاشًا اجتماعيًّا سياسيًّا قفز بها والد طالب الحقوق المرفوض؛ إلي حدود الميلودراما …..ومات من الجلطة.