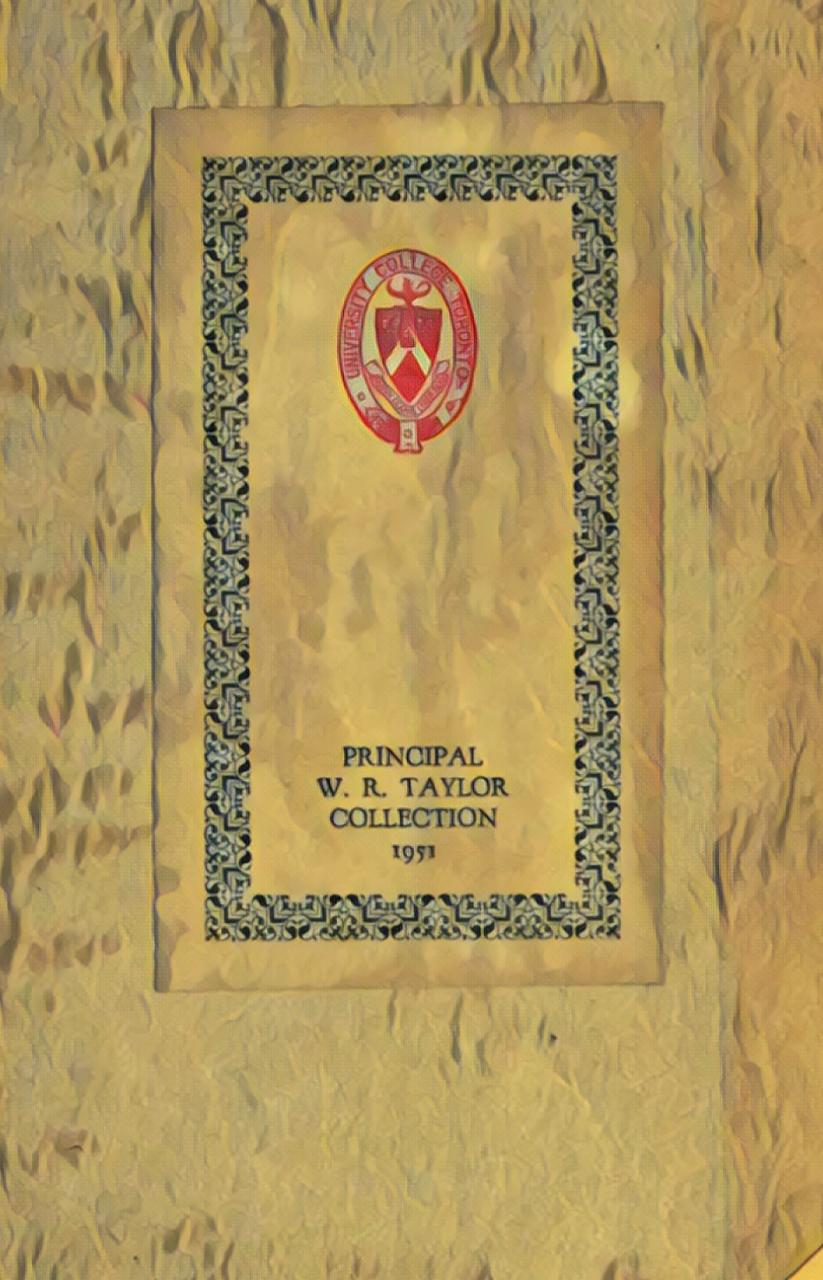في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
عثرت عليه في الشارع.. اعتبرته كنزي الثمين، خبأته في درج سري، لم أعرف كيف أتصرف معه: كل مايتعلق باللذة لا بد أن يختفي عن أعين الرقابة العائلية..كل ما يتعلق بهذه المنطقة الغامضة ينبغي دفنه.. كتاب بلا غلاف ولا إشارة إلى محتواه.. تخلص منه صاحبه الأصلي.. وعندما وقع في يدي اكتشفت أن الكلام السري والبحث المنفرد عن خفايا اللذة يمكنها أن تكون بين دفتي كتاب. وهذا وعي مفارق سيغير فهمي لحرب دارت بيني وبين غرائزي ورغباتي وملذاتي. وكنت قد عرفت مجلات البورنو؛ ليست مجلات كاملة؛ لكنها صفحات مقطوعة من مجلة متهالكة الصفحات.. اكتشاف البورنو المصور لم يكن فقط حدثًا سعيدًابالنسبة لمراهق كتوم.. لكنه خروج من عالم الخيالات المجردة إلى تجسيد صور الخيال المرعوب، من مفارقة نقائي الذي أتلقى يوميا دروساً عن وجوده المهدد بالدنس والخطايا.
ظل الخيال أكثر نزقًا وجمالاً، يحتفظ للجسد ببهاء ما.. ويلعب ألعابه السرية بكل ما تحمله من شحنات.. الصور كانت ثقافة سرية، وهذا ربما سر الاسم المستعار: مجلة ثقافية.. أو فيلم ثقافي. ثقافة مارقة في مجتمع محافظ يثور سياسيًّا أحيانا.. لكنه يتمهل عند الثورة الاجتماعية.. وقتها كانت الأجساد ما زالت تحمل أثار مرحة. وملابس النساء ما زالت خفيفة وحرة.. والرجال أزاحت قشرة خفيفة تحكمهم في النساء؛ أتحدث عن أواخر السبعينيات من القرن العشرين، بعد قليل من ستينيات الفورات الكبرى في الحريات الشخصية. ففي طفولتي كانت أمي ترتدي الميني جيب والملابس فوق الركبة ودون أكمام بشكل طبيعي.. خالتي الأكبر كانت أقل جرأة في الخروج بهذه الملابس، لكنها لم تعرف ثقافة الملابس الداخلية داخل البيت.. بنات خالتي سرن على درب أمي.
أول معركة عائلية حول الملابس كانت بين ابن خالتي وشقيقته الأصغر؛ كان يعبر المراهقة ويخط شارب الرجولة مكانه بصعوبة مضحكة، كانت المعركة بشأن ارتداء المايوه.. كنا في المصيف المعتاد بالإسكندرية، بأحد الشواطئ العامة-الشاطبي أو ربما ميامي أو سيدي بشر- والشقيق “الحمش” لا يريد أن ترتدي أخته المايوه لأنها كبرت. الأب انحاز للبنت في المعركة.. وأنا أدركت أن الجسد مساحة قلق، حتى في المصيف؛ حيث كنا (أقصد نوع الذكور) يمكننا أن نسير نصف عراة تقريبًا في الشوارع.
عائلة مثل عائلتي بدت من خارجها “حديثة” بالمعني الذي فرضته الإقامة في المدن، وتلبية نداء خروج المرأة للعمل، واستهلاك صور جديدة عن علاقة الرجال بالنساء؛ امتدت من أيام الاستعمار وأصبحت من مستلزمات “الدولة الفتية”التي يبنيها “ضباط التحرر من الاستعمار”، الاستهلاك حالة إعجاب بموديل لم يسهم المستهلك في صنعه وتأسيس، ويصاحب الإعجاب عذاب من نوع الانفصال عما تسميه النرجسية العمومية “الأصالة “.. وعائلتي ظلت معلقة بين التيه بالمعاصرة والعذاب من الابتعاد عن الأصالة المتخيلة.. غادرت عائلتي إلى صورة جديدة؛ بفعل الحماس للحظة الجماعية؛ حماس لم يحولها إلى عائلة متحررة، خصوصًا في مجال الكلام عن الجسد.. ولم تفرق العائلة بيني وبين أختى في المعاملة، استجابة لنداء المساواة.. كان ذلك حتى في الرقابة على النشاط الجنسي، الذي نالت منها أختى نصيبًا أكثر قسوة.
كانت أمي تخاف من شطحاتي الجنسية غير المعلنة.. وتعمدت أكثر من مرة أن تسميها أمامي بالتسمية الشائعة الرادعة في مثل هذه العائلات: قلة أدب.
التسميات دفعت التفكير حول الجسد إلى السر.. إلى الخيالات ربما، أو إلى محاولات فردية للاكتشاف؛ محاولات أعرف أنها ملعونة من التسمية العائلية.. التي ربما لا زالت مستقرة في مكان ما من الوعي المنسي.. أو الذي تم تجاوزه، لكنها تظهر من حين إلى آخر لتشعرني بالذنب كلما اكتشفت لذة عبر الجسد.. أو خضت مغامرة حول الطاقات المهجورة في الجسد الذي يحملني أو أحمله طول عمري وسيغادرني فقط لحظة الموت.
التسميات قادتني أيضًا إلى أحكام قيمة؛ فالعضو الجنسي عند البنات تسميه أمي:” اللولي” ما يعني أنه نادر وغالٍ ويجب المحافظة عليه. وهكذا عندما وجدت حكايات الكتاب الذي عثرت عليه تسمي الأعضاء بأسمائها المتداولة في الشارع، استيقظت حساسية المتعة المحرمة. كانت الحكايات أكثر إثارة للخيال.. في الحقيقة نقلت محبتي لقراءة درجات من المحبة الذهنية إلى عالم الحواس.
ربطتني فانتازيا الحكايات بشيء حميمي مع الأميرات والعبيد والبحارة العابرين والتجار والجواري.. والأمراء أصحاب الأجساد المذهلة.. عالم كامل قادني إلى منطقة حرية لم أسمعها لا في أحاديث رفاق جولاتي القصيرة في الشوارع في أثناء الطفولة والمراهقة ولا استمتعت مثلها مع الصور.. عالم ربط بين جسدي ونشاطي الذهني ارتباطًا جديدًا على وعي الهارب من القيود والصمت المحيط بالعلاقة مع الجسد.. لم يكن الجسد محظورا.. كان حاضرًا.
تجلس نساء العائلة بمنتهي الراحة، الحرية كانت مفصولة عن العيب طول الوقت. كنت أتابع عالم العيب في السر منفردًا، وأقيم بينه وبين الحرية سورًا وهميًّا.. كتابي الحبيب الذي عثرت عليه مصادفة خربش قليلاً في هذه الأسوار.. لكنه بقي علامة على اللقاء الأول الكامل مع صورة الجسد. وعرفت بعد سنوات طويلة أن كنزي السري لم يكن سوى أشهر كتاب عربي؛ ألف ليلة وليلة.