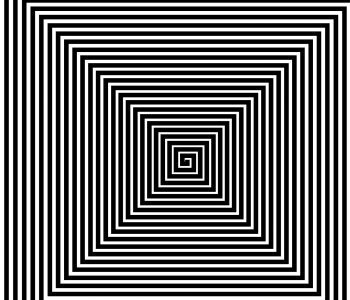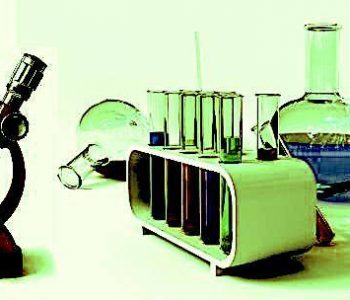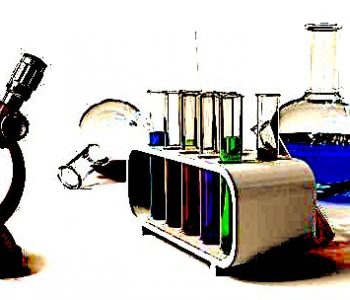في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
الشريحة العمرية التي سقط منها معظم ضحايا فيروس الكورونا بين 70- 95 عامًا، تنتمي إلى الجيل الذي بعث أوروبا من الموت بعد الحرب العالمية الثانية، الجيل الذي حوَّل حطام الحرب وأطلال المدن إلى دول الرخاء والرفاه، الجيل الذي دافع عن الحريات ورسخ ثقافة حقوق الإنسان، يموت وحيدًا في العزل، وتمضي جثامين أبنائه إلى الحرق في طابور طويل من العربات العسكرية في موكب جنائزي يغلفه صمت مدن تخلو من الحياة في مشهد ختامي حزين لأوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية، ولأزمة جيل يقاوم الإقصاء منذ سنوات.
منذ عامين تقريبًا تقدم السيد إيميل راتلباند لمحكمة مدينة أرنهيلد الهولندية بطلب لتغيير تاريخ ميلاده من 11 مارس 1949 إلى 11 مارس 1969، ليصبح عمره أقل عشرين عامًا مما هو مدون في أوراقه الرسمية، وقد قام بتعزيز طلبه بشهادات طبية تؤكد أن حالته الصحية وقدراته الجسدية هي لرجل في نهاية الأربعينيات من عمره. بنى راتلباند قضيته على أساس أن العمر أحد أهم العناصر المحددة لهوية الفرد داخل المجتمع، فإذا كان القانون يسمح للأفراد بتغيير أسمائهم أو أديانهم، وإذا كان يسمح لمن ولد ذكرًا أن يختار أن تكون هويته امرأة أو العكس؛ فلماذا “لا يسمح لي أن أقرر ما هو عمري؟“..
رفضت المحكمة طلب راتلباند؛ لأنه وإن كان العمر أحد محددات الهوية الفردية فإن محو عشرين عامًا من الأحداث والوقائع سيترتب عليه مشكلات قانونية لا حصر لها، فهناك الكثير من الحقوق والواجبات المترتبة على العمر مثل الحق في التصويت والحق في قيادة السيارات، والزواج وتناول الكحوليات إلخ..
على الرغم من أن قضية الهوية الفردية من أهم القضايا الفلسفية التي تواجهها الثقافة الغربية اليوم إلا أنها لم تكن الدافع الحقيقي وراء هذه القضية التي أثارت كثيرًا من الجدل والسخرية في العالم كله، فقد كان التمييز الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له جيل السيد راتلباند هو المحرك الحقيقي للقضية، إذ أن الانتماء إلى هذه الشريحة العمرية يقلل من فرص العمل وفرص الحصول على قروض شراء سيارة جديدة أو منزل جديد، وحتى فرص الاشتراك في تطبيقات المواعدة على مواقع التواصل الاجتماعي.
في السنوات الأخيرة تتابعت الدراسات والإحصاءات التي تدق أجراس الخطر بسبب شيخوخة المجتمعات الأوروبية، ولا يتعلق الأمر فقط بتراجع نسبة المواليد وإنما – وهذا انطباعي الشخصي – باستمرار تلك الشريحة العمرية ( 70- ٠٠) في الحياة، واستنزاف اقتصاد تلك المجتمعات بسبب ما يحصلون عليه من امتيازات، إذ تشير إحصاءات مختلفة قام بها البنك الدولي، وإدارة الإحصاء التابعة للمفوضية الأوروبية eurostat ، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD ؛ إلى أن الإنفاق على المعاشات يصل إلى 15٪ من الناتج القومي لدول الاتحاد الأوروبي، وأن دولاً مثل ألمانيا وإيطاليا تصل نسبة الإنفاق فيها على المعاشات إلى 16.4 ٪ من الدخل القومي، وهذه النسب في كل الحالات تمضي في خط تصاعدي يؤكد الخبراء أن استمراره في الصعود سيدمر الاقتصاديات الأوروبية ويخفض كثيرًا من مستوى المعيشة فيها، وهو ما دفع كثيرًا من كتاب الصحف الكبرى إلى الجهر صراخا بما تشير إليه أرقام الإحصاءات بصمت محايد، فهذا فيليب إنمان من صحيفة الجارديان ينتقد بشدة البرلمان البريطاني الذي أجل البت في خطة إعادة هيكلة الضرائب التي ستقلص من امتيازات أصحاب المعاشات وتقلل من العبء الذي تتحمله الأجيال الأكثر شبابًا إلى عام 2025 زاعمًا أن الاقتصاد البريطاني لن يتحمل هذا العبء حتى ذلك التاريخ.
يقول إنمان إن الفائزين بـ “اللوتاري” من المسنين يجب أن يساهموا في مواجهة مشكلات الاقتصاد البريطاني، ويضرب مثلا بقائد الأوركسترا برنارد هايتنك الذي احتفل بعامه التسعين على خشبة المسرح والذي لا يزال مصرًا على الاستمرار.. يقول إنمان إنه لا يجب السماح لأمثال برنارد ممن يمتلكون الثروة والصحة بالاستمرار في العمل، وأن عليهم ترك الساحة لأجيال أصغر سنًّا، ليس هذا فقط، فهؤلاء المحظوظون بجيناتهم الوراثية وباستفادتهم من الازدهار الاقتصادي لأوروبا ما بعد الحرب العالمية عليهم تحمل عبء أبناء جيلهم الأقل حظًّا، فقد زاد دخلهم في الـ12 عاما الأخيرة بنسبة 60٪ بينما لم يتجاوز الباقون سقف 36٪ ، لذلك ربما يجب إجبارهم على مشاركة ثرواتهم.
مثل السيد راتلباند لم يستلم أبناء هذه الشريحة العمرية، وشرعوا في تأسيس أحزاب سياسية لا تقوم على أيديولوجيا سياسية أو اقتصادية معينة، وإنما على أساس واحد هو الدفاع عن حقوق ومكتسبات هذا الجيل، وقد تأسست هذه الأحزاب في 23 دولة؛ من بينها إيطاليا وألمانيا وإنجلترا والنرويج والدنمارك، وقامت بلعب أدوار سياسية متفاوتة في هذه البلاد وصل بعضها إلى الحكم من خلال الدخول في ائتلافات مع أحزاب أكبر، وهو ما ساعدها في الدفاع عن مكتسبات المسنين، وزاد في سخونة الجدل الدائر حول ضرورة انسحابهم من الحياة العامة؛ ذلك الجدل الذي ساهم في عودة المالثوسية (نسبة إلى توماس مالثوس 1766-1834 الذي يرى أن الزيادة السكانية تؤدي إلى تآكل الموارد، ومن ثم للحفاظ على المجتمع يجب ترك السكان الأكثر فقرًا وضعفًا للموت عن طريق الأوبئة والحروب ولكوارث) خصوصًا مع انتشار فيروس الكورونا وانتشار عبارة “لا داعي للقلق فهذا الفيروس يقتل المسنين فقط” والتي بدت شعار لممارسة منهجية إذا وضعنا في الاعتبار إهمال بعض الحكومات مواجهة الكورونا في بداية انتشار الفيروس، أو في اعتماد البعض الآخر نظرية “مناعة القطيع” التي تعني التضحية بأبناء هذا الجيل.
قد لا يتعاطف القاريْ العربي مع أبناء هذا الجيل، فمن وصلوا إلى هذه المرحلة العمرية في عالمنا العربي هم إما قابعون ينتظرون الموت “يالله حسن الختام“، أو يعايرون الأجيال الأحدث سنًّا على ما آلت إليه أحوال مجتمعاتهم من انحدار وتفسخ هم المسؤولون عنه بالأساس، أو لو كانوا ممن يملكون الثروة أو السلطة أو كليهما فهم يتنمرون على الأجيال الشابة ويحرمونهم من فرص المشاركة الفاعلة في المجالات المختلفة متمترسين حول كلمات مبهمة مفرغة من المعنى مثل الخبرة والحكمة، بل إنهم قد يستغلون ما يتمتعون به من حقوق سياسية لحرمان الشباب من فرص تغيير المجتمع إلى الأفضل لإبقاء الحال على ما هو عليه، إذ كانوا وما يزالوا تنقصهم روح المبادرة والمغامرة، وهنا أستطيع أن أقول، ومن واقع خبرتي الشخصية، إن قطاعًا كبيرًا من أبناء هذا الجيل في المجتمعات الغربية على النقيض تمامًا من كل هذا.
عندما انتقلتُ للعيش في الولايات المتحدة الأمريكية للتدريس في جامعة نيويورك، ثم إلى إيطاليا للتدريس في الجامعة الكاثوليكية بميلانو كان أبناء هذا الجيل مثار دهشتي الدائمة، إذ التقيت منهم من يسجلون أسماءهم في فصول اللغة العربية لدراسة لغة جديدة تساعدهم على فهم ما يحدث في واقعهم الآن، والتقيت منهم من كان يحارب الفاشية والجوع والبرودة القاسية في جبال الألب يقومون بإنشاء المتاحف ويجمعون حكايات رفاقهم من شباب وشابات المقاومة، التقيت من يبدأون مشروعات لن تكتمل إلا بعد سنوات طويلة مدفوعين بقناعة أن أهميتها للمجتمع ستضمن استمرارها حتى بعد رحيلهم، التقيت من كرسوا جهدهم ومهاراتهم لمساعدة المهاجرين وأبنائهم، وفي قاعات الندوات عندما كنت أدعى للحديث كانوا يشكلون النسبة الأكبر من الحضور، ليس لأن المجتمع أصابته الشيخوخة ولكن لأنهم الأكثر فضولاً والأكثر اقتناعًا بدور المعرفة في التغيير والأكثر تفاؤلاً بالمستقبل.
ربما يرى البعض أن هذا مبالغة، ولكنها سمات هذا الجيل الذي أعاد بناء أوروبا ما بعد الحرب وصنع معجزتها الاقتصادية، وحقق مجتمع الرفاه الذي تسعى النيوليبرالية اليوم للانقضاض عليه، والذي عندما تعرض للتهميش في نهاية أيامه قام بتنظيم نفسه في أحزاب، متجاوزًا خلافاته الأيديولوجية والسياسية، وكيف لا وهو الجيل الذي آمن بالحريات والتعددية وحقوق الإنسان ودافع عنها من خلال الآليات الديموقراطية ومن خلال الاحتجاجات مثل احتجاجات الطلاب في عام 68.. لقد قام هؤلاء الشباب بحشد أنفسهم كما لم يحدث قط؛ وفعلوا ذلك بشكل تلقائي، وكأنهم فئة اجتماعية ذات بُعْدٍ كوني يمكنها حتى عبور أسوار الحرب الباردة. ولقد برزوا لبعض الوقت كعامل اجتماعي جديد يميّز نفسه عن عالم الكبار.
إنه الجيل الذي رأى كل شيء ينمو ويزدهر – كان تعداد البشر 203 مليار نسمة حتى عام 1947 وتضاعف ثلاث مرات تقريبا حتى عام 2006، إذ وصل إلى 6.5 مليار نسمة، مكذبًا تنبؤات المالثوسية وتشاؤمها من المستقبل، يرقد الآن في غرف العناية المركزة، يفارق الحياة يوميًّا المئات من أبنائه ليعلن عن نهاية عالم أوروبا ما بعد الحرب، وأهم ما يميزها تلك الإرادة التي لا تشيخ للحياة.
يقول الخطيب الروماني شيشرون “ليس هناك حقًّا من تبلغ به الشيخوخة حدًّا لا يجعله يتوقع أن يعيش عامًا آخر” وهذا الجيل لم يعش حياته في انتظار الموت، ولم يقضها في محاولات للهروب منه، وإنما في مطاردة الحياة في مستقبل أفضل حتما سيأتي.