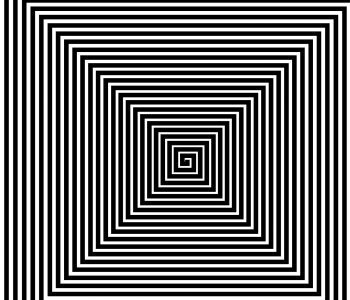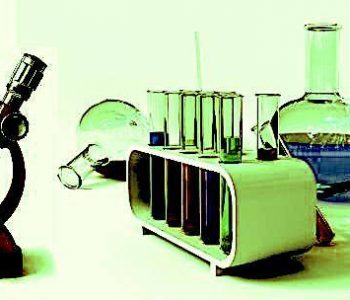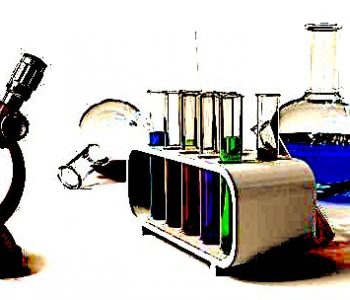بداية عادية ليومٍ عادي جدًا.
الحياة في ظل أجواء الكورونا جعلت وصف اليوم، كل يوم، مثل الآخر.. استيقظت نحو العاشرة، أتكاسل كالعادة، ومعي ذلك الصداع البسيط الذي يهاجم مؤخرة عيني على استحياء، مثل ضباب متوسط الكثافة. فلا هو يحجب عنك الرؤية بالكامل ولا ينتابك الشعور بالراحة بعد صفاء الرؤية..
أخيرًا أعاني من مشكلات متعلقة بالنوم، ليس هناك موعد محدد أذهب فيه إلى النوم، أسهر أيامًا وأنام باكرًا في أيام أخرى، بل قد يجافيني النوم بعض الأحيأن طوال الليل وحتى التاسعة صباحًا.
قد أكون في قمة الإرهاق عند النوم وأسقط على سريري شبه فاقدٍ للوعي ممنيًا نفسي بنوم عميق يمتد لساعات، إلا أنني أفاجأ باستيقاظي عقب أربع ساعات فقط ولا أستطيع النوم مرة أخرى! حدث ذات مرة أن استيقظت عقب النوم بساعة ونصف فقط ولم أدر ماذا أفعل! وإذا نمت ما أعتقد أنه يكفيني– سبع أو ثماني ساعات– أستيقظ على صداع وخمول عام!
على كلٍ لم أعد أبالي أو أكترث.. أقرر أن أنفض تكاسلي وأقضي حاجتي؛ أغسل أسناني ويزعجني نزيف اللثة مرة أخرى، أبصق الدماء مرارًا وتكرارًا كعملية روتينية بلا كلل ولا هدف. أتناول إفطارًا بسيطًا مكونًا من ساندويتش جبن بالمشروم، وبضع حبات من الزيتون، أعقبهما بكوب كبير من النسكافيه الساخن، الذي لم أعد اثق في مفعوله ولو قليلاً.
أفتح حاسوبي المحمول، أقوم بتصفح آخر مستجدات عملي، لا شيء جديد يذكر. أراسل بعض الأصدقاء، الأوقع أنني أقوم بالرد على مراسلاتهم من باب الذوق ليس إلا، محاولا الحفاظ على أدنى قدر من التواصل الاجتماعي مع الآخرين.
في الأونة الأخيرة، أشعر براحة كبيرة في الانعزال، وعدم التجاوب مع أحد أو الاتصال بأحد. كل ذلك لم يجد نفعًا مع محاولة نسياني أو تناسيَّ لتلك الفكرة التي أرقتني بشدة منذ عدة أيام، فعادت لتهاجم عقلي وتحتل تفكيري بشدة. لم أحأول التهرب منها هذه المرة، ولا أجد سلوانًا إلا في القراءة، قررت التماشي معها، ومحاولة السباحة بين ثنايا أمواجها.
فكرة أنه لا بد لي من الكتابة، حتمًا سيأتي يوم وأكتب، مرارًا أقوم بتأجيل تلك الخطوة، بلا سبب مقنع، أعتقد أنه الخمول، أو الخوف من الكتابة، فالكتابة عمل شاق، ومرهق..
لا أعلم عن ماذا أكتب، لكني أشعر أني بحاجة إلى قول الكثير، إلى التعبير عن ما يفتعل بداخلي. أريد أن أشعر بالراحة، وجدت بعضًا منها في القراءة، انهمكت في القراءة مثل العائد الى الحياة بشهقة هواء، أحأول امتصاص كل ما أستطيع قراءته. إحساس الراحة الذي تشعر به في أثناء رؤيتك للوحة فنية، بسيطة التفاصيل، معالمها مكتملة، تجعل شفتيك تفتران عن ابتسامة دون الحاجة لأن تكون دارسًا للفن، أو مختصًا فيه.
في حالتي، أمدتني القراءة بمثل ذلك الإحساس. إلا أنه ما زال إحساسًا منقوصًا، مثل ابتسامة مبتورة، غير مكتملة، اللوحة ينقصها بعض التفاصيل، بلا دليل، أو حتى إرشادات لإكمال ما ينقصها. قد تكون الكتابة سبيلي للبحث عن تلك الراحة التي أنشدها، قد تكون هي تلك التفاصيل الناقصة، المبهمة. قد تُكمل بناء تلك اللوحة، وتوضح كنهها في النهاية.
وحتى الانتهاء من تلك اللوحة، وظهورها على الملأ، فها أنا أكتب، وأحاول تجربة حظي، لعل وعسى، أن أحظى بتلك الراحة.
أعود مرة أخرى إلى حاسوبي، أفتح صفحة للكتابة، لا أعلم من أين أبدأ، لكن أصابعي لا تخذلني، أجدها تضغط على المفاتيح بطريقة لا إرادية، تستمر الكلمات في التتابع والظهور على الشاشة، بلا انطباع عن الشكل النهائي لما سأكتبه، كما لو أن أصابعي تحولت إلى ريشة فنان، تكون بداية رسوماته عبارة عن لطخات متفرقة هنا وهناك، على سطح لوحة كانت في الأصل، فارغة، مصمتة.
أشعر بدفقة من الانتعاش، تهاجم وتكافح ذلك الضباب الذي يعمل عمله كصداع في ثنايا رأسي. يتحول الإحساس إلى لذة، كإحساس بالبخار عند تجمعه، أحس بتثاقل في أصابعي، وكأنها باتت تحتاج إلى مجهود أكبر لمتابعة الضغط على المفاتيح. لا أواصل الإلحاح أو الضغط، أتوقف، أحملق في الشاشة، محاولا قراءة ماكتبت، شذرات وشظايا، من يومياتي وذكرياتي، لا أعلم ما الرابط بينهم. لطخات فرشاة كما أسلفت. أعيد القراءة المرة تلو المرة، حتى تنطفئ الشاشة، معلنة الدخول في فترة السبات المؤقت، لا أزال أنظر إلى الشاشة المظلمة، أستطيع تمييز انعكاس معالم وجهي، لا أحتاج إلى كثير من الجهد، لأفهم وأعي ماغاب عني طوال تلك الفترة، وعجزت عن تفسيره، فملامح وجهي على سطح عاكس مظلم، أجبرتني على الاعتراف بأني وحيد.
قد يكون من مميزات فترة الجائحة، الوجود لمدة أطول في المنزل، مما يتيح الفرصة للتقارب الأسري، وإيجاد الوقت اللازم لمشاركة الاهتمامات الأسرية، إلا أنني في الوقت نفسه، أشعر بالعكس، أشعر بأن ذلك من أشد المساوئ المصاحبة للجائحة، أثرًا ووطأة، بعد الآثار الصحية، وما ينتج عنها من تدهور عام يؤدي إلى الوفاة. عندما أنظر إلى الطرقات الفارغة، والملامح المذعورة والخائفة، والالتزام بإرشادات التباعد الاجتماعي، يقتحمني إحساس رهيب بالوحدة، مصحوب ببرودة تصيب القشعريرة، تبحث عما تدفئ به نفسك، ويبث بعض الحرارة في أوصالك. لكنها محاولات بائسة، بلا نتيجة.
أدرك أن روحي تعاني البرودة، مثل باقي أعضاء جسمي، روحي تلتمس الدفء، في مجالستي لمن أحب، دفء الروح قد يكون مقدمًا في بعض الأحيان على دفء الجسد، بل قد يكون منبعًا لدفء الجسد في الأساس. أشتاق إلى دفء من هذا النوع، أشتاق إلى لدفء أرواح من أحبهم، فهم فقط، من بيدهم أن يعيدوا إلى روحي إحساس السعادة، والقضاء على شعور الوحدة.