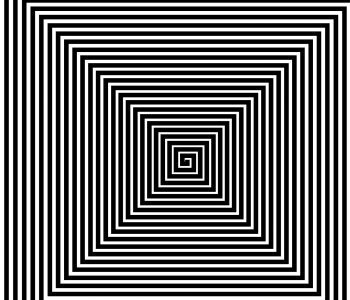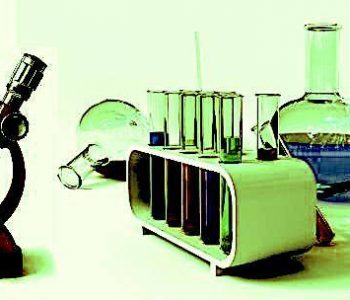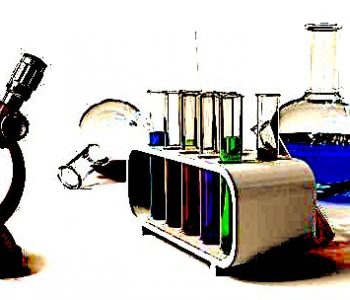في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
مي ماتت.. كانت تلك الرسالة أول ما وقعت عليه عيناي، عند استيقاظي صباحًا، أتململ في سريري، أتذكر أنه ليس لديَّ ما أفعله، ليس هناك ما يستدعي الاستيقاظ من أجله باكرًا، فالعمل من المنزل، يتيح لي فسحة من الوقت؛ أن أؤديه في أي وقت، قبل مواعيد انتهاء العمل الرسمية.
حين يستوعب ذهني ذلك، أعود إلى النوم مجددًا، نوم متقطع، منهك أكثر من أي شيء آخر، أدرك أن الوقت صار ظهرًا، أقرر النهوض، فالبقاء في السرير، صار أكثر إنهاكًا.
أفعالي أصبحت رتيبة و متكررة، عقب النهوض، أتوجه إلى الحمام، مصطحبًا هاتفي المحمول، عشرات الإشعارات على مواقع التواصل الاجتماعي، أمر عليها مرور الكرام، أقرأ الرسائل، وأتجاهل الرد عليها، مؤقتًا أو أتجاهلها على الإطلاق، لا فارق، أعيد قراءة رسالة صديقي؛ مي ماتت، ولا يعلم سببًا لوفاتها، رسالة أرسلها لي أحد أصدقائي الذي لم أره منذ عدة أعوام، ويعمل خارج البلاد، إلا أن العقل ليس بحاجة ماسة إلى إرهاقه بالاستنباط، وتخيُّل سبب الوفاة في هذه الأوقات، يصيبني السأم سريعًا ثم ينقطع التيار الكهربائي، قبل أن أستطيع الرد عليه سريعًا، أنتهي، واضع نفسي، متثاقلاً، أسفل الدش، أستقبل قطرات المياه المتسارعة على رأسي ووجهي، بلا مبالاة، وكأني تحولت إلى إنسان آلي، يتم تنظيفه، دون إبداء أية أحاسيس تدل على عدم تأثره بم يحدث حوله على الإطلاق.
أغلي قهوتي، أتكاسل عن إعداد فطوري، فالساعة قاربت على الثانية ظهرًا، ولا رغبة لدي في الطعام عمومًا، تفور القهوة، وأفشل في الحفاظ على وشها الكثيف، فأقرر شربها كما هي، ولا أعيد غلي كوب آخر.
يعود التيار الكهربائي، أفتح لابتوبي، أرتشف قهوتي ببطء، أتصفح مواقع الإنترنت المختلفة، أتجاوز وأتفادى كل ما له علاقة بالأوضاع الحالية، وآخر مستجدات الجائحة، فأخيرًا، لم أعد أطيق تحمل كلمة عاجل، فلا عاجل ينبئ بخير هذه الأيام، ومعظم الأخبار أصبحت كئيبة، لا تشرح النفس، حتى منشورات الأصدقاء، لا أكمل قراءتها، وأهرب منها سريعًا، إذا تبين لي، أن ما يناقشه يخص الوضع الحالي، بل امتد الأمر إلى إلغاء متابعة بعضهم، الذين نصبوا أنفسهم منابرًا إعلاميو بشكل تطوعي، لإذاعة كل التفاصيل التي تجعل لفظ لا إله إلا الله لا يفارق لسانك، وأن ملاك الموت أوشك على الوصول إليك، وعليك استقباله كما يجب أن يكون!
أحاول التركيز فيم عليَّ فعله، وإنجازه، لصالح العمل، أتصفح بريدي الإلكتروني، لا تفاجئني سرعة الإنترنت البطيئة، التي تنافس سرعة السلحفاة، التي أصبحت معتادة في الآونة الأخيرة، بل لن أندهش، إذا ما قيست السرعتان عمليًّا، وتفوقت سرعة السلحفاة، فسر سرعة الإنترنت، من المعجزات التي حار العلماء والمختصون في تفسيرها، وفشلوا بكل جدارة!
تمر الساعات بطيئة، ثقيلة، ليس لي من الهمة ولو قدر يسير، يعينني على إشغال نفسي، ومحاولة نسيان ذلك الواقع الممل، أو نسيان خبر الوفاة، حتى حلول الليل، وبدء فقرة الحظر الليلي.
أغلق شاشة لابتوبي، أشعر أن الجو أصبح حارًا، وعقلي يصبح أكثر تشتتا، أعد كوبًا آخر من القهوة، أخسر وشها كعادتي، أفتح نافذتي، أحدق في الشارع بلا هدف، لا يفاجئني وجود الناس بكثرة، بعد دخول توقيت الحظر حيز التنفيذ، فعلى ما يبدو أن الناس لا يجدون ما يفعلونه في بيوتهم، فكان الأسهل عليهم، استئناس الحظر، والتعامل معه على أنه كائن أليف.
أفشل في طرد خبر وفاة صديقتي من عقلي، يتملكني الحزن، رغم عدم تقابلنا وجها لوجه، واكتفائنا بالصداقة الافتراضية، إلا أني أذكر حسها الرقيق، ملامحها الطيبة وابتسامتها المنعشة، وألفتها في الحديث، وأدبها الجم، ثقافتها واطلاعها، عقليتها الناقدة لكل ما يحدث حولها، ومساعدتها في إنجاز بعض الأمور إذا استطاعت، طموحاتها التي لا تنتهي، مؤهلاتها العلمية الهائلة، شهادتي ماجستير، وإتقان لعدة لغات، تضحيتها بعروض العمل الخيالية خارج البلاد، مقابل أن تبقى بجوار والدتها، وشقيقتها التوأم، محاولاتها الحثيثة لكسر البيروقراطية الحكومية، والحصول على ما هو حق لها، في التعيين بأحد المصالح الحكومية، نظرًا إلى مؤهلاتها وتفوقها الدراسي دائمًا، حتى نالت ما تريده.
ألتقط هاتفي المحمول، أتصفح حسابها على الموقع الأزرق، علِّي أجد نفيًا للخبر، كمتعلق بقشة، إلا كما يحدث عادة، أجد أن الخبر مؤكد، والتعازي لا تنقطع، أستمر في القراءة، تفزعني صدمة أخرى، فقد لحقت بها أختها، وتوأمها، بعد وفاتها بساعات معدودات، وكأنها لم تتحمل فكرة البقاء بمفردها، وهما من عاشتا معًا تتشاركان كل شيء، منذ لحظة الولادة.
أغلق هاتفي، واستمر بالتحديق في الشارع، تنتابني مشاعر حزن لا حصر لها، أفكر في باقي أشقائها، في والدتها، التي لا بد أنها في حالة يرثى لها. إن الأم التي تفقد أحدًا من أبنائها، كأنها فقدت جزءًا من روحها، فهل يستطيع أي شخص تخيل حالة من يفقد جزئين من روحه، في الوقت نفسه؟ أفكر في الدورة الاعتيادية التي أصبحت عليها حياتي أخيرًا، بل حياة الكثيرين غيري، وأن اليوم يمر تلو الآخر، بالتفاصيل نفسها في كثير من الأحيان، فتشعر أنك في دائرة لا تنتهي، فكأن بداية اليوم هي بداية تلك الدائرة، ونهاية اليوم هي نهاية تلك الدائرة، وأن البداية والنهاية هما في الأساس شيء واحد.
وفاة بعض من نعرفهم قد تكون من ضمن التفاصيل الصغيرة التي لا تحدث كل يوم، يخطر ببالي فكرة؛ ترى من سيصيبه الدور في طابور الوفاة، هل يكون أحد الأقارب، أحد المعارف، بائع الخضروات المتجول الذي ينادي أسفل نافذتي كل يوم صباحًا؟ ينزلق الكوب من يدي، أتابع سقوطه الى الأسفل ببطء، وعند اصطدامه برصيف الشارع، يتحطم، وتنتشر شظاياه وبقاياه في شتى الاتجاهات، تتحول مشاعري حينها من الحزن، إلى فورة من الغضب العارم، غضب مُنصبٌّ على تلك الجائحة، تلك الجائحة التي أصبحت سببًا في تشظي أرواحنا، وأصابتها في مقتل، لم ترحم عزيزًا، ولم تشفق على من يعاني.
قد يعتقد البعض أن الأثر السيء لتلك الجائحة، أنها تؤدي إلى الوفاة، وأن العلماء والخبراء لم يتوصلوا إلى علاج ناجع أو مصل يوقف تلك الجائحة عند حدها، رغم أبحاثهم المتواصلة ومثابرة جهودهم التي لا حصر لها، لكن هناك ما هو اسوأ من ذلك، إنه إحساس الخوف المستمر، الذي زرع في أرواحنا، وأصبح متعمقًا في داخلنا بصورة كبيرة، ويطغى على أي مساحة أخرى، إحساس الخوف من المجهول، من الإصابة، من عدم النجاة، من إصابة أحد الأقربين، من فقدان من نحبهم جراء إصابتهم.. بل أيضًا الخوف من الاقتراب ممن نحب، حتى نتفادى احتمال الإصابة منهم، أو نقل العدوى إليهم. من تفضيلنا البقاء منعزلين، وحيدين، حتى إذا أجبرنا على ذلك، فالجائحة جعلت النجاة مقترنة بالوحدة، والابتعاد عمن نحب. ألقي نظرة أخيرة، على شظايا الكوب المتناثرة، وأغلق نافذتي، أوقن أنه حتى إذا انتهت تلك الجائحة قريبًا، إلا أن نفوسنا وأرواحنا ستظل عليلة، منكسرة، وخائفة، في انتظار من يأخذ بها، ويحتويها، بدفء ومحبة، ليعيد إليها الثقة من جديد، والشعور بالأمان، وذلك لن يحدث، إلا ببقائنا بجوار من نحبهم.