في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
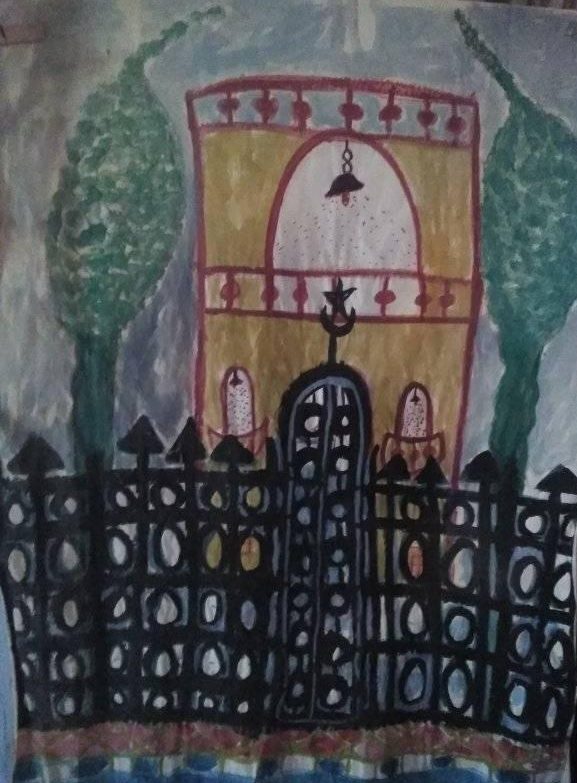
مذكرات عطشجي في السكة الحديد
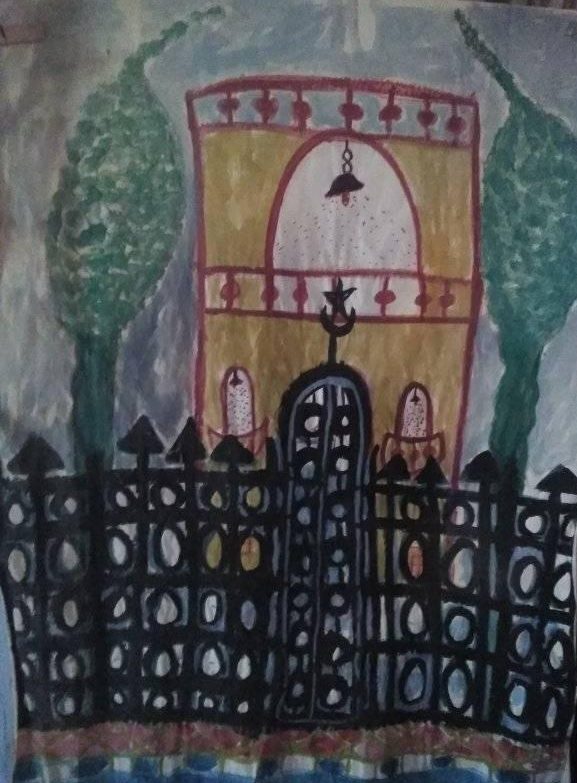
مع دقات أجراس أعياد الميلاد المجيد في جوف الليل أتذكر أم سوزي القبطية جارتنا في المسكن الذي نعيش فيه.. أتذكر طفولة الحب؛ ونحن نذهب معًا أنا وسوزي، كل منا يمسك في طرف جلباب أمه وهما متجهتان إلى سوق سميكة للخضار، ومشهد الباعة يأخذ لباب قلبي، بالطماطم والجزر والفلفل الرومي والبصل والباذنجان الأبيض منه والأسود، بحلل الجبنة القريش، وتلال الجرجير والبقدونس والشبت والكرفس، أو وأنا أتوه في جماليات تلال القرنبيط البيضاء أو تلال البرتقال..
العالم الأثير لذاتي وأنا أمشي وسط السوق ونظرات الحب الأولى والفطرية تمامًا.. كانت أم سوزي في نفس جمال أم يورجو اليوناني بالضبط.. وكأن روح الإيمان الكنسي قد انقسمت لنصفين.. هجرت أم سوزي المنزل بسب الاضطهاد، وكان يومًا محبطًا للغاية في حياتي، وأنا أقاوم هذا الاضطهاد وذاك بإضاءة نور السلم.. فقد كانت أم سوزي في الدور الرابع، وأنا أسكن في الدور الأول، وهنا كانت تقع مسؤوليتي الأخلاقية تجاه هذه الأسرة النادرة في حياتنا ككل، لأن الصداقة الوحيدة التي نشأت؛ كانت بين أسرة سوزي وأسرتنا، ونمت بفعل الزمن والحب، وذلك بفعل بسيط ومؤثر: عندما كانت المياه تنقطع عن شقة أم سوزي؛ لأنهم يسكنون في الدور الأخير، كانت أم سوزي تهبط لتملأ الجرادل والحِلل بالماء العذب من شقتنا نحن فقط دون كل شقق الدور الأول! الأمر الذي لفت نظري مبكرًا وأنا طفل. كانت تلك الأسرة القبطية طيبة للغاية.. عدد أفرادها قليل جدًا مقارنة بعدد أفراد الأسر المسلمة كثيرة العدد.. هذه المقارنة لفتت نظري مبكرًا، وطبعًا لم أندهش عندما وجدت أن مديح؛ الأخ الأكبر لسوزي من أعز أصدقاء أخي مطراوي، ولا زلت أتذكر حكاية مديح عندما سافر إلى باريس في الستينيات من القرن الماضي، وثورة الشباب الهيبز في أوج ازدهارها..
ولكن ما الذي جعلني أترك مهنة العربجي، أو أنسى تجربتي مع هلال في باب الخلق، طبعًا لم يكن من قبيل المصادفة أو الخجل، بل بالمصادفة البحتة، فقد وجدت صديقًا آخر، وكان أيضًا جنديًّا في نفس الكتيبة؛ وهو خليل.. وخليل هذا كان جنديًّا يعمل في مطبخ الكتيبة، طباخًا لنا جميعًا نحن الجنود.. وقد كان من أهم ذكريات أخي الكبير عبد العزيز عن الحرب حديثه عن قلة الطعام، وكانت أهم نقطة في ذكرياته أنه صادق الجندي الموكولة له إدارة المطبخ، ومن هنا انتبهت إلى أهمية صداقتي لخليل هذا.. وبدأت أتقرَّب وأتودد إليه في أوقات فراغي من المهام العسكرية.. وبالمصادفة البحتة عرفت أنه يعمل في الحياة المدنية أسطى في مصنع للزجاج بالقرب من محطة الدمرداش.. وفي الإجازة التالية كنت أعمل في مصنع الزجاج ذاك، الأمر الذي جعلني أتقرَّب أكثر من خليل؛ ربما لملامحه المصرية الخالصة؛ فهو أسمر ونحيف تمامًا، وطويل بعض الشيء، وحنجرته ذات نبرة رجولية، وعيناه سوداوان واسعتان، ودمه خفيف، لكنه لم يكن ابن نكتة.. وكان يحب المطرب محرم فؤاد جدًا، إن لم يكن مهووسًا به، وكنا نخرِّط السبانخ ونقشر البصل في مطبخ الكتيبة ووسط الدخان، وجدران المطبخ الملطخة بهباب موقد السولار، وهو يغني “خاين وعينيه خاينين.. خدو مني أحلى سنين” وصوت خليل أصلاً أجش، من جراء تدخينه للسجائر الكليوباترا والمعسل.. وقد دهشت جدًا من صداقتي لخليل، ربما لأنه أمِّي، لكن تجربته في الحياة عميقة جدًا، خصوصًا مع النساء.. وكانت النساء هي مربط الفرس.. كيف؟ صديقي خليل هذا يسكن في المساكن الشعبية في حي غمرة القاهري، وتسكن على مقربة منه امرأة لعوب.
وهنا ينبغي أن ننبه الأصدقاء إلى أن سكان المساكن الشعبية عندهم ميزة غريبة؛ هم طبعًا فقراء، وربما يكونون بالفعل تحت خط الفقر، وربما يكونون أكثر فقرًا من سكان المناطق العشوائية، مثل الدويقة أو إسطبل عنتر أو كوبري الليمون.. ولكن الميزة الأساسية للمساكن الشعبية هي فكرة وجود ضوء الشمس الذي يدخل المطابخ وغرف النوم والحمامات.. إلخ. وتلك نقطة سوف أعود إليها لاحقًا.. نرجع إلى خليل صديقي الجندي ذاك مع المرأة اللعوب؛ طبعًا عشق خليل هذه المرأة، وكان يحلم بها وهي في أحضانه على سرير النوم. والمرأة كما وصفها خليل بيضاء وطويلة، وذات شعر أسود ناعم وطويل، وذات جسد ناعم وأملس، وطبعًا ذات صدر نافر وأرداف متماسكة ونابضة بالحيوية والشهوة. تملك كل ذلك وكانت تصعد إلى شقة خليل بقمصان النوم القطن خفيفة الملمس، التي كانت تُظهر مفاتن صدرها وبطنها، ومن ثَم شَعْر ما تحت الإبطين.. وكان خليل صديقي ذاك يحكي بتمعن ودقة، وطبعًا جن من قوة الشهوة، وهو مراهق لا يزال، وتلك المرأة تعرف ذلك.. وفى نفس الوقت لا تترك لخليل أي فرصه للانفراد بها، لأنها كانت في الأساس صديقة أم خليل، بل وتساعدها في أعمال الطبخ والغسيل، وخليل متربص بها، وفى نفس الوقت الذي وصل فيه إلى ذروة الشهوة، بل وكادت أن تصل إلى حد العنف والتهور، حدث له أمل غريب، وذلك أن أعطته هذه المرأة اللعوب مفتاح شقتها، كي يحضر لها شيئًا بسيطًا، ربما هو منخل، أو حتى طبق، أو طشت غسيل، ووجد خليل نفسه ومعه مفتاح شقة حب حياته، فما كان منه إلا أن اندفع بكل قوته إلى غرفة نومها.. يقول خليل “وعندما دخلت الى غرفة نومها لا لم أفكر في السرقة.. بل ولم أفكر في أي شيء آخر.. لم أفكر إلا في دولاب ملابسها الخاصة.. وبدأت أهجم على قمصان النوم الخاصة بها، وعلى ملابسها الداخلية.. وبدأت أشم هذه الملابس وألحسها بلساني.. وبدأت أخلع ملابسي الداخلية وأنام عاريًا على سريرها.. وأحتضن مخدتها.. ومن قوة شهوتي ارتديت ملابسها الداخلية حتى وصلت إلى قميص نومها.. بل ومارست العادة السرية عليه.. حتى إنني وجدت نفسي وقد أصبح لباسها الداخلي مبللاً بحيواناتي المنوية إثر ممارستي العادة السرية”.. وهنا كان خليل يتوقف قليلاً كي يلتقط أنفاسه، غير مصدق أنني أسمعه.. أو أن هناك إنسانًا يسمعه، لأنه قال، أو ألقى بملحوظة هو نفسه دهش منها “لقد تصورت أنني سوف أعاقب على ما فعلته بملابسها الداخلية، لأن المني كان واضحًا وضوح الشمس”. وطبعًا لم يُعاقَب خليل.. ودهش خليل عندما كرر هذا الفعل الفاحش أكثر من مرة.. كل ذلك ونحن في هذه الصحراء القاحلة نغني “خاين وعنييه خاينين خدو مني أحلي سنييين!”، ولم يكن خليل يعرف أن ما حدث له قد حدث لي بالضبط.. ولكن يا أصدقاء هذه حكاية أخرى.