في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

مذكرات عطشجي في السكة الحديد
السؤال الآن: ماذا تبقى في ذاكرتي من تلك الحياة التي كنت أعيشها؟ ما تلك الروح الجميلة التي كنت أشعر بها تجاه هذه الحياة؟ عندما كنت أسافر بنحو 200 جمل من حوش بضائع محطة بولاق الدكرور؛ تلك المحطة التي شهدت أجمل سنوات عمري.. أو وأنا أقف وأنظر إلى هذا الكم الهائل من خطوط القضبان، والتي ارتبطت بها وعمري 17 عامًا، حين كنت خائفًا جدًا من هذه الحياة، من خبرتي البسيطة في الحياة في مقابل شخصيات عمرها ممتد منذ زمن الملكية؛ هؤلاء البشر كانوا يحبون الملك فاروق حب العبادة، حتى ذكرياتهم عن المهندسين الإنجليز أو وبورات البخار، وحالة الانضباط الأخلاقي التي سرت في عروقهم حتى امتدت إلى الأحفاد!
كنتُ منبهرًا للغاية بهذه الشخصيات؛ “عم عثمان فينو“، وعم “سعيد جوزة“، وعم “عمر القرشي“، و“محمود الأسيوطي“، و“محمود توت“.. هؤلاء بشر عاشوا في عروقي، وفي دمي، ولا يزالون حتى الآن.. كنت أجلس وأنظر إلى نحو عشرين خط سكة حديد متراصين بجانب بعضهم بعضًا، في نظام هندسي بديع، وروح التاريخ تقف منتصبة مثل تمثال الحرية.. أتامل حركة التاريخ في هذه الشخصيات.. وأنظر إلى وابورات البخار والحنين يعصف بمشاعري..
أقول: كنتُ أجلس منبهرًا بحالة الليل الممتد بلا نهاية.. وأضواء عواميد الإنارة مثل الشموع، وهي تنبثق من بين سحب الضباب والمدينة.. مدينة القاهرة هناك.. تترنح في غموض الليل.. أحيانًا في الأيام الصيفية المشمسة، كنتُ أمد بصري فأشاهد فندق “سميراميس“..
كان عندنا ملاحظ قاطرات اسمه “عبد الشكور“، وكنا نطلق عليه لقب “أفندينا” تدللاً ومحبة.. كان أفندينا يلعب القمار طول الليل وحتى شروق الشمس، وكان ذا ذراع مبتورة إثر حادث مؤلم أصابه وهو عطشجي صغير السن.. وكان لأفندينا إرادة حديدية.. يرف الكوتشينة بمهارة مدهشة.. ويستطيع أن يكسب أي إنسان يجلس أمامه على مكتب حجرة الملاحظة.. أيًّا كان هذا الإنسان؛ سواء كان سائق قطار، أو كمساريًّا، أو عامل دريسة، أو ميكانيكي قاطرات يكون سهرانًا في الوردية.. ومع ذلك كان – أفندينا– أمينًا في لعب القمار..
كان القمار هوسًا عند سائقي القطارات.. ولا أعرف لماذا هذا الجنون بلعب القمار؛ حتى إنهم أحيانًا كانوا يأتون من منازلهم في أيام الراحة من العمل من أجل اللعب.. وكانت عندهم طقوس في لعب القمار، على سبيل المثال؛ يطبخون اللحم على سخان كهرباء كبير الحجم، موجود أصلاً في حجرة الملاحظة لنصنع عليه الشاي.. في تلك الليالي كانت نفسياتهم تبدو سعيدة للغاية؛ ويلقون النكات الخشنة الفظه، ذات التلميحات الجنسية الصريحة، ويدخنون السجاير بشراهة، وتنتابهم حالات من الكرم الهائل في تلك الليالي التي تمتد للصباح الباكر.. ونظرًا إلى التربية الأخلاقية الصارمة التي كانت في محيط أسرتي، فلم أقترب من لعب القمار مطلقًا، ولا حتى لعب الكوتشينة البريء.. وفي تلك الليالي كان سلوك السائقين يصير عدوانيًّا ومخيفًا للغاية، وخصوصًا مع الشخصيات المسالمة، وقد كنتُ ببساطة واحدًا من هؤلاء المسالمين.. وكان عندهم مسمى يطلقونه على الشخصية المسالمة، وهو “رجل غلبان“، وعادة ما يصطادون أحد هذه الشخصيات ويجعلوا منه “مُسخة“.. أو بالبلدي “يكون فاكهة القعدة“، فيمسحوا به الأرض؛ من نكات وضرب على “القفا” وخلافه.. لذلك كنت شخصيًّا ما أنزوي بعيدًا عنهم.. أو أجلس خارج حجرة الملاحظة.. متحملاً، في ألم، طقس السكك الحديد شديد البرودة.. ومع ذلك كان “أفندينا” في الليالي التي يكون فيها بلا أصدقاء يترك حجرة الملاحظة، ويظل يمشي طول الليل في الشوارع القريبة حول ميدان الدقي؛ وكانت محطة بولاق الدكرور مكانًا بديعًا كما كان أفندينا يحكي” يومًا ما كانت غيطان القمح تحوط المحطة من كل جانب.. والكوبري الخشب يمر أسفله ترعة تروي كل هذه الغيطان“..
كنتُ أستمع نشوانًا بلذة الحكايات، وبالقطارات التي مرت فوق ذاكرتي في حزن: قطارات خام الفحم مثل قمم من الفيلة السوداء.. وقطارات صهاريج البنزين؛ والبنزين يخترق حاسة الشم في عنف.. كم أحببت هذه القطارات في ذاكرتي.. وكثيرًا ما تأملت في حركتها المعنوية داخل ذاتي.. على سبيل المثال؛ القطارات التي كانت تحمل البصل أو المشمش أو الطماطم أو البطاطس أو البطاطا، وهي تتجه بأقصى سرعة إلى ميناء الإسكندرية، أو ميناء السويس، أو ميناء بورسعيد، كي تلحق بالسفن المتجهة إلى أوروبا.. وكانوا يطلقون على هذه القطارات اسم “السهم الأخضر“.. وفي أحيان كثيرة كنتُ أسافر بقطار مُحمَّل بنحو 200 جمل، وكانت الجِمال تأتي مشيًا على الأقدام من سوق الجِمال القريب من محطة بشتيل وحتى رصيف التخزين، والكلَّاف يقودها في صمت، وهو يدق بعصا غليظة على بلاط الرصيف.. دقَّات موسيقية ذات رنين حاد.. الأمر الذي يذكرني بالجِمال وهي تعبر مدقَّات الصخور البركانية، وأنا جندي في القوات المسلحة مقارنة بصورة الجِمال وهي تقف أمام عربات القطار وهي تنحني بقاماتها الطويلة في ذل واستسلام.. وطبعًا غير صورتها وهي تعبر وديان جبال البحر الأحمر في صلف وشموخ، ورجال قبيلتي” العبابدة والبشارية” يمشون في المقدمة، والجِمال ذات الأعداد الكثيفة تمشي في نظام عجيب.. بصراحة كنت أشاهدها كثيرًا وأنا في نوبات الحراسة والتي عادة تكون فوق ربوة عالية، ورجال القبيلة يمشون بجانبها في ثقة بملابسهم الغريبة وشعورهم الكثيفة وكأنهم قادمون من زمن ما قبل الميلاد.. وعادة كانوا يلبسون صديريات من جلد الماعز، فوق جلباب واسع وقذر.. والعمَّة والشال الأبيض الناصع النظيف هو كل ما علاقتهم بالمدنية أو بالحضارة.. طبعًا كنت قد قرأت رواية فساد الأمكنة للكاتب الفذ صبري موسى، وكانت توجد تعليمات أمنية مشددة من ضباط الكتيبة بعدم التحدث معهم لأنهم خطرين؛ خصوصًا فيما يخص البنادق التي نحملها..
في بولاق الدكرور كان الكلَّاف يرعى الجِمال وهي تركب القطار، فأخمِّن أنه ربما يكون أقرب إلى قبيلة العبابدة في علاقته السرية بتطويع الجِمال.. فأحيانًا كان يهمهم بكلمات غامضه للجمال وهو مستمر في دق الشومة الغليظة على الأرض ذات الرنين المعدني..
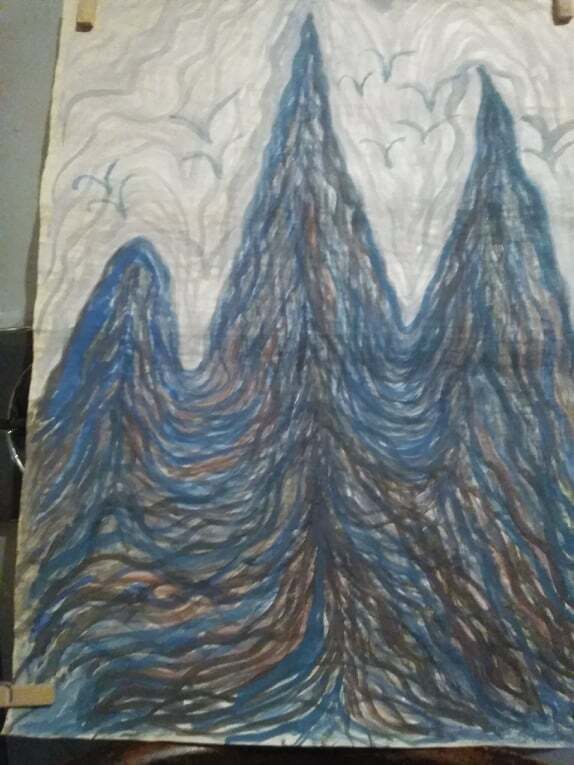 حقيقة كنتُ أحب مشاهدة هذه الصورة كثيرًا.. وكذلك وأنا في جبال البحر الأحمر؛ بل وكنت أتابعهم عن كثب.. وفي أحيانٍ كثيرة أشاهدهم وهم يستريحون من عناء السفر في هذه الجبال الوعرة شديدة الخطورة من حيث التركيب الصخري، فيهبطون في أحد الوديان، وأجدهم يشعلون النار، والجِمال تبرك بجانبهم تأكل الكلأ أو العشب.. وقليلاً، أو نادرًا للغاية ما يأتي واحد أو اثنين من هؤلاء الرجال كي يأخذ بقايا طعام مطبخ الجنود، كي تأكل الجِمال.. حينها كنت أقترب منهم قليلاً.. وأظل أتامل وجوههم شديدة السمرة، وشعر ذقونهم الذي يتدلى في وحشية.. كانوا يشبهون رجال الطوارق في الصحراء الكبرى الممتدة جنوب جبال الأطلسي في دول المغرب العربي..
حقيقة كنتُ أحب مشاهدة هذه الصورة كثيرًا.. وكذلك وأنا في جبال البحر الأحمر؛ بل وكنت أتابعهم عن كثب.. وفي أحيانٍ كثيرة أشاهدهم وهم يستريحون من عناء السفر في هذه الجبال الوعرة شديدة الخطورة من حيث التركيب الصخري، فيهبطون في أحد الوديان، وأجدهم يشعلون النار، والجِمال تبرك بجانبهم تأكل الكلأ أو العشب.. وقليلاً، أو نادرًا للغاية ما يأتي واحد أو اثنين من هؤلاء الرجال كي يأخذ بقايا طعام مطبخ الجنود، كي تأكل الجِمال.. حينها كنت أقترب منهم قليلاً.. وأظل أتامل وجوههم شديدة السمرة، وشعر ذقونهم الذي يتدلى في وحشية.. كانوا يشبهون رجال الطوارق في الصحراء الكبرى الممتدة جنوب جبال الأطلسي في دول المغرب العربي..
في حوش مخازن بولاق الدكرور كان المشهد أكثر قوة؛ حيث كان تاجر الجِمال يأتي أولاً.. وعادةً ما يكون حسن الهندام ذا جلباب نظيف.. وطبعًا يلبس عمَّة ملفوفة بشكل يجعلها تبدو مثل القرطاس، وفي أحد أصابعه خاتم غليظ من الذهب، ويمسك مسبحة طويلة ذات حبات كبيرة من الكهرمان.. ويجلس مع ناظر المحطة ثابت أفندي، أو أبو جورج.. وكانا يتحدثان حديثًا وديًّا خافتًا، تتخلله ابتسامات مهذبة، وعيونهم تشع بالثقة.. لكننا، نحن السائقين وعمال المناورة، كنا ننظر إلى هذا المشهد في صمت، لأن مهمتنا الأساسية والصعبة، كانت كيف ستركب الجِمال عربات البضاعة الضيقة نسبيًّا بالنسبة لحجم الجِمال الضخم.. في تلك اللحظة يُخرِج الكلَّاف شيئًا فظيعًا من بطن جلبابه الواسع القذر؛ ألا وهو كرباج.. وكانت الجِمال تعرف هذا العقاب.. أو تعرف هذه الأداة الجهنمية القاسية، وفي توحش بالغ يلوِّح الكلَّاف في الهواء بالكرباج مرة أو اثنتين أو حتى ثلاثة.. والكرباج طويل للغاية الأمر الذي كنا بسببه نبتعد عن حيز فرقعة طرف الكرباج في الهواء كي لا يلمسنا.. وفي تلك اللحظة تضطرب الجِمال، وتبدأ في الهرولة يمينًا أو يسارًا.. ولكن الكرباج كان طويلاً بشكل نادر.. وعجيبًا.. وصوته وهو يمرق من بين طبقات الهواء يشبه صوت سرسعة طلقات الرصاص وهي تخترق صمت الصحراء المهيب في سكونه.. ولاحظت أن الكلَّاف يحدد هدفه بجمل معين؛ ربما يكون الأكبر عمرًا في طابور الجِمال، أو الجد، أو الأكثر ذكورية، المهم كنت أجد الكلاف يبادر بتخويف ذاك الجمل وبصفة شخصية؛ فيهجم عليه أولاً.. ولا ننسى أن هناك إيقاعًا آخر يوجد حينها؛ ألا وهو الإيقاع الموسيقي ذو الرنين المعدني والجميل بحق، والذي يصدر عن الشومة الغليظة.. الكلَّاف يفعل كالمثل السياسي عندنا نحن البشر، وهو “العصا والجزرة“؛ فتكون الشومة ذات الرنين المعدني الجميل هي الجزرة، والكرباج هو العصا.. وبمجرد أن يركب الجمل “الجد“، أو الزعيم، تركب بقية الجِمال بطواعية وخنوع واستسلام.. عند هذه النقطة أهم بركوب القاطرة كي تبدأ رحلة السفر..
كثيرًا ما كنت أنظر في عيون الجِمال وهي تنظر من بين التجويف المعدني لعربة القطار، وكان الكلَّاف عادة ما يضع كميه كبيرة من التِبْن أو العلف.. وكنت بصفة شخصية، أحب ذلك الهواء والمنبعث من أرضية العربة، وذلك بسبب اختلاط روث الجِمال مع التبن؛ فأشم انبعاث غاز النيتروجين في أنقى شعور لحاسة الشم..
في جبال البحر الأحمر كانت صورة حركة الجِمال بين مدقات الجبال مذهلة في إحساسها النفسي، ربما لتضاد لون جلد الجِمال الأصفر مع لون الجبال الأسود أو الأحمر.. والجِمال تمر ببطءٍ شديد وسط الجبال، وهي تصعد وتهبط هذه المدقات البركانية شديدة الوعورة والخطورة.. فعند المنحدرات على سبيل المثال أجد هذه الجِمال وهي تهبط مسرعة وبشكل رأسي لتأخذ بعدها في المسير بشكل أفقي، وذلك عندما يستقيم المدق الصخري، فكنت أشفق على الجِمال وبشدة؛ مثلما كنت ألتمس لها العذر عندما أراها تختبئ برؤوسها بسب عنف وسرعة وقوة القطار القادم من الاتجاه العكسي..
كل ذلك ولم أجب على سؤال: لماذا يذهب عم عبد الشكور، أو أفندينا، في ورادي الليل إلى الشوارع الجانبية لميدان الدقي يبحث ويدقق في أكوام الزبالة، على الرغم من أنه ميسور الحال.. لكن هذه حكاية أخرى!