في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

هذا نص غير أكاديمي تراكم في أثناء التجوال بمسارات متعرجة في الإسكندرية وبرشلونة ومدن أخرى، بين قصاصات ورق وصفحات إنترنت وكتب ومقالات وأفلام ولقاءات (فردية وجماعية) مع ناس، وخرج في صورة مقاطع تأمل أن تفتح نقاشًا حول الأسئلة والمواضيع المختلفة التي تطرحها عن تيمة الحركة والتيه في المدينة.
في الثانية من ظهر الجمعة 25 ديسمبر 2015، قررت، على غير العادة، أن أنزل وكلي نشاط وحيوية، مبكرًا ساعة عن موعد اللقاء حول برنامج ماس الإسكندرية لدراسة الفنون للعام 2016، وأتوجه من أبي قير، حيث أسكن، إلى مقر “ماس الإسكندرية” دون سؤال أحد من أصدقائي –الطلبة السابقين في برنامج ماس لدراسة الفن– وأن أعتمد على نفسي، وعلى العنوان المبيَّن في خريطة جوجل الموجودة على صفحة “ماس الإسكندرية” على فيسبوك.. (شارع المدينة المنورة. المنشية البحرية).
ما أسمعه دائمًا أن مقر “ماس” يقع في شرق المدينة، في أول ميامي– عبد الناصر لكن مؤخرًا نما إلى علمي أنهم يعتزمون الانتقال إلى مكان جديد أكبر وأوسع؛ فخمّنت أن هذا العنوان الموضح على خريطة جوجل هو عنوان المقر الجديد. ركبت (مشروع) المحطة، ونزلت آخر شارع 45، وهناك سألت كيف أذهب إلى المنشية البحرية التي لم أسمع بها من قبل كإحدى مناطق الإسكندرية قبلي أو بحري! ثم ركبت تاكسيًا ووصلت إلى المنشية البحرية؛ والمنشية البحرية عزبة أو ضاحية بين القرية والمدينة، شوارعها بين التراب والطين والإسفلت، مليئة بالتكاتك ومبانيها غابة عمرانية بين العمارات الطويلة والمباني القصيرة الريفية من الطوب الأحمر. وظللت أمشي في شوارعها باحثًا عن (شارع المدينة المنورة) وكلي أمل وشك وسؤال “هل يمكن أن توجد مساحات للفن (معاصر أو غير معاصر) والثقافة في العزب والضواحي؟“. أسأل الناس والمحلات وأتوه، وتذكرت فالتر بنيامين وفن التيه في الشوارع والمدينة وذم الـ (جي بي إس GPS). وأخيرًا، رضخت واتصلت تليفونيًّا بصديق؛ فقال إنه لا يعرف سوى عنوان ميامي. وصلت اللقاء متأخرًا على عكس ما كنت أطمح، مقر ” ماس الإسكندرية” في 2 شارع المدينة المنورة متفرع من شارع جمال عبد الناصر، يعتبر في أول ميامي شرق الإسكندرية. أفكر الآن في أنه ربما يكون تتبع المواقع الموضوعة بالخطأ على ال GPS مساحة لاستكشاف تصور ورؤية مختلفة ونقدية للمدينة.
يمكننا أن نعتبر الـ GPS نظام التموضع العالمي الذي يعمل على الهواتف الذكية و أجهزة الملاح “النافيجتور“، أحد تجليات مجتمع السيطرة.
هو نظام ملاحة عبر الأقمار الصناعية يقوم بتوفير معلومات عن الموقع والوقت في جميع الأحوال الجوية في أي مكان على أو بالقرب من الأرض؛ حيث هناك خط بصر غير معاق لأربعة أو أكثر من أقمار الـ GPS. يوفر النظام قدرات مهمة للمستخدمين العسكريين والمدنيين والتجاريين في جميع أنحاء العالم. أنشأت حكومة الولايات المتحدة النظام وهي التي تحافظ عليه وجعلت الوصول له مجانيًّا لأي شخص لديه جهاز استقبال GPS.
بدأت الحكومة الأمريكية مشروع الـ GPS في 1973 للتغلب على قيود نظام الملاحة السابق، فدمجت أفكارًا سابقة من ضمنها دراسات هندسية سرية من ستينيات القرن الماضي. وفي أثناء الحرب الباردة طورت وزارة الدفاع الأمريكية النظام لأغراض عسكرية بحتة لخدمة الجيش الأمريكي وحلفائه، استعمل في الأصل 24 قمرًا صناعيًّا. أصبح النظام يعمل بشكل كامل في 1995. وقد أدى التقدم في التكنولوجيا والمطالب الجديدة على النظام القائم إلى تحديث نظام الGPS وتنفيذ الجيل القادم وهو الـ GPS III (ويكيبيديا).
“إنت شغلتك إنك تمشي على الـ GPS ” مستخدم أوبر إلى سائق أوبر. وأوبر هو تطبيق للهواتف الذكية ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009، طورته إحدى شركات “اقتصاد المشاركة” في سان فرانسيسكو بكاليفورنيا، وراج استخدامه في مصر والعالم في السنوات الأخيرة. لا يتطلب العمل من سائق أوبر إلا أن يكون لديه سيارته الخاصة المكيفة، وأن يتلقى تدريبًا على التعامل مع التطبيق والـ GPS وأن يتعامل بصورة جيدة ومرضية مع المستخدمين والزبائن؛ حيث إن السائق يخضع للمراقبة والتقييم من قبل شركة/مكتب أوبر في البلد التي يعمل بها وكذلك من قبل الزبائن والمستخدمين.
يعمل سائق الأوبر دون حقوق عمل أو تأمينات صحية واجتماعية طمعًا في الأجر الجيد والحوافز التي تتحدد وفقًا للتقييمات الجيدة التي يحصل عليها من قبل المستخدمين ومكتب أوبر والتي تتحدد بدورها بناءً على حسن معاملته للزبائن ومدى تتبعه لمسارات الـ GPS.
يقع سائق الأوبر تحت السيطرة الكاملة للـ GPS الذي يعمل بالأقمار الصناعية كأنه تحت مراقبة كاميرات وسلطة لا يراها من ناحية، وسلطة أخرى يراها هي سلطة الزبائن والمستخدمين وتقييماتهم.
سلطة الـ GPS اللا مرئية تلك تعطي لمستخدم الأوبر – والذي كثيرًا ما يكون من السياح أو من طبقات برجوازية – إحساسًا زائفًا بالأمان لأنه يعرف أنها أقوى من السائق وتتحكم فيه وفي أجره وحوافزه وتلغي أي قرار له، ويعرف كذلك أن التطبيق يمنحه سلطة التقييم التي تداعب السلطوي الذي بداخله ليتحكم هو نفسه أيضًا في أجر وحوافز السائق إذا قال كلمة أو تصرف تصرفًا لا يليق من وجهة نظر هواه.
السائق أيضًا يعرف كل ذلك جيدًا، وهو دائمًا ما يشعر بالضغط والقلق حيث يجب عليه أن يكون في أعلى درجات التركيز واليقظة في تتبع الـ GPS حتى لا يخطئ أو يتوه أو يشعر المستخدم بعدم الأمان، وبالتالي يحصل على تقييم سيء، كما أنه لا يمكن أن يقترح اختصارًا أو تخريمة في الطريق خلافًا للـ GPS حتى لا يتعرض للخصم من قبل مكتب أوبر.
بإختصار، يجعل أوبر من السائقين أناسًا تحت السيطرة الكاملة لسلطة الـ GPS والتطبيق، أناسًا بلا أدنى صلاحية داخل سياراتهم، ممتلكاتهم الخاصة، لا لأنه مع الملكية العامة، ولكن ليأخذ تلك الصلاحية ويتشاركها ويوزعها ويخضعها لسلطة المستخدمين كمرحلة مؤقتة حتى يبدأ العمل بنظام السيارات ذاتية التشغيل والتي ستعمل على الـ GPS كروبوتات وتلغي العنصر البشري/ السائقين نهائيًّا.
سائق أوبر الواقع تحت سيطرة الـ GPS ومكاتب إدارة التطبيق في كل بلد، انضباطه وحرصه المصطنع على رضا المستخدم/الزبون من حيث ( نظافة السيارة وجودة التكييف وتنوع الأغاني والموسيقى ومحطات الراديو والكراسي المريحة .. إلخ) يذكرني ببطل فيلم الدراما الفانتازي (المحركات المقدسة) لليو كراكس – إنتاج 2012، الذي يعيش حياته كممثل يستعرض من مشهد لآخر، يتحرك عبر مدينة باريس من موعد لآخر من خلال سيارة تقودها سيدة تحت سيطرة كاميرات لا يراها تحيط به في كل مكان، يكبر ويشيخ وتفلت منه لحظات يتذكر فيها إنسانيته وحبه ويحن إلى عصر كان يرى فيه الكاميرات لكن أوان ذلك قد فات، يذهب إلى المشهد الأخير ليجد أن زوجته وابنه من حيوانات الشمبانزي!
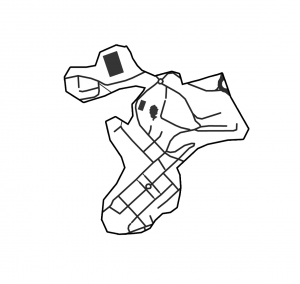
التوهان في المدينة، في تصوري، لا يعني فقط التوهان الفعلي في الشوارع والطرق وعدم تمييز المناطق، لكنه يعني أيضًا، وفقًا لاستراتيجيات المواقفيين التخريبية، تحرير الرغبة وروح المغامرة واللعب واختبار أدرينالين التهديد والأحاسيس والعواطف المختلفة عندما نخرج من المناطق والمسارات التي نحفظها عن ظهر قلب بفضل هيمنة مشاوير العمل والتعليم والسياحة (دائرة السيطرة والسلطة ورأس المال) على حياتنا، لنتحدى تخطيط المدن وسطوة الخرائط ونتحرك فرادى أو جماعات بمساعدة خرائط خاطئة وأوفلاين بلا هواتف ذكية بلا GPSأو تحت تأثير نشوة مزاجات مختلفة في المناطق المتنوعة في مدينتنا التي نعيش فيها، أو في مدن لا نعرفها جيدًا.. لنلعب بالمدينة ومعها ربما نستطيع إحساس وفهم ورؤية تلك المدينة بشكل نقدي وجديد ومختلف.
(سؤال اعتراضي: كيف يمكن لامرأة على سبيل المثال أن تقوم بذلك في بلد مثل مصر دون أذى أو مخاطرة كبيرة؟!) عن نفسي، ليس لدي أدنى فكرة أو رغبة للحديث بالنيابة عن أحد. فقط أطرح السؤال الذي أعتقد أنه يجب مناقشته ومشاركة حكاياته وتجاربه والحديث عنه حتى لا يصبح ما نقوله أضغاث أحلام مفرطة الرومانسية.
في 2016، ظهرت لعبة “بوكيمون جو” في مصر ودول كثيرة من العالم كتطبيق على الهواتف الذكية التي تحتوي على GPS وكاميرا تعتمد على تقنية “الواقع المعزز” التي تم تطويرها هي أيضًا عبر أبحاث عسكرية وتعتمد على إسقاط الأجسام الافتراضية والمعلومات في بيئة المستخدم الحقيقية على عكس تقنية “الواقع الافتراضي” القائم على إسقاط أجسام حقيقية في بيئة افتراضية
“في أزمنة الإرهاب، حين يصبح كل فرد متآمرًا من نوعٍ ما، يكون كل فرد في وضع يكون عليه فيه أن يلعب دور المخبر السري. والتجوال يتيح له أفضل الإمكانات لعمل ذلك . كتب شارل بودلير “المراقب أمير يتمتع في كل مكان بمجهوليته“. وإذا تحوّل المتسكع على هذا النحو إلى مخبر سري رغم أنفه، فإن ذلك يفيده اجتماعيًّا بدرجة كبيرة، لأنه يضفي قيمةً على كسله. إنه يبدو خاملاً فقط، فوراء خموله انتباهُ مراقبٍ لا يرفع عينيه عن أي وغد . لذلك تنفتح أمام المخبر السري آفاقٌ واسعة لتقديره لنفسه. ويطوِّر أشكالاً من رد الفعل تتماشى مع إيقاع المدينة الكبيرة. إنه يلتقط الأشياء وهي طائرة؛ ويتيح له ذلك أن يحلم بأنه مثل فنان. فالجميع يمتدحون سرعة قلم الفنان الجرافيكي. ويزعم بلزاك أن البراعة الفنية في حد ذاتها مرتبطة بسرعة الالتقاط.
الإطار العام لرواية دوما بعنوان موهيكان باريس Mohicans de Paris هو الحصافة في علم الإجرام مقترنةً باللامبالاة البهيجة للـمتسكع . يقرر بطل هذا الكتاب أن يمضي بحثًا عن المغامرة عن طريق تتّبُع قصاصة ورق ألقاها للريح لتلعب بها. ومهما كان الأثر الذي يقتفيه المتسكع، فسيؤدي بكل واحدٍ منهم إلى جريمة” (فالتر بنيامين بتصرف، باريس الإمبراطورية الثانية عند بودلير، ت: أحمد حسان)
على عكس متسكع باريس القرن 19؛ الذي كان على هامش المدينة الكبيرة وهامش الطبقة البرجوازية، يعيش داخل البواكي (أشبه ما تكون بالمولات اليوم) والتي تعد المنزل والشارع (النجوم) بالنسبة له، يتفرج على السلع خلف الفاترينات الزجاجية لمتاجرها ويروج لها بازدحامه حولها لكنه لا يستطيع أن يشتريها ويتجول شاعرًا بالعزلة أحيانًا وسط زحام المدينة الكبيرة ليبحث عن مغامرة (صورة بودلير الشاعر المتسكع الرومانسية التي رسمها بنيامين)، انتشرت لعبة البوكيمون جو في مصر والعالم انتشار النار في الهشيم في مراكز المدن وضواحيها وبشكل عابر للطبقات الاجتماعية.
بصرف النظر عن تهديد اللعبة للخصوصية على أهميته وهو ما يمكن بحثه فى مجال آخر، يتحرك لاعبو البوكيمون في المدينة بالسيارات أو مشيًا على الأقدام بحثًا عن البوكيمون بأنواعه كمحققين أو مخبرين أو مسحورين ليكتشفوا جرائم بالمصادفة، أو يتسببوا في متاعب لأنفسهم أو يرتكبوا جرائم فادحة من وجهة نظر مؤسسات وسلطات الهيمنة والضبط. لذا، أصدر الأزهر بيانًا يقول إن اللعبة جعلت الناس كالسكارى، وأعربت كثير من الحكومات والمؤسسات العسكرية عن قلقها وخوفها من اللعبة واتخذ البعض إجراءات بالحظر والمنع.
فلاعب البوكيمون لا يشغل باله سوى أن يصطاد ويلتقط البوكيمون، يسعى وراءه في كل أماكن وفضاءات المدينة دون أن يقيم لها وزنًا أو قيمة أو أهمية، يجري وراء البوكيمون في المساجد والكنائس وأقسام الشرطة والأماكن التاريخية والأثرية والسياحية ولا يراها. لا يرى أو يهتم أو يبحث إلا عن البوكيمون وفي أثناء ذلك، وربما دون أن يدري، يفضح أصنام المدينة ويسخر من أساطيرها ولا يبالي بهالاتها ويقاوم الخوف من هيبة مؤسساتها لأنه عندما يدخلها.. لا يدخل تحت سيطرتها؛ بل يدخلها ليلعب وذلك بالطبع قد يعرض هؤلاء اللاعبين إلى الخطر والأذى.. وربما الهلاك.
في النهاية، في ظل تعقيدات عصر اقتصاد الاتصالات والشبكات والخدمات الذي نعيشه، قد نعتبر “البوكيمون جو” لعبة أصبحت جَدًّا، لكنها تظل لعبة تأخذ وقتها وصرعتها كأي موضة ويحل محلها مع تطور تكنولوجيا تطبيقات الألعاب الذكية لعبة/تطبيق/سلعة أخرى تشغل بال وعقول الناس. وبناءً على ذلك، يبدو لنا أنه من الصعب التعامل مع لعبة/تطبيق/سلعة مثل البوكيمون جو باعتبارها تكنيك مقاوم للسيطرة على مسارات حركتنا في المدينة.

المخرج الألماني هارون فاروقي عام 2007
تصوير Hertha Hurnaus
جرت العادة على أن يكون مجاز المدن الحديثة الكبيرة هو السيمفونية، استعارة تعكس التناغم بين الإنسان والآلة بعد صراع طويل مع الثورة الصناعية التكنولوجية في مدن مختلفة أوروبية وغيرها، استطاعت الطبقات العاملة أن تقتنص من الرأسمالية والملكية حقوقها في ساعات عمل محددة وإجازات ورواتب جيدة وحوافز وتقنين عمالة وتشغيل الأطفال. حيث يمكننا أن نرى تمثيل ذلك التناغم في أفلام تجريبية طليعية أُنتجت في عشرينيات القرن الماضي مثل “الرجل ذو كاميرا السينما” لدزيجا فرتوف و“برلين: سيمفونية مدينة” لوالتر روتمان، لنجد صورًا صامتة مفعمة بالدراما عن طريق التقطيع وتقنيات المونتاج على مدار يوم منذ الاستيقاظ وحتى الليل لحياة العمال والناس داخل المصانع ومواقع الإنتاج وخارجها في وسائل المواصلات والأماكن المختلفة وشوارع المدينة.
لكن المدينة الحديثة أيضًا (في القرن 19 وحتى منتصف 20) كانت مكان الانضباط والنظام وتحديد المسارات، كانت، وفقًا لفوكو، حاوية مؤسسات الضبط (المدرسة والمستشفى والسجن والمصنع) ومع حلول أواخر القرن 20 وتحول الاقتصاد الرأسمالي المهيمن إلى اقتصاد خدمات واتصالات وشبكات من بينها الشبكة الأهم: الإنترنت. انقلب السحر على الساحر؛ وسيطرت التكنولوجيا على المدينة، وسيطرت المدينة المعاصرة على كل مناحي حياتنا الخاصة والعامة، داخل المنازل وخارجها.
أهلا بكم في مجتمع السيطرة (وفقًا لدولوز). كاميرات المراقبة تراقب كل شيء، تراقب الشوارع وإشارات المرور وأعمدة الإنارة والمقاهي والمولات والمحلات وعربات المترو والمواصلات العامة وبواباتها ومحطاتها.
أنت أونلاين ولديك بطاقة ائتمان.. إذن أنت موجود. إن لم تكن أونلاين وليس لديك بطاقة ائتمان فأنت خارج العالم.. خارج التاريخ، وخارج المنافسة، وخارج الفرص. اختفت الدراما من فضاءات المدينة، لتظهر في غرف التحكم (غرف تحكم المترو والمرور والقطارات) كما يمكن أن نرى في تجهيز فيديو “الموسيقى المضادة” للمخرج والفنان الألماني هارون فاروقي – إنتاج 2004.
نعيش في مدننا العربية ومدن العالم الثالث جزءًا من العالم أجمع تحت مراقبة سيطرة التكنولوجيا، بالإضافة إلى سلطة مؤسسات الضبط التي تعمل بالكفاءة نفسها. نعيش مثل طفلة فيلم جودار التليفزيوني المسلسل (فرنسا/جولة/لفة/طفلين) – إنتاج 1978 التي تسير إلى المدرسة في طريق تعرفه وتحفظه جيدا كأنها تتحرك على خط هندسي مستقيم من نقطة إلى نقطة تحت سطوة “جرس المدرسة” دون أن تتوه، دون أن ترى شيئًا من جغرافيا المدينة التي تعيش فيها.
(عمل – مترو – نوم) مارك أوجيه في “أتنولوجي في المترو” مختصرًا حياة الباريسيين – فى الإسكندرية، تحت وطأة تعب العمل، يبدأ النوم في الطريق الطويل للعودة إلى المنزل، في أوتوبيسات العمل والمواصلات، تحديدًا قطار أبي قير. نعيش..نلف..ندور في دوائر؛ نستيقظ من النوم، نذهب إلى أسباب استمرار حياتنا وتعاستها، نذهب إلى العمل، وإلى الدراسة (التعليم) كمسرنمين يجذبهم مغناطيس. في مسارات معروفة نحفظها جيدًا تحت سيطرة إعلانات تحتل رؤيتنا وإعلام إذاعى يحتل مسامعنا، كل يوم حتى عطلة نهاية الأسبوع، نذهب إلى البارات، وإلى الكلوبات، وإلى المقاهي وزيارات الأهل حتى يبدأ أسبوع جديد لنكرر الدائرة مرة أخرى. ولو أتيحت لنا فرصة زيارة مدن أخرى، غالبًا ما نذهب في جولات سياحية مبرمجة يشرف عليها مرشد لنزور الأماكن السياحية والأثرية التي ترسم الصور النمطية للمدن.
في الفيلم الرومانسي “البحر بيضحك ليه” إنتاج 1995 والذي أهداه مخرجه محمد كامل القليوبي إلى صناع فيلم “البحر بيضحك” استيفان روستي وأمين عطا الله إنتاج 1928 والذي يتناول حياة شرطي في مدينة الإسكندرية، نجد “حسين” الموظف ابن الطبقة المتوسطة الذي يعمل في مدينة الإسكندرية أيضًا ويعيش حياة منظمة ورتيبة ومملة، يتمرد عليها بعد أن يستيقظ مفزوعًا على توبيخ زوجته لأنه نام بالبنطلون؛ فيصفعها على وجهها ويصفع أخته التي تعيش معه ويذهب إلى عمله ليصفع كل زملائه ورئيسه وأصدقائه على وجوههم ويبيع سيارته ويخرج ليتسكع في شوارع المدينة ليقابل متسكعًا آخر “سيد بُص” الذي يعمل كما يقول في “الدعاية والإعلان” لأنه ينادي مروجًا لسلع الفرشات والمحلات الجديدة المختلفة، ليبدو وكأنه هو نفسه سلعة تطلبها تلك المحلات. يترك “حسين” البدلة والكرافتة ويحب حاوية تجوب الشوارع ويصبح حاويًا يكشف زيف حياته السابقة.
في الأعياد (الأضحى والفطر)، يأتي الشباب الصغير والمراهقون من الضواحي والتوسعات العمرانية شرقًا وغربًا من أبناء الطبقات العاملة ومحدودة الدخل ليفرضوا سطوتهم على محطة الرمل والمنشية وبحري “حدود وسط البلد” في الإسكندرية، وأيضًا في القاهرة لعدة أيام في اتفاق ضمني غير مكتوب مع باقي سكان المدينة الذين اعتادوا القدوم والحياة في وسط البلد بشكل شبه يومي بأن يتركوا لهم حرية الحركة فيها طوال تلك الأيام.
هؤلاء المراهقون وصغار الشباب الممتلئون بمشاعر وأحاسيس “الذكورة الجريحة” حيث يعانون كبت وقمع سلطة أهاليهم وذويهم الأبوية المتحكمة فيهم في مناطقهم والتي لا يقدرون على مراوغتها إلا سرًّا لذا – كما تقول لوسي ريزوفا في دراسة لها عن وسط مدينة القاهرة – يهربون إلى وسط البلد المحرومين منها معظم أوقات العام، ليتحرروا قليلاً من سيطرة تلك السلطة الأبوية، وليكتشفوا ويحرروا أحاسيسهم وأجسادهم وشهواتهم المنهكة بعيدًا عن تلك السلطة وسط “الأغراب“.
يتخذ ذلك أشكالاً مختلفة منها أشكال عنيفة (مثل حوادث التحرش والعنف الجسدي والجنسي التي لا تميز أحدًا غريبًا كان أو قريبًا والتي ندينها أشد الإدانة والتي نرى أنها تحتاج بحثًا مفصّلاً ومنفصلاً لمحاولة فهم تعقيداتها وتفسيرها) وأشكال أخرى، هي التي تعنينا هنا، حيث اللعب بالمدينة وزحزحة أسطورة وسط البلد وتحرير الرغبة في شوارعها وأماكنها المتيبسة عن طريق فرض منطقهم وطريقتهم الخاصة للاستمتاع والاستكشاف على عكس النمط المهيمن على وسط البلد ونقاطها الرئيسية.
فنجد الرقص في مجموعات على أغاني “المهرجانات” في الشوارع والتنطيط أمام المباني العريقة ذات الماضي الكولونيالي البرجوازي والحركة بعربات الكارو (المعتادة في الضواحي) في قلب محطة الرمل ودخول السينمات أفواجا لمشاهدة والتفاعل مع “محمد رمضان” الذي يمثل تجسيد صورة البطل الجماهيري الشعبي المصطنعة، صورة الحلم/التحدي بالنسبة لهم حيث إنه يقيم أسطورته في أفلامه ومسلسلاته في منطقته وليس بعيدًا عنها.
أما أبناء الطبقة المتوسطة فيفضلون الذهاب للتسكع في طرقات المولات، يفضلون أن يروا أنفسهم في صور وأحلام الاستهلاك والتطلع الطبقي في فضاءات السلع في “كارفور” و“سان استيفانو” وقبلهما “جرين بلازا” أو يأخذوا “المشاريع” من ميامي (شرق الإسكندرية) إلى مول العرب في 6 أكتوبر بعيدًا عن أعين الأهل والأقارب.

تبدو لي العمارة “الجميلة” والمباني التراثية ذات الطرز المعمارية الفريدة والمتاحف والأماكن والمواقع الأثرية والشوارع القديمة مثل (وسط المدينة الذي عادة ما يكون بفعل حركة التاريخ مكانًا غير متجانس ومتضارب المصالح)، وسط البلد في القاهرة ومحطة الرمل في الإسكندرية وعمارة “جاودي” في برشلونة والتي تمثل معاقل “الجمال” المحنط المشيد كأطلال، المغناطيس الذي يجذب السياح والفنانين والمثقفين والباحثين وتُبنى عليه أسطورة المدينة وسرديتها وصورتها النمطية (الكارت بوستال) لكنها أيضًا تمثل غطاءً وستارًا وحجابًا يمنعنا من استكشاف المدينة.. أقصد الجزء الأكبر منها: ضواحيها ومناطقها المختلفة وتوسعاتها العمرانية. فكما تقول حنة أرندت في كتابها “الوضع البشري” دائمًا ما تبدو وجهات المصانع الخارجية التي يراها الناس جميلة وفخمة وذات طرز معمارية فريدة كمبالغة لإخفاء كم البشاعة و“القبح” وقسوة الظروف التي يعيشها العمال داخل المصنع.
فضاء تلك العمارة العريقة الضيق هو مسرح أحداث رواية لورانس داريل “الجميلة” (رباعية الإسكندرية) المتمترسة بعالم كاتبها والمشغولة بشخصياتها “الأجنبية” وعلاقاتهم وأجسادهم والتي لا نرى فيها المدينة، الإسكندرية، ولا أهلها من المصريين أو (العرب على حد تعبير داريل) إلا من خلال صورة استشراقية غرائبية نمطية، نسمع منها أزيز أصوات مضاجعات هؤلاء العرب الذي يزعج ويشوش على أفكار بطل الرواية الإنجليزي في أثناء تفكيره وتمشيته!
أفكر أن علينا نحن، الفنانين والمثقفين والكتاب والباحثين والأكاديميين، المعنيين بفهم أعمق ونقدي للمدينة أن نحاول أن نخرج من مناطق راحتنا ونفوذنا، مع التفهم الكامل للصعوبات الناتجة عن عمل ذلك أحيانًا، لنستكشف بحق المدينة وعمرانها وضواحيها ومناطقها. ليس في زيارات سريعة واستشراقية (بشكل آخر) لا تؤدي في النهاية إلا إلى أطروحات ومحاولات (تجميل الفقر أو تجميل القبح) التي تعكس مبالغة أخرى وإعجابًا وانبهارًا بائسين بـ “حياة الفقراء والغلابة الجميلة“! وتنم للأسف عن موقف طبقي مقيت.
مثلما نرى ذلك في رواية ” 2666″ ( خمس روايات في واحدة) للروائي التشيلي روبرتو بولانيو الذي عاش آخر أعوام حياته في برشلونة، حيث نجد في أحد الأجزاء رواية أربعة نقاد أكاديميين بيض يثقون بالثقافة والفن مسلِّمين بإخفاق الأيديولوجيات قادمين من أوروبا إلى مدينة مكسيكية على الحدود مع الولايات المتحدة الأمريكية ليبحثوا عن كاتب ألماني مفقود ومختف لكنهم يجدون جرائم قتل بشعة فيحملون الفظاعة المروعة على مسألة جمالية وينكفئون على أجسادهم وينتهي بهم الحال محتقرين للمدينة وأهلها وقذارتها وجرائمها.
على عكس بولانيو نفسه، الذي ينحو منحى جماليًّا جذريًّا يكشف ذلك القبح، فيخصص رواية لتلك الجرائم والتي يراها كـ “مرآة إحباطاتنا وتأويلنا السافل لحريتنا ورغباتنا” حيث يقوم بتخييل وقائع مقتل 430 سيدة عاملة بأبشع الصور في مصانع تلك المدينة.
استلهامًا من ذلك، أفكر ألا تخدعنا وتضللنا طويلاً واجهة العمارة “الجميلة” وأن علينا أن نحاول كشف البشاعة و“القبح” القابع في عمران مدننا والذي هو أيضًا الحكم الجمالي الأنسب للفشل السياسي والاقتصادي الناتج عن السلطوية والهيمنة عن طريق الدراسة والبحث الميداني والمعايشة والتواصل والزيارات المطولة حتى نحاول أن نحلل ونفهم بعمق تعقيد الحياة والصراع في عمران المدينة، لربما يكون ذلك هو الانحياز الأقرب نحو الجمال.
“ألا تجد طريقك في مدينة ما، لا يعني الكثير، أمّا أن تتوه في مدينة مثلما يتوه المرء في غابة فذلك يحتاج إلى تدريب“. (فالتر بنيامين – طفولة برلينية في مطلع القرن العشرين – ت :- أحمد فاروق).
في حر يوليو، الصيف الماضي، زرت برشلونة. تعج المدينة بالسياح القادم معظمهم من مدن أوروبية مختلفة لتمضية إجازة الصيف في برشلونة، فهي مدينة أوروبية لا تزال، ليست بعيدة جدًا عن مدنهم، وهي ساحلية وجوها لطيف ومعتدل، وأسعارها رخيصة مقارنة بالمدن الأوروبية الكبيرة الأخرى.
كنا، عندما نشعر بالاختناق من كثافة الأجواء السياحية في قلب المدينة وحولها في (الرافال وجراسيا) نهرب إلى الضواحي. ذهبنا إلى “الهوسبيتالات” و“بيل فتشي” مرورًا بـ “سانت” التي كانت منطقة مصانع عندما كانت برشلونة مدينة صناعية في المقام الأول في القرن 19 وحتى منتصف القرن 20. الآن، تحولت بعض من مصانع “سانت” إلى تعاونيات ومساحات فنية. أما “الهوسبيتالات” و“بيل فتشي” فهي غابات عمرانية تتوه فيها، مناطق سكن الطبقة العاملة منذ النصف الثاني من القرن 20 والتي تمتلئ بمبانٍ سكنية ضخمة “قبيحة” وأجواؤها تبدو ذكورية وأسعارها أرخص من وسط المدينة. وفي مرة أخرى، زرنا “مستعمرة جويل“، موقع سياحي لكنه مثير للاهتمام في قلب ضواحي برشلونة الآن.
مستعمرة جويل الصناعية والتي تم بناؤها عام 1890 كتجسيد للحداثة الكتالونية وعمارتها لصالح عائلة جويل الرأسمالية وقد تم تشييدها كمدينة متكاملة مصغرة في عزلة الضواحي بعيدًا عن المدينة الكبيرة برشلونة. تتكون المستعمرة من مصنع للنسيج والأقمشة، وبيوت العمال، وبيت وعيادة طبيب، وبيت مدرس، ومدرسة، وبيت للإدارة، ومسرح للأنشطة الترفيهية، ونادٍ اجتماعي يحتوي على بار للعب الورق ومكتبة تخضع كتبها لرقابة الإدارة وبلياردو ومكان لتدريبات كورال بنات العمال على أغانٍ تمجد قيم العمل ومكان لتعليم الفتيات ومكان آخر للراهبات لرعاية المولودين الجدد في المستعمرة ولرعاية المرضى. وكذلك كنيسة غير مكتملة و مبهرة، صممها وشيدها معماري الحداثة الكتالونية ومعماري عائلة جويل المفضل أنتونيو جاودي والذي كان يتعامل مع تلك الكنيسة كمعمل للتجريب والعمل على تصميم وتشييد عمله الأشهر كنيسة “العائلة المقدسة” في قلب برشلونة.
يوجد أيضًا في المستعمرة معرض سياحي ودعائي عن الصناعة الكتالونية والمستعمرات الصناعية، يعرض فيه فيديو تخيلي مدته 12 دقيقة يعكس السردية الرسمية القومية الكتالونية حيث يتخيل من منظور طفلة حياة العمال وأهاليهم كأناس سعداء ومبتهجين، يعشقون ويقدسون العمل والحياة في المستعمرة مثل بطلة فيلم passion أو الشغف لجودار – إنتاج 1982 والتي كانت تقول بمنتهى الرومانسية أن حركات ممارسة الحب تشبه كثيرًا حركات ممارسة العمل! يتم ذلك بالطبع دون أي حس نقدي يناقش فكرة المستعمرة الصناعية كنظام ضبط شامل متكامل يتكون من مؤسسات ضبط المصنع والمدرسة والعيادة والكنيسة ليتحكم ويحتل ويسيطر على حياة وأوقات العمال وعائلاتهم داخل العمل وخارجه.
في مصر، مع خطة التحديث والتصنيع الثانية في ستينيات القرن الماضي، قامت الدولة ببناء مستعمرات صناعية كثيرة في ضواحي الإسكندرية وفي المحلة وغيرها. أفكر أننا بحاجة إلى دراسة تاريخ تلك المستعمرات الصناعية من خلال الأرشيفات والمرويات من منظورات مختلفة بشكل نقدي للسردية الرسمية للدولة فيما يخص خطط وبرامج التحديث والتصنيع.
قال لي صديق، إذا اعتبرنا أن “السياحة” هي المسار الذي يميز أعلى سلم الصراع الطبقي بين مدن العالم، فإن “الهجرة” هي المسار المقابل الذي يقبع في أسفل ذلك السلم. مجموعات مثل المهاجرين وعاملات الجنس وعاملات التنظيف والمنازل، مجموعات موصومة بأحاسيس العار والخوف بسبب سيطرة السلطات والطبقات المهيمنة على الشوارع والفضاءات العامة؛ لذا نجد وجودهم في المدينة شبحيًّا أو مؤقتًا، أو ربما دائمًا في أماكن بعينها. يتحركون في المدينة في مسارات ملتوية رغما عنهم وليس باختيارهم.
نحن لا نراهم ولا نريد، بل نرى آثارهم، نرى ونذهب إلى محلات الشاورما والأكل السوري لكن لا نريد أن نعرف شيئًا عن حياة اللاجئين والمهاجرين السوريين في ضواحي الإسكندرية شرقًا وغربًا. نرى عربات التسوق التي تستخدم لحمل ملابس المهاجرين ومنتجات إعادة التدوير التي يعملون في تجميعها لكن لا نريد أن نعرف شيئًا عن حياة هؤلاء المهاجرين الجنوبيين في أزقة (ال رافال) في برشلونة.
نحن كـ (مخدومي فيلم ماهر أبي سمرا) نريد بيوتنا ومنازلنا نظيفة تلمع لكن لا نريد أن نرى أو نعرف شيئًا عن حياة عاملات المنازل اللاتي يقمن بذلك.
“الجنتريفيكاشن” مصطلح ظهر تقريبًا في ستينيات القرن الماضي ليعني “البرجزة” أو “الإحلال الطبقي العمراني” حيث تحل الطبقات البورجوزاية والشرائح العليا من الطبقة المتوسطة لتسكن وتعيش محل الطبقات العاملة ومحدودة الدخل. وهو مثل السياحة يعتبر شكلاً آخر من تحكم رأس المال في المدينة بهدف تسليعها، وخلق سردية للمدينة تتغذى على النوستالجيا عبر المطبوعات والكتب والخرائط وجولات السير الإرشادية لتخدم مصالح شركات الاستثمار العقاري، كما تعمل كعلامة تجارية تسوّق المدينة لجذب رؤوس أموال واستثمارات أكبر.
حيث إنه في كثير من الأحيان تتخذ الأحداث الضخمة والمؤتمرات الدولية الكبيرة وبدء الفعاليات الفنية والثقافية التي تحدث بشكل سنوي وإنشاء متاحف ومساحات ثقافية فنية معاصرة ومراكز دراسات وأبحاث عملاقة ودعاوى الحفاظ على تراث وذاكرة المدينة كمدخل وعامل مساعد مسرّع لعمليات “جنتريفيكاشن” موسعة وممنهجة.
هذا على سبيل المثال ما حدث في برشلونة منذ التسعينيات؛ بدأ “الجنتريفيكاشن” مع دورة الألعاب الأوليمبية في 1992 وازداد بكثافة بعد “المنتدى العالمي للثقافات” في 2004 لتجتاح المدينة موجات عنيفة من السياحة و“الجنتريفيكاشن” في كل مكان حتى الجبال. في ديسمبر 2008، ألقى الجغرافي الأمريكي الماركسي “نيل سميث” ( 1954 – 2012) محاضرة بعنوان (عن “الجنتريفيكاشن“.. هل المتاحف مجرد وكلاء عن رأس المال العقاري؟!) في متحف الفنون المعاصرة في برشلونة “الماكبا“؛ هذا المتحف مع مركز الثقافة المعاصرة في برشلونة يعتبران المدخل الرئيسي لعملية “الجنتريفيكاشن” التي اجتاحت منطقة “ال رافال” بعد إنشاء المتحف والمركز في منتصف تسعينيات القرن الماضي. و“ال رافال” تاريخيًّا منطقة للطبقة العاملة، ثم أصبحت مكانًا لحياة الليل وعاملات الجنس والمهاجرين القادمين من الجنوب من أمريكا اللاتينية وباكستان والفلبين وبالتالي كانت مكانًا للجريمة والصراع مع الشرطة.
يقول نيل سميث إنه بعد بناء “الماكبا” والمركز انتقل كثير من جاليريهات الفن والكافيهات والمطاعم وافتتحت الفنادق فروعًا لها في “ال رافال” وأتى الفنانون للعيش هناك مما أدى إلى زيادة الأسعار والإيجارات واستقر “الجنتريفيكاشن” هناك. يشدد سميث على أن “الجنتريفيكاشن” ليس فقط مسالة أخلاقية ( على أهميتها)، ربما لأنه لا يريد أن تُؤوَّل محاضرته عن “الجنتريفيكاشن” في (الماكبا أحد معاقل الجنتريفيكاشن فى برشلونة) تأويلاً أخلاقيًّا. فالجنتريفيكاشن، بالنسبة له، بالأساس مسألة اقتصادية سياسية، ويمكن أن نضيف بناءً على ذلك، أنه مسألة جمالية أيضًا فيما يخص الممارسات الفنية والثقافية التي تمثله والتي تسبغ عليه شرعية ما يفتقر إليها.
ينتقد سميث أن يتم التعامل مع “الجنتريفيكاشن” تلبية لنزعة استهلاكية عند الناس وفقًا لمنطق الاقتصاد الكلاسيكي، كما يرفض طريقة إلقاء اللوم وإثارة الإحساس بالذنب التطهرية. لأنه من الصعب مثلاً أن نلقي اللوم على سيدة في مصر مثلا تستخدم الأوبر طلبًا للأمان وبعض الخصوصية وخوفًا من التحرش، أو نلوم فتاة تريد أن تعيش بمفردها بالقرب من عملها فى منطقة بها الحد الأدنى من الأمان والخدمات الجيدة والحريات الأساسية والخصوصية. كذلك ينتقد سميث منطق المعماريين والمطورين العمرانيين النيو ليبراليين الذي يرى في “الجنتريفكاشن” التطور والتقدم العمراني الطبيعي الذي يتبنى تصورًا خطيًّا ودارونيًّا اجتماعيًّا للتاريخ؛ بحيث يعيش ويعمل الأغنى وبالتالي الأذكى والأنجح في الأماكن الأعرق والأكثر تميزًا والأقرب لأعمالهم وممتلكاتهم.
يرى سميث أن “الجنتريفيكاشن” يعمل بشكل نظامي ومنهجي في المدن الكبيرة المختلفة في كثير من دول العالم؛ من برلين وبرشلونة إلى القاهرة والإسكندرية، يفرض نفسه علينا بشكل يبدو كأنه لا فكاك منه عن طريق تواطؤ وانسحاب الدولة من تطوير نظام إيجارات مناسب وتضافر الجهود والتعاونات بين شركات الاستثمار العقاري وأنظمة الإقراض في البنوك المختلفة، بالإضافة إلى ضخ كثير من الاستثمارات في اقتصاد ريادة الأعمال والذي يحتاج إلى( فضاءات عمل تشاركية coworking spaces) كبيرة لتحوي الكثير من مكاتب الشركات الناشئة في مواقع متميزة.
شبكة المصالح التكاملية تلك هي التي تجعل مشاريع “الجنتريفيكاشن” تتغلغل في أوصال المدينة وتجعلها أكثر تعقيدًا وجدلاً، فهي التي تنظم المؤتمرات البحثية والمهرجانات الفنية وتبني الفنادق وعمارات سكنية بتسهيلات بنكية والمتاحف والحدائق وأماكن التسوق والترفيه والمراكز الثقافية والبحثية واستوديوهات الفنانين على حد سواء.

،ممر كوداك، وسط البلد، القاهرة
ديسمبر 2017
تصوير: مادو/ المصدر: تويتر
تتميز برشلونة بالمساحات العامة بـ “ال راملا” التي توجد في معظم مناطق المدينة، يخلقها أحيانًا “الجنتريفيكاشن“، مثلاً “ال راملا دو دارفال” الساحة العامة في ال رافال، فضاء قام “الجنتريفيكاشن” بخلقه في أثناء إعادة تخطيط “ال رافال” على أنقاض وبدلاً عن أماكن سكن للطبقة العاملة ليكون فضاءً للاستهلاك؛ للكافيهات والمطاعم وزبائنهم من السياح. على عكس الإسكندرية، المدينة الخطية التي لا يوجد فيها من المساحات العامة إلا القليل.
المساحات العامة ليست فقط فضاءات للاستهلاك لكنها يمكن أيضًا أن تكون فضاءات لالتقاط الأنفاس عندما يتوقف الناس في المدينة، فرادى أو جماعات، ولو قليلاً عن الدوران في عجلة الإنتاج والاستهلاك، ليرتاحوا ويأكلوا ويشربوا ويغنوا ويرقصوا ويتناقشوا ويبنوا مساحة تشاركية. حينها، وكما تقول مارينا جرسياس الفيلسوفة والكاتبة والناشطة الكتالونية، تعمل المساحات العامة كرئة ومساحة للتنفس في جسد المدينة التي تبدو كالسجن. وحينها أيضًا، تتخذ السلطات والطبقات المهيمنة موقف الريبة والشك من هؤلاء المتوقفين عن “الدوران” في الساحات العامة.
تطرح مارينا جرسياس فكرة المساحات التشاركية ربما كمحاولة لإرباك وإزعاج أشكال سيطرة وتحكم رأس المال مثل “الجنتريفيكاشن” وغيره على المدينة وعلى حياتنا بدلاً عن انتظار الأزمات المالية البنكية!
حيث إننا نعيش في عالم تبدو فيه هذه الأشكال من السيطرة والتحكم شديدة الوضوح و“البجاحة” في ظلمها وقمعها لا تحتاج إلى تبيين وشرح ونقد وتوعية وتنوير الجمهور بطبيعتها ومخاطرها لأنه يعيش تحت وطأتها بالفعل.
لكن ما نحتاجه كـ (فنانين ومثقفين وكتاب وناشطين وباحثين وأكاديميين حتى ولو مضطرين للجنتريفيكاشن) هو بناء وخلق مساحة تشاركية، نتخلى فيها عن أنانيتنا لنبنى “نحن” وليس “أنا” أو “هم” ليتجسد فيها ذلك النقد في مساحة تشاركية (لقاءات) غير هرمية ولا سلطوية، مساحة تقوم على المساواة، يمكن أن تكون في مساحة عامة أو مقهى أو مساحة فنية ثقافية صغيرة مع فئات أخرى مختلفة ومتنوعة متضررة من “الجنتريفيكاشن” مثل محدودي الدخل والعمال والعاملات والطلبة واللاجئين والمهاجرين، أو من أشكال السيطرة الأخرى لبحث ومناقشة ما يواجهنا من مشكلات وأسئلة وكيف نتعامل معها. مثل تجربة مشروع “اسباي إن بلانك” (فضاء فارغ) الذي كان ناشطًا في الفترة من 2002 إلى 2006 ونتج عنه تقرير تم توزيعه وتحميله من على الإنترنت آلاف المرات ضمن حملة لفضح الحدث الدولي الكبير “المنتدى العالمي للثقافات” عام 2004 الذي غير وجه برشلونة، كذلك نتج عنه فيلم وسلسلة لقاءات شهرية، يعلن عنها عبر ملصقات، يجتمع فيها المهتمون بشكل متساوٍ غير هرمي لمناقشة مشكلة ما، انطلاقًا من فكرة أن حياتنا مشكلة مشتركة، ومحاولة ضد “خصخصة وجودنا“.