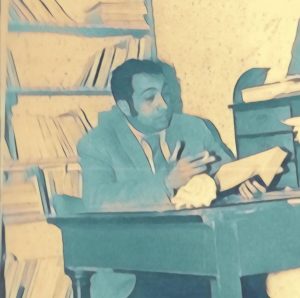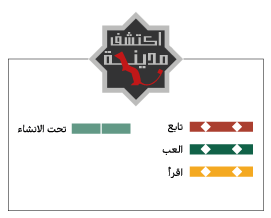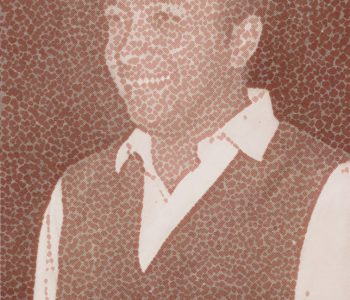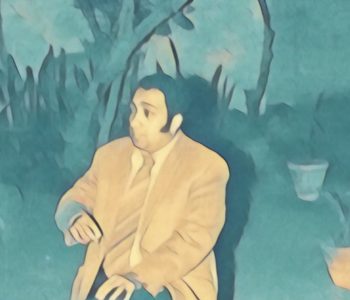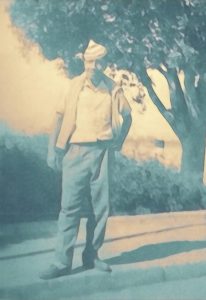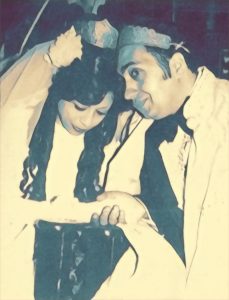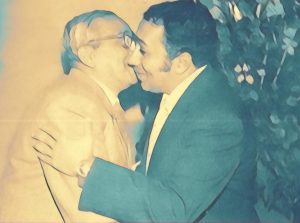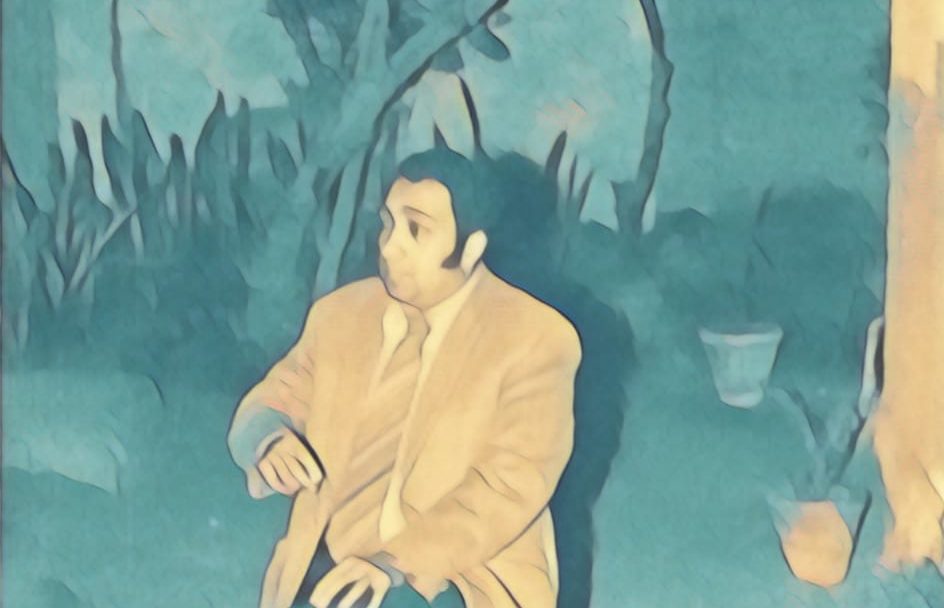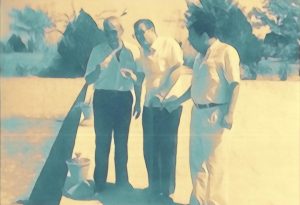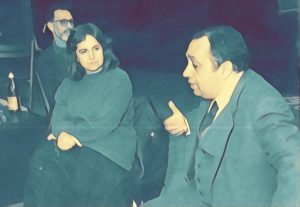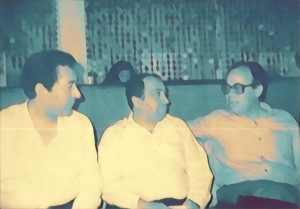– بدأت كتابة النقد السينمائي خارج الصحافة، أي لم تكن مرتبطًا بصحيفة..
وحتى الآن
– أعرف، لكن كيف كنت ترى كتابة النقد بعيدا عن الالتزام تجاه صحيفة معينة؟
أراه ضرورة وليس اختيارًا؛ لأنه لم يكن أمامي ولا أمام جيلي كله فرصة للالتحاق بمؤسسة صحفية، مجالات الصحافة كانت ضيقة، وعدد من يكتبون من الخارج قليل.
– من الذين تعتبرهم جيلك؟
مساحة واسعة من الكتاب، روائيين مثل إبراهيم أصلان، وبعضهم أصغر مني بسنتين أو ثلاثة مثل عبد الرحمن أبو عوف وحسن عطية.
– كنت أتكلم عن جيلك في السينما؟ أو بالتحديد في النقد السينمائي؟
قبلي بسنوات قليلة فتحي فرج، علي أبو شادي، سمير فريد طبعًا، لكن سمير استطاع أن يجد مكانًا في الصحافة بطريقة أسرع ربما أكثر سلاسة، طبعًا سبقنا بعدة سنوات صبحي شفيق، أنا وسامي السلاموني بدأنا في نفس الفترة، بدايتنا كانت واحدة. أنا الذي تأخرت لعدة سنوات عندما عملت في المنصورة، يعني بدأت مع عدد لا يستهان به من الكتّاب لكنني تعطلت طوال سنوات المنصورة. وعدت مرة أخرى. ربما تكون خيرية البشلاوي أيضًا من نفس الجيل.
– متى شعرت أنك ناقد سينما؟
حتى الآن لم أشعر.
– متى اتخذت قرارًا بأنك ستركز في كتابة النقد على السينما؟
الحقيقة لم يكن الاختيار حرًا مائة بالمئة، طلب المقالات هو الذي حدد الاختيارات، مقالات السينما كانت هي المتاحة أو هي التي كانت لها مساحة على الخريطة شاغرة.
– سمير فريد قال لي إنه قبل جيلك لم يكن هناك نقد سينمائي بالمعنى الدقيق. هل أنت معه في هذا الرأي؟
من الصعب أن تقول إن ما يُكتب وقتها هو نقد سينمائي بالمعنى الدقيق. هي انطباعات ذكية يكتبها أحمد بهاء الدين وأخرى لأحمد حمروش وأيضًا سعد نديم وعدد لا يُستهان به من الكتّاب لم يكن أيا منهم ناقدًا سينمائيًّا بالمعنى الموجود الآن. كان موجودا وقتها وحتى الآن المحرر الفني، وأحيانًا كان يُطلق عليه اسم يزعجنا هو الناقد الفني. ماذا تعني هذه الكلمة؟ أنه الشخص الذي يُجري حوارا مع ممثلة ويكتب أخبارها، أو يكتب تعليقًا ظريفًا، كان هذا هو المجال المفتوح للكتابة عن السينما وقتها. ولهذا فأغلب نقاد جيلي قادمين من النقد الأدبي، بعضهم استمر وبعضهم توقف، آخرون توجهوا إلى السلك الأكاديمي، مثل الدكتور أحمد السعدني أستاذ الأدب العربي بجامعة المنيا.
– وأنت بدأت ناقدًا أدبيًّا.
فعلاً. كتبت مقالاً في مجلة تصدر من بيروت وأسمها (العلوم) عن الديوان الأول للشاعر محمد إبراهيم أبو سنة، كتبت أيضًا عن المجموعة الأولى لبهاء طاهر اسمها (المظاهرة).
– تقصد مجموعة الخطوبة؟
آه فعلاً.. المظاهرة اسم قصة في المجموعة، المهم أنني وقتها كنت أعد نفسي ناقدًا أدبيًّا، وأيضًا في المسرح، في مجلة اسمها (الرواد) تصدر من ليبيا، لكن مساحة النشر كانت أكبر في السينما.
– اختيار براجماتي؟
لا تستطيع أن تقول براجماتي، لأن عشقي الأساسي أو الجوهري كان السينما، لكن تقدر أن تقول بأن النقد السينمائي هو الذي اختارني.
– كيف؟
سأدقق العبارة: على قدر اختياري للنقد السينمائي، فإن النقد السينمائي هو الذي اختارني؛ لأن متعة مشاهدة الفيلم والإحساس به وتحليله فيها نوع من العشق.
– وقت الاختيار كنت تشعر بأنك في مجموعة سينمائية؟
لا.. أبدًا.
– ولا في المجموعات الحالمة بسينما مختلفة مثل (جماعة السينما الجديدة)؟
كنت أرى بعضهم في التجمعات الأدبية، مثلاً أول مرة ألتقي رأفت الميهي كان عند عبد الرحمن الخميسي، شاب متحمس ومخيف، يرتدي نظارة طبية، نموذج للمثقف المصري لكن ملامحه تقترب من المثقفين الفرنسيين كما تعرفنا عليهم في الروايات التي قرأناها. وما زلت أتذكر حوار تلك الليلة، رأفت قال يومها جملة حلوة جدًا وهو يشكو من الجيل القديم، قال: هم يعتقدون أن الإخراج السينمائي كهنوت رغم أنني أراه مثلاً أبسط بكثير.
– كانت علاقة عن بُعد؟
عندما رجعت بعد سنوات المنصورة تعرفت عليهم أكثر، لكن هذه المرة بالفعل كانت المعرفة من الخارج، وأذكر بشيء من التقدير فاروق عبد القادر الذي كان يشرف على ملحق الطليعة في سنة 1971 على ما أظن، قابلته على مقهى ريش، وقال لي أكتب لنا. فسألته عن الموضوعات التي أحب أن أكتب فيها، قال لي: أكتب ما تريد.. كانت أيامها قمة انتشار موجة أفلام اليسار الإيطالي.
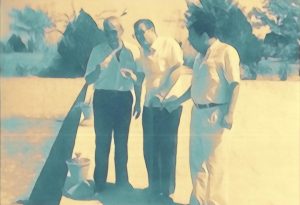
كمال رمزي مع حسين وفاروق عبد القادر
– هل تقصد أفلام الواقعية الجديدة في إيطاليا؟
لا هي أفلام متجاوزة الواقعية الجديدة بمراحل، وقتها أيضًا ظهرت مدرسة نيويورك الواقعية أيضًا. ونشرتُ أول مقال في الطليعة كانت ملاحظات على سينما جديدة، المقال الثاني كان عن حصاد السنة كاملة ثم توالت مقالاتي في الطليعة، وعرفت أن سمير فريد جاء إلى الطليعة وقال أريد مقابلة كمال رمزي.
– هذا أول اعتراف من جماعة النقاد بك؟
انزعجت في البداية أنني كنت أُعامل كمبتدئ، ووافد، لكن مقالات الطليعة صنعت لي مكانًا خارج الأطر والمجموعات، وبالتالي عندما اقتربت من هذه المجموعات، كان اسمي معروفًا ولم أعد شخصًا وافدًا من الخارج، وحدث نوع من القبول الحسن لي، ولا أريد أن أقول الاحتفاء (يضحك) وقتها انضممت إلى جمعية النقاد المصريين.
– احكِ لي عن اللقاء مع سمير فريد؟
سمير قال لفاروق عبد القادر أريد أن أراه ضروري وينضم لنا، كنت أعرفه جيدًا لأنه يسبقني بعدة سنوات في المعهد وكنت أقرأ له بانتظام، وبدأ اللقاء بيننا كأنه صداقة قديمة أو استمرار لصداقة قديمة. وفي جمعية النقاد تعرفت على هاشم النحاس وأحمد راشد وسامي السلاموني، ومباشرة بدأت أقدم أفلامًا في نشرة نادي السينما، وأصبحت أمين صندوق جمعية النقاد بعدها بسنوات، وبدأت تُطلب مني مقالات في السينما، ساعتها اكتشفت أنني أدخل عالم السينما الرحب جدًا، وهو فعلاً رحب جدًا، وأصبحت السينما منطقة تحتاج إلى ضعف جهدك، واستعنت بالقراءات الأدبية في الاقتراب من الأفلام التي أكتب عنها.
– كيف؟
قرأت بعض الكتب في مجالات غير السينما وعشقتها لأنها أعطتني مفاتيح لفهم الأفلام، وفي مقدمتهم كتاب مثل (شعراء المدرسة الحديثة) لروزنتال الذي ترجمته على ما أظن سلمى خضراء الجيوسي، كتاب ممتع يحلل اللقطة داخل قصيدة الشعر عند إزرا باوند وإليوت وييتس، وحتى هذه اللحظة أشعر وأنا اقرأ هذا الكتاب أشعر بأنني أقرأ نقد سينما في أفضل مستوياته.
– اشرح لي قليلاً وجهة النظر هذه..
الكتاب يرى ويحلل تكوين اللوحة التي رسمها الشاعر، ويفسر جزئياتها ويهتم بالتفاصيل الصغيرة في القصيدة.
– ربما يكون إعجابك بطريقة كتاب أدبي في النقد هو سر الحمولة الأدبية الموجودة في مقالاتك عن السينما، وأيضًا في نظرتك إلى الفيلم نفسه والتعامل مع الفيلم على أنه نص.. يشبه النص الأدبي؟
ربما.. لا أستطيع تقييم نفسي، ولا أن أحلل ماذا أفعل أو فعلت، وحتى الآن لم أتوقف لحظة لأفكر هل أنا لدي مشروع أم لا، أو أن أتكلم عن مصادر ثقافتي، في النقطة الأولى أعتقد أن المشروع يتكون في أثناء الشغل، ولا يكتمل إلا عندما ينتهي المشوار.
– أعتقد أن فكرة المشروع مرتبطة أساسا بمفهوم أكبر يرى أنه تابع لمؤسستين كبيرتين هما الأيديولوجيا والسياسة، وأصحاب المشاريع -في ذلك الوقت- يدورون في مدار هذه المفاهيم بشكل أو بآخر.
بهذا المعنى، أنا لا علاقة لي بالمشاريع.
– لكنك بدأت في عز زهوة هذه المشاريع.
لم يكن في ذهني أن ترتبط كتاباتي بشيء أكثر من ارتباطها بأفكاري.
– لم أفهم!
لو دخلت فيلمًا من الذي يُطلق عليه فيلم سياسي، وخرجت منه وأنت تشعر بالخوف يكون هذا ضد قدرة الإنسان على تغيير مصيره، وعلى العكس إذا دخلت فيلمًا وخرجت أقوى وتشعر أنه لا بد أن يكون لك موقف من

كمال رمزي مع عطيات الأبنودي في ألمانيا 1988
الحياة، أنا مع هذا الفيلم. كانت أيامها مناقشات طويلة حول موجات أفلام السياسة أو للاتجاهات السياسية المتضاربة في الأفلام، بينها فيلم لا أتذكر اسمه الآن لعمر الشريف، يحكي قصة شخص يُعتقل 7 سنين وحبيبته تظل تنتظره، يقاوم في بداية المعتقل، لكنه يستسلم فيما بعد، ويخرج فلا يعرف حبيبته، كان الفيلم قويًّا لكن كان فيه حاجة مش مضبوطة، تجعلك لا تتقبل الفيلم، في نفس الفترة كانت هناك أفلام تنتهي بمصرع المناضل لكن الفيلم قوي، هنا وصلنا وبعد مناقشات طويلة أن الفيلم الذي يُخرجك من قاعة العرض وأنت قوي بعض النظر عما تم على الشاشة، هذا هو المعيار، أقصد المعيار الذي أقيس به، يعني فيلم مثل (إحنا بتوع الأتوبيس) هو نموذج يحذرك من أي اشتراك في السياسة أو أي محاولة لتغيير مصيرك، فيلم لا يمنحك أي مساحة لكي تكون قويًّا، أو يمنحك إحساسا بقدرتك على الصمود.
– المعيار الذي تتحدث عنه غامض!
ما الغموض الذي تقصده؟
– لأنه ليس معيارًا موضوعيًّا، حتى بالنسبة لمفهومك عن الخروج من السينما بقوة ما!
بمعنى؟
– بعض المتفرجين سيخرجون من (إحنا بتوع الأتوبيس) بأحاسيس ساخطة، والسخط جزء من القوة.
لا أعتقد.
– أكلمك عن فكرة التأثير على المشاهد، وهي فكرة نسبية للغاية.
عمومًا الاستقبال مختلف من شخص لآخر، وإنما يوجد تقريبًا مساحة عامة مؤثرة على الجميع، يعني ربما لن يخرج المتفرج ساخطًا، بل مرعوبًا أكثر منه ساخطًا، وعمومًا مسألة السخط تحتاج مراجعة، ساخط على إيه ومن أجل إيه!
– سأعيد سؤالاً مررت أنت عليه بذكاء. أريد أن أعرف موقفك من فكرة التعامل مع السينما على أنها وعاء تابع للأيديولوجيا والسياسة أم أنك لم تكن واعيًا بهذه الإشكالية؟ وربما لم يكن لديك موقف منها وقتها، أو ما زلت ترى أنه موقف صحيح؟
بالتأكيد أي فيلم يحتوي، لا أقول على بُعد سياسي بالمعنى الضيق، لكن بُعد أوسع من مسألة السياسة.. مثلاً في أفلام المدرسة الطبيعية مثل: رنة الخلخال لـمحمود ذو الفقار، وامرأة على الطريق، كانت هناك موجة من الأفلام الطبيعية وقتها، وكان يهمني جانب إيجابي فيها وهو الاعتراف بالغرائز، ليس الإعلاء من شأنها، لكنه الاعتراف بالجسد كقوة وكقيمة من الممكن أن تكون قوة بناءة أو مدمرة. هذه موجودة في المدرسة الطبيعية، هنا لا توجد سياسة بالمعنى المباشر لكن بُعد فكري، في النهاية يمكن أن يصب في طاحونة السياسة، لكن ليست السياسة بشكل مباشر.
– لكن الغالب الأعم على كتابتك النقدية-أنت ومعظم جيلك- هو الطابع السياسي.
ممكن.. وسأقول تفسيرًا لا تبريرًا، في بداياتنا كان الجميع مهتم بالسياسة، الآن قطاعات قليلة هي التي تهتم بالسياسة، أيامنا حازت القضية الوطنية اهتمام كل الشباب، ولكن الآن الديموقراطية هي القضية المهمة، ولم يعد العدو الخارجي في خطورة الخصوم الداخليين. أيامنا كان هناك نوع من أنواع التسامح مع النظام الناصري؛ لأنه قدم أشياء للناس. وليس أمامنا إلا العدو الخارجي، والعدو الخارجي قوة باطشة، وهو ما جعلنا جميعا نشتغل بالسياسة بشكل ما.
– تشتغلون بالسياسة أم تعيشون بإحساس أنكم على خط النار؟
وهل هناك فرق؟
– فرق كبير.
لا أعتقد.. لأن السياسة تبدأ من مناقشة بين اثنين. وذروتها عدو يطرق الأبواب، وعندما يحدث هذا فإن السياسة تطغى على كل شيء.
– وهل ما زال العدو يطرق الأبواب؟
الآن، في اللحظة التي نتكلم فيها، بالتأكيد، ما زال، لكنه في الحقيقة لا يطرق الأبواب، يتسلل من تحتها.
– أتكلم عن السينما
لا يمكن أن نتكلم عن السينما كإنتاج موحد مثل إنتاج الصابون مثلاً أو المعلبات؛ لأن السينما مليئة بالاتجاهات، كل مخرج له اتجاه، بل إن كل مخرج له اتجاهات متعددة، وبالنسبة للسينما كان هناك باستمرار اتجاهين، ما نسميه الاتجاه الجاد أو النقدي والاتجاه الترويحي، وطبعًا الفصل الحاسم بين الاثنين ليس دقيقًا، إنما نجد حسين كمال يقدم فيلم (البوسطجي) و(شيء من الخوف)، ثم يقدم بعدها (أبي فوق الشجرة) وينجح نجاحًا مهولاً، فنحن نفرق بين حسين كمال هنا، وحسين كمال هنا.
– تفرقة أم إدانة؟
لا ليست إدانة، صحيح زمان كانت الإدانة موجودة لكن الآن.. لا.
– لكن عند عرض (أبي فوق الشجرة) كانت هناك إدانة.
طبعًا.
– لهذا قلت لك أنكم كنتم تشعرون أنكم على خط النار.
بمعنى؟
– الإحساس الغالب وقتها أن السينما لها دور وهو تثوير الجماهير.
ممكن.. عمومًا النقطة التي تتحدث عنها كانت هي الطاقة الغالبة على كل الكتابات بما فيها الكتابات النقدية في الأدب.. والفن.
– وكتابتك أنت؟
لا أعرف.
– أليس لديك نقد لكتابتك القديمة، لا أتحدث عن تقييم، هل أعليت من قيمة فيلم وخسفت بآخر طبقًا لموضة البحث عن الثورة في الأفلام؟
لا أعتقد.. هناك ربما أفلام ترددت في الكتابة عنها لم أكن أتقبلها عقليًّا، رغم تجاوبي معها.
– مثلاً؟
أتذكر فيلم (خلي بالك من زوزو) عُرض في فترة حرب، عدد منا هاجمه، لم أكتب عنه لأنني شعرت بأنني متناقض، بالمعايير الفكرية الصارمة لست مع الفيلم، وعلى النقيض أحببته، وأحببت الأشياء الجميلة فيه، والحقيقة أن بعض الكتَّاب الأجانب كتبوا عن الفيلم كلامًا من الناحية الفكرية والسياسية ناضجًا جدًا، من نوع أنه ينتصر للحاضر ضد الماضي، وللمستقبل ضد الحاضر والماضي، وأنه فيلم يؤكد قدرة الإنسان على صنع مصيره ويدعم شجاعة الإعلان عن الوضع الوظيفي أو الطبقي للإنسان، وأنه فيلم مؤمن بالعلم، فبطلة الفيلم (زوزو) غيرت بالعلم واقعها كله، وهذه قيم إيجابية موجودة بالفيلم، لكن صوت السياسة كان عاليًا في المجتمع بسبب ما أثرته عن الوقوف على خط النار، وهو ليس تعبيرًا مجازيًا هنا، بل هو تعبير دقيق؛ لأن العدو كان على الضفة الأخرى من قناة السويس تلاحقنا مفاجآت وغارات وضرب أطفال بحر البقر وعمال أبو زعبل، أخبار عن سرقة العدو لرادار من العين السخنة، وأخبار أخرى عن المعارك الشديدة في جزيرة شدوان.
– وما علاقة السينما بكل هذا؟ أقصد كيف كنت تراها؟
هي ليست علاقة السينما بشكل مباشر، ولكن علاقتها بالشخص الذي يستهلك السينما، كنت أريده أن يرى صورة مما يحدث في الواقع على شاشة السينما.
– لماذا؟
لأنه عندما تدخل صالة العرض وفي ذهنك حرب في الخارج، ثم تشاهد فيلمًا يقدم مشكلات بعيدة تمامًا عن الحرب، ستبحث أنت عن أشياء أخرى.
– هل هذا ما فعلته الواقعية الإيطالية؟
الواقعية الإيطالية بدأت بعدما انتهت الحرب، وفعلت هذا وعكست أوضاع السينما بشكل ما.
– لكنها كانت تيارًا في السينما؟
نعم.
– وليس كل السينما؟
كان هذا هو الاتجاه الغالب في إيطاليا.. كانت هذه هي السينما التي يتوجه إليها كل الناس.
– مَن كان وقتها يعجبك في السينما؟
صلاح أبو سيف.. أنا من عشاق صلاح أبو سيف.
– فقط؟
عز الدين ذو الفقار أيضًا، كما كان هناك رهان على السينمائيين الجدد، مثل رأفت الميهي حينما كتب سيناريو (غروب وشروق) وكان مفاجأة. وغالب شعث مخرج (ظلال على الجانب الآخر) وهو فيلم تعرض لمجزرة من قِبل السلطة على يد يوسف السباعي، في هذه الفترة كنت تجد أجزاءً من أفلام مضيئة وأخرى متواضعة، والحقيقة أنه من ضمن الأشياء المدهشة أنه كان هناك تلاحق سريع للأحداث، كانت عين على الواقع وعين على السينما، بينما يتغير الواقع بشكل أسرع وأسخن من السينما.
– هذا شيء طبيعي؟
لا ليس طبيعيًّا لأنها فترة حرب، جاءت 73 وبعدها بخمس سنوات مبادرة السادات ثم تظاهرات واعتقالات.. حدوتة غريبة جدًا. ثم مقتل السادات، لكن في الربع قرن الأخير كان هناك ما يسميه البعض سلام أو سكون، لكنها فترة خالية من أحداث كبرى، البعض يسمي هذا استقرارًا وفي المقابل يعتبره آخرون تعفنًا، لكن في الفترة السابقة عليها هناك فوران بالأحداث، تبحث عن انعكاسات هذا الفوران على الشاشة ولا تستطيع أن ترصد استجابتها بشكل كبير.
– هل توقفت علاقتك بجماعة السينما الجديدة عند حدود اللقاء الأول مع رأفت الميهي؟
جماعة السينما الجديدة كان فيها نفحة حداثة (يصمت ثوان قليلة ويكرر) نفحة حداثة (ويواصل) هذه النفحة موجودة في النقاد أو في السينمائيين التسجيليين، وهذه نقطة مهمة لأن وجود الجماعة تزامن مع نهوض السينما التسجيلية في هذه الفترة، حدث هذا بأعمال صلاح إلهامي وسعد نديم وعبد القادر التلمساني، بعدهم جاءت الموجة الثانية، وبالتحديد عبر اثنين: هاشم النحاس وعطيات الأبنودي، كل منهما قدم فيلمًا فتح سكة في السينما التسجيلية، حيث اختفى صوت المعلق من خارج الكادر، واختفت أيضًا صور الرؤساء والوزراء وظهر رجل الشارع، ليحكي عن مشكلاته، ويتكلم وكان هذا تطورًا مهمًا جدًا في السينما التسجيلية.
والملاحظة المهمة هنا أن عددًا من المخرجين الذين لمعوا في السينما الروائية هم أبناء السينما التسجيلية؛ من بينهم خيري بشارة وداود عبد السيد، وطبعًا لن ننسى الإشارة إلى فيلم من أهم أفلام السينما التسجيلية أخرجه أحمد راشد واسمه (أبطال من مصر)، فيلم قوي ومؤثر بشكل كبير، باختصار موجة السينما التسجيلية عقب حرب 1973 موجة مهمة جدًا، طبعًا في نفس الفترة كانت هناك أفلام أقرب إلى النبوءة.
– مثل؟
عودة الابن الضال.
– لم تذكر اسم يوسف شاهين عندما سألتك عن المخرجين الذين تحبهم؟
يمكن أن أضيفه، تعرف أن ذهني ليس حاضرًا، كما أنني أضع صلاح أبو سيف نمرة واحد. والفرق بينه وبين نمرة اثنين مسافة كبيرة إلى حد ما، لكنني أحب يوسف شاهين، وهناك مشكلة في هذا الموضوع وهي أنني لا أحب للمخرج كل أفلامه، فمثلاً حتى الآن أرى أن أجمل أفلام توفيق صالح هو (درب المهابيل)، أفلامه الأخرى مهمة، وأنا أحبها، لكن هذا الفيلم هو أجملهم. وكذلك بالنسبة ليوسف شاهين أفلامه مهمة وخصوصًا الأبيض والأسود، أحبها جدًا، وعلى رأسها (باب الحديد)، لكن يوسف باغتنا بفيلم عظيم الشأن هو (عودة الابن الضال)، فيلم مدهش ينتهي بمجزرة للعائلة بالكامل، وبعد عدة شهور تندلع تظاهرات من أسوان حتى مرسى مطروح تلك التي اسماها السادات “انتفاضة الحرامية”.
– تريد أن تقول إن (عودة الابن الضال) حمل نبوءة سياسية؟
بالطبع.. وليس وحده في هذه الفترة كان هناك فيلم رأفت الميهي (عيون لا تنام) حيث رب العائلة المسيطر على كل شيء، ويرى أنه الألف والياء ثم ينتهي الفيلم بضربة واحدة تقتل رب العائلة، والعجيب أن الفيلم عُرض يوم الاثنين، بعدها بأيام قُتل السادات. الفيلم الثالث في أفلام النبوءات هو (البريء) لعاطف الطيب، الذي يحكي عن ثورة جندي أمن مركزي على تعليمات ضابطه بتعذيب المعتقلين السياسيين، وللمرة الأولى في تاريخ السينما يشاهد الفيلم لجنة مكونة من 3 وزراء مهمين جدًا: الدفاع والداخلية والثقافة، ليقرروا عرض الفيلم من عدمه، والعجيب أنه بينما تشاهد اللجنة الفيلم كان جنود الأمن المركزي تحتل منطقة الهرم كلها.. في أحداث الاحتجاج الشهيرة على أوضاع الجنود.
– كيف تفسر فكرة سينما النبوءة السياسية تلك؟ هل هي النظرية القديمة التي ترى أن يكون الفن انعكاسًا للواقع؟
المخرج يحاول أن يكون له عين على الواقع وعين على الشاشة، هو انعكاس ولكنه انعكاس إيجابي، في الأفلام إحساس قوي بما يعتمل في قلب الواقع ورصده وتقييمه وتقديمه، ربما أرى نفسي أقرب للواقعية، والواقعية تعني عندي إدراك الأسباب المسببة للظاهرة وليس مجرد تسجيل الظاهرة أو إلغائها وتزييفها.
– في هذه الفترة كيف شاهدت فيلم مثل (زوجتي والكلب) إخراج سعيد مرزوق؟

كمال رمزي في حديث إذاعي 1978؛ويبدو في أقصى يمين الصورة المخرج سعيد مرزوق
تجربة شكلية تمامًا، ومفيدة في مسألة التجربة.. إنما لم أر أنه فيلم عظيم، وتأكد لديَّ هذا في الفيلم الثاني لسعيد مرزوق (الخوف)، ويحكي قصة بنت مهاجرة من السويس-أيام الحرب- وولد يحبها يصعدان إلى سطوح عمارة، ويهجم عليهما البواب والولد يدافع عنها، شعرت بأن منطقة الخوف في الفيلم منطقة أوسع وكبيرة جدًا مما كانت عليه في الواقع، كما أن العدو الذي قدمه لا علاقة به شيء تمامًا.
– ماذا تعني بتجربة في الشكل؟ أليست السينما تجربة في الشكل؟ أي كيف تقدم حكاية بتقنيات السينما، تجرب في أدواتها لكي تصنع من حكاية مشاهد مصورة؟ هل ما زال هناك فرق بين الشكل والمضمون؟
نعم ما زال هناك فرق بين الشكل والمضمون وفي السينما بالتحديد؛ لأنها تقدم أفلامًا يمكن أن تعطي لك شكلاً دون مضمون أو شكلاً مبهرًا بمضمون سلبي، يعني ليس بالضرورة الفيلم المتميز جدًا الذي ترحب به يكون مصنوع بشكل جيد.
في السينما الأمريكية، هناك بعض الأفلام المصنوعة بمهارة شديدة، تكتشف أنها اليوم لم تعد تجربة مثيرة، كنا ننبهر زمان كيف تخترق الرصاصة جسد واحد من أعداء الجيش الأمريكي وتخرج من الناحية الأخرى، كنا مبهورين وقتها.
– هذه ليست تجربة في الشكل، بل إبهار في التكنيك..
وما الشكل الذي تقصده إذن؟
– الشكل هو طريقة بناء الفيلم.
سأقول لك.. المسافة بيننا ليست واسعة لكن السينما فيها هذا، وليس في مسألة البناء، ما أقصده يظهر تقريبًا في تجربة أفلام كلود ليلوش في مصر.
– ماذا حدث؟
عندما عُرضت أفلام ليلوش في مصر، حدث نوع من الانبهار، انبهار غير معقول، يمكن أن أحضر لك المقالات التي كُتبت عنه، أيامها كُتب بمنتهى الانبهار على مشهد كلب يجري على الشاطئ، يذهب ويعود، ومشاهد أخرى للبطل والبطلة وهما يسيران أمام تل من الجليد ثم يختفيان ويظهران من الناحية الأخرى، لمسات من هذا النوع دفعت بآراء عن تأثير تحول مصور إلى مخرج في تقديم أفلام مبهرة، وذلك حتى حضرت ندوة من الندوات وكان فيها جورج سادول؛ أشهر نقاد السينما في فرنسا، الذي قال إنه آن الأوان أن نكتشف أن هذا الشكل هو شكل مزيف، فالصو، يلمع لكن ليس كل ما يلمع ذهبًا، وفي الحقيقة هذا يجعلنا نرى مأساة أخرى في أفلام ليلوش، وهو أنه قدم المرتزقة الأوروبيين الذين كانوا يعملون في أفريقيا ضد أنظمة تخطو أولى خطوات الديموقراطية، يقدمهم كفرسان، وكتبت مقال عن سينما ليلوش واعتبرت أنها في عداء مع العالم الثالث، التجربة هنا شكلية، وغرضها مضمون بالغ البشاعة تجعلك تحب الناس المعادية للعالم الثالث.
– هل كل تجربة شكلية وراءها مؤامرة؟
لا.. لا، ليس بالضرورة من قال إن داود عبد السيد لا يجرب في الشكل وفي كتابة السيناريو، السيناريو عند داود يتكون من عدة مستويات، وفي تقديري هذا نوع من أنواع التجربة في الكتابة. فيلم مثل (مواطن ومخبر وحرامي) يمكن أن تراه على أكثر من مستوى، حتى أغنية شعبان عبد الرحيم يمكن التعامل معها على أكثر من مستوى، تصفق وتغني معها، ثم عندما تتأمل في معاني الكلمات، ستكتشف أنها مهمة جدًا، ليس بالضرورة التجربة في الشكل وراءها شيء سيء، التجربة هي محاولة لاستخدام عناصر اللغة بشكل يُبعدها عن التكرار.
– وهل هذا جيد أم رديء؟
مفيد.
– ما أوجه الفائدة؟
حتى لو كان للتجربة مضمون سيء، فإن التجربة تفيد لغة السينما، تطورها، وتغيرها، وتؤثر على تجارب أخرى.
– لكنك لم تعتبر هذا عنصرًا إيجابيًّا عند سعيد مرزوق!
لا.. أنا باستمرار أطلب الأكثر اكتمالاً ونضجًا، يعني عند سعيد مرزوق تجاربه وحتى فيلمه الأخير (المرأة والساطور) فيها لغة سينمائية ممتازة، ومنظر البحر ونتف قادمة مع الموج، تصنع جوًا مذهلاً.
– أليست هذه هي السينما؟
السينما أوسع مما أطلبه، نعم هذه هي السينما، أنا لا أصنع سينما، أنا أتفرج عليها، الناقد ليس صانع سينما، السينما موجودة قبله وستبقى بعده، كما أنها ليست اتجاهًا واحدًا، وفنان السينما لا يصنع فيلمًا من أجل الناقد، السينما أوسع بكثير، لكن عملك كناقد أن تحدد الأفضلية بين مستويات وأساليب السينما المختلفة، وسترى مثلاً رجلاً جميلاً مثل صلاح أبو سيف يصنع في فيلم (البداية) تجربة جديدة على مستوى الشكل، لكنها في النهاية تصب في واقعية صلاح أبو سيف.
– هل تعتبر أن الواقعية علامة الجودة في السينما؟
بالمعنى الذي شرحته وليس الواقعية التي تعني تصوير حارة وعجلاتي وبيوت قديمة وناس بتردح وتتخانق مع بعضها، ممكن الفيلم كله يدور في أجواء أرستقراطية ويكون واقعيًّا، الواقعية هي إدراك الأسباب المؤدية للظاهرة.
– كيف تنظر لأفلام فؤاد المهندس مثلاً؟
حسب المخرج، يعني معظم أفلامه مع فطين عبد الوهاب تتضمن إدراكًا عميقًا للواقع، والكثير من أفلام فؤاد المهندس تكاد تكون مسلية، ولكن له بعض الأفلام الجميلة جدًا مثل (أرض النفاق) أرى أنه فيلم واقعي، يقول إن واقع الناس لن ينصلح بعقاقير.
– باختصار أنت ترى أن السينما رسالة؟
نعم.
– ورسالة لإعطاء قوة إيجابية؟
نعم
– لكن أليس لها رسالة بمعنى آخر.. ألا توجد خصوصية للسينما، ما يمكن أن يُقال في السينما لماذا لا يُقال في مقال أو يُحكى في رواية؟ أعتقد أن هذا سؤال بديهي؟
أفترض أنه هناك فيلمًا لطيفًا، فيه ترويح فقط، بالطبع سأراه ظريفًا، وبعض أفلام فطين عبد الوهاب فيها هذا الترويح مثل (عفريت مراتي) فيلم لطيف.. أريد أن أقول لك أن هناك فرقًا بين قبولي لفيلم وتفضيلي لفيلم آخر، أقبل أنواع كثيرة، وفيلم رومانسي ممكن يكون لطيف وحلو ومسلي لكنها تسلية، في حدود عدم تضمنها قيم سلبية.
– تتعامل مع فكرة التسلية باحتقار نوعا ما!
سأقول لك على أحد الأخطاء، فيلم (بين الأطلال) أثَّر عليَّ تأثيرًا شديدًا جدًا، لكنني اليوم أراه بشكل مختلف، أرى أن الفيلم جعل الماضي أقوى من الحاضر والمستقبل، وأن البكاء بين الأطلال أفضل من الدخول للحياة، وأن الاستسلام للموتى أهم من الاستسلام للأحياء، رومانسية سلبية جدًا، وأنا لا احتقر الفيلم المسلي، لكنني لم أفضله مثل الفيلم القوي المشبع المقنع والمسلي في نفس الوقت، وفيه فكر.
– قلت لي إن من ضمن أفلامك المهمة فيلم (الآنسة حنفي).
فيلم جميل.. فيه مفاجأة اكتشاف أن الرجل بحكم تراث طويل فيه قدر كبير من الأنانية والغرور وإيثار الذات، وأن المرأة من الممكن أن تكون أقوى من الرجل ومتفتحة على الحياة أكثر منه، هذا فيلم بنَّاء ومسلي.. مسلي جدًا.
– لكن شخصًا آخر يمكن أن يرى العكس.. أو يراه مجرد فيلم عادي!
آه.. غالبا يحدث هذا لأنني أتعامل مع مستوى والآخرين مع مستوى آخر، لكن دائمًا ستجد أنه ليس أقل من 95% سيقبلون على الفيلم.
– أفهم من كدا إنك ابن الاجماع أو الأغلبية؟
لا.
– أين النقد هنا؟
النقد يشرح لماذا تحب الفيلم وتقدره.
– ممكن تعمل صدمة؟
وارد.
– وارد أم حدث؟
بالنسبة لي؟ لا أستطيع أن أجزم، أنا لا أعرف من قرأ المقالات التي كتبتها، أنا لا أعرف فعلاً.
– تواضع ولا قلق؟
إحساس حقيقي.
– هل كان من الممكن تعمل في شيء آخر غير النقد؟
كان ممكن أشتغل جنايني.
– لماذا؟
لأني أحب الجنينة.