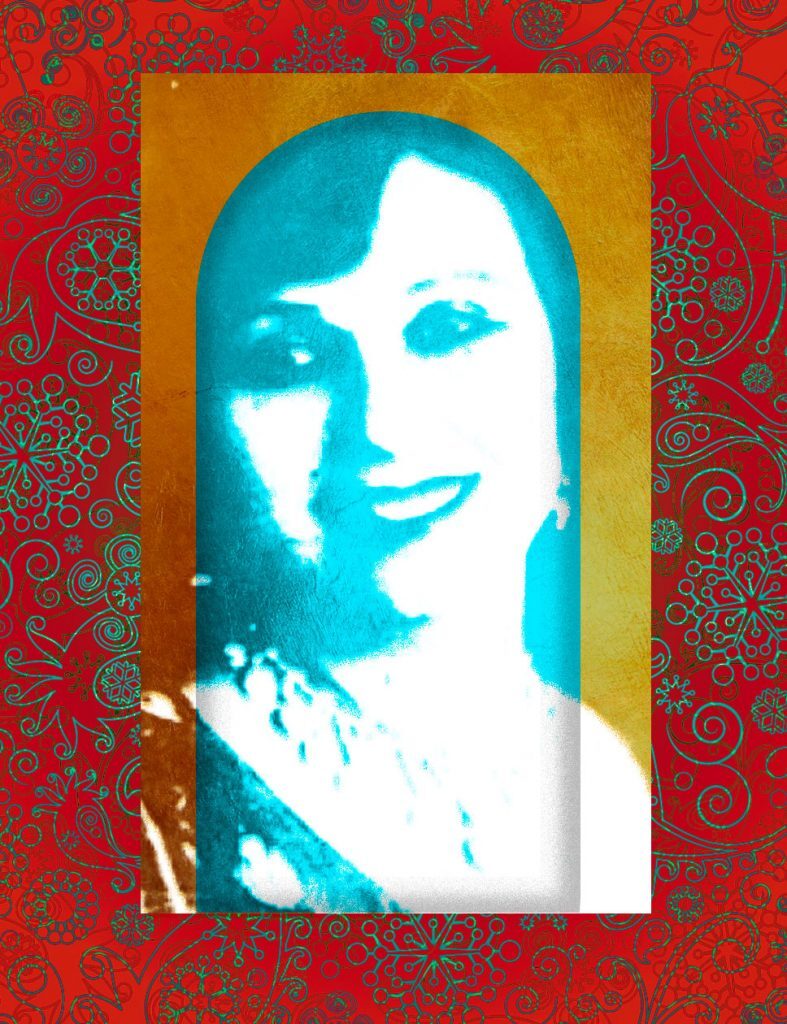في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
غادر ألبير قصيري القاهرة، بعدما أصبحت مدينة لتسلية المنتصرين في الحرب العالمية الثانية.
تقريبًا في لحظة تجاوزت فيها أم كلثوم كل المغنيات الأسطوريات اللاتي سبقنها، ولم تحظ واحدة منهن بالوجود في زمن الحفظ والتسجيل المرئي والسمعي بالميكرفون (إمكانية اتساع دائرة المستمعين) والإذاعة ( أن تتخطي صوتك جغرافيا الجسد) والسينما (الخلود في شريط عابر للزمن) والتليفزيون (في كل بيت)… بمعنى ما: أم كلثوم تقاطعت مع إمكانية الخلود اللانهائي.
غادر ألبير قصيري والقاهرة في النزع الأخير من مرحلتها الملكية، التي تعلقت بأوهام إنقاد النازي الألماني للعرش في مواجهة الإنجليز.. كانت الدولة الحديثة في مرحلة تجديد طغاتها.. وتبحث عن صورة جديدة لألوهيتها.. فالدولة هي الله بالنسبة لرعايا عالقين في منطقة بين الإنسانية البدائية.. وبين إنسانية ما بعد الدولة الحديثة.. بين الفرد في القطيع البائس.. وبين الفرد الموصوف في الدساتير والقوانين.. هذا هو العالم المدهش الذي اختار ألبير التلميذ المتمرد على المدارس، أن يكون كاتبه.. نعم، كاتبه لا راويه.. فهو كاتب اختار موقعًا ليرى ويراكم مشاهد وعلاقات ومشاعر تصنع له حكمة وفلسفة. ألبير الذي كان ينسج قصصًا من الأفلام الفرنسية والإنجليزية التي يترجمها لأمه (نادية) التي لم تعرف القراءة يومًا ما، ثم كتب في السابعة عشر من عمره ديوان شعر اسمه “اللسعات”؛ طبع منه عدة نسخ لم يظهر منها حتى الآن نسخة كاملة، وإن كان من اطلع عليه لاحظ سيطرة روح بودلير الغاضبة والمتمردة، ولم يذكر ألبير من ديوانه سوى سطر يقول فيه “وحيدًا وحيدًا كجثة جميلة، في يومها الأول بالقبر».. روح تعي لعنتها منذ الخطوات الأولى.
غادر ألبير قصيري القاهرة بعد أن نشر شحنته العنيفة الأولى “بشر نسيهم الله”.. تلك الشحنة التي وصفت بالثورية والانحياز الخام لبروليتاريا محشورة في مدينة تبحث عن اكتمال حداثتها.. عن التئام “المدينتين” الحديثة والقديمة.
في هذه الشروخ بين المدينتين تعيش شخصيات الكتب الأولى لألبير قصيري وبين الشروخ نفسها أقامت أم كلثوم جسرها التاريخي لتكون “إلهة مصر” كما سمى ألبير مسودته (سيناريو/سيرة) عن المطربة الأسطورية.
ومنذ أن هاجرت عائلة قصيري من مدينة قصير القريبة من حمص في سوريا، ومكانها وحياتها في حدود علاقة صغار ملاك الأراضي بمدينة في مدار الذبذبات العالية لمدن تفك علاقاتها بالسلطة العثمانية، وتراوغ سلطة الاحتلال الأجنبي؛ الأب (سليم) يقرأ الصحف، بينما يهتم بتعليم أولاده مع الحفاظ على علاقة متواصلة بكنيسة الروم الأرثوذكس، بجوار البيت القائم في منطقة الضاهر، مغناطيس المهاجرين الشوام الذين ساهموا في تحديث مصر كما تقول السرديات المعروفة.
ألبير كان الأصغر في وسط عائلة مهتمة بالتعليم، وانتقل من الأسلوب المحافظ لمدرسة الفرير، إلى أسلوب أكثر تحررًا في ليسيه الحرية.. لكن المهم بالنسبة له هدايا الأشقاء الأكبر المولعين بالروايات، بلزاك ودستويفسكي وغيرهم، وبالنسبة لمن رفض أن يكمل في مسار الأشقاء ويحصل على شهادة الثانوية، كان عالم الثقافة والفن الاختيار الأفضل، التسكع بمعناه الباريسي في القرن التاسع عشر هو المصير الذي انتقل معه من القاهرة لباريس.
المتسكع الأبدي اكتشف المدن من خلال تمشيات يومية، وعندما تدقق في لقطات الفيديو له في باريس أو القاهرة، ستذهلك ملامحه اللامبالية بالزحام، كأنه يسير في ممرات شفافة. يخبط المارة جسده المنتبه تمامًا في ملابس أنيقة غريبة عن العصر، لكنه ليس هنا، على الرغم من أنه هنا تمامًا.
التسكع لم يكن بحثًا عن شيء محدد.. لكنه عمل دؤوب في اكتشاف المدينة.. منها عرف أن تلك المدينة الأوربية التي بناها الخديو إسماعيل، ومع أنها جوهرة متلألئة، فإنها تصيبه بالضجر، وتصيب الناس بالخبل.. بينما هناك في المدينة القديمة وكما قال بيير جازيو؛ أصبح المقهى “مكان ينأى عن الجنون المدمر الذي يكتنف العالم وعن الخداع الكوني.. إنه المركز الحقيقي، مركز العلاقات الإنسانية حيث “تبدو الجموع مفعمة بسعادة حكيمة لا يمكن لأي عذاب أو قهر أن يطفئانها” (مقال نشر في مطبوعات احتفال المركز الثقافي الفرنسي بالقاهرة بالذكري العاشرة لغياب ألبير قصيري 2018).
العالم مُقسم بين الخداع والسخرية، وكذلك بين الأوغاد والناس، هذه رؤية فنان يعتبر نفسه كما قال بيير جازيو في لقاء قصير سنة 1989 “أكثر ثورية من خلال كتاباته، مقارنة بشخص مثل هنري كورييل الزعيم الشيوعي ومؤسس حركة حدتو يريد أن يكون رئيس حزب، فمـا فائـدة حـزب يتكـون مـن حفنـة مـن الأفـراد المثقفين الذين يكلمون أنفسهم، ولا يعرفـون حتـى اللغـة التـي يتكلمهـا الشـعب؟”.
لم يعمل ألبير في السياسة، لكنه وضع على قائمة “المخربين” بعد توقيعه على بيان “يحيا الفن المنحط” الذي أصدره الفنانين المصريين تضامنًا مع الفنانين الألمان ضد هتلر، كما أنه في رحلته الأولى سافر إلى أمريكا سنة 1942 هربًا من “جحيم القاهرة”.. عمل رئيس جرسونات على سفينة متجهة إلى نيويورك عن طريق كيب تاون، وألقي البوليس السري الأمريكي القبض عليه بعد تشككهم في أنه جاسوس، فتوسَّط لورانس داريل صاحب “رباعية الإسكندرية” شارحًا لهم “أوكد لكم أن ألبير ليس جاسوسًا.. لأنه يستغرق كل وقته في مطاردة النساء”!
ماذا في ملامح هذا الشاب الوديع يثير غريزة البوليس السياسي؟!
ربما طاقة الغضب والسخط والتمرد الساكنة تحت الوجه الصخري الذي تشكل عبر السنوات، وبدا في كل أحواله كأنه رسالة من عالم اختفى تحت الركام منذ زمن…ومازالت طاقتها تنبض بإيقاعها الخاص.