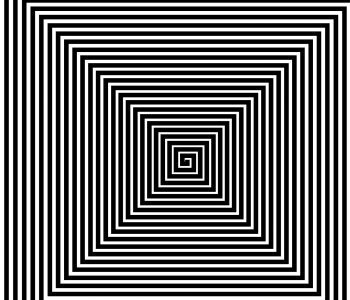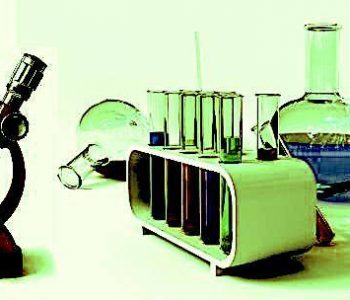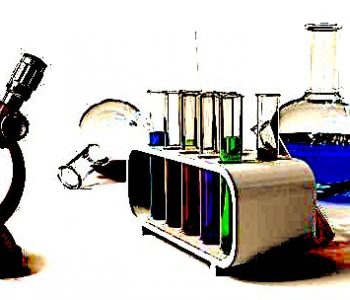في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
دقات كعب سكرتيرة الشركة التي لا تكف عن ذرع أرجاء الشقة أعلاي، وتنفذ منها عبر سقف حجرتي، هي أول ما يوقظني في الصباح..
منذ أن بدأت العمل من المنزل، حينما بدأ الحجر الصحي، وأنا أستيقظ على دقات كعبها في الصباح..
كل صباح صار مطابقًا لكل صباح..
وكل نهار صار مماثلاً لكل نهار..
ولم أعد بحاجة لتذكر أسماء الأيام..
حينما تعمل من المنزل، حينما تكف عن تبديل ثيابك، حينما لا تحتاج لتلميع حذائك، لا يكون بوسعك تفقد تقويم الحائط، كل ما تحتاجه، هو أن تستيقظ يوميًّا، وتذهب إلى المطبخ، وتعد قهوتك، ثم تعود إلى اللاب توب.. الذي تخلى هو الآخر غريبًا عن مستقره، بات لصيقا بي في السرير.. وبات لا يفارقني.
صباحات كثيرة أستيقظ وأفتح البلكونة، ألقي نظرة سريعة على عمال الجراج الذين يستلقون في استرخاء دون أن يحملوا هما لأصحاب السيارات الذين باتوا جميعًا محبوسين في المنازل بفضل أوامر الحجر الصحي، الجميع يخشى الخروج الآن، الوباء منتشر، وكل نزول للشارع يجب أن يكون ملحقًا بسبب قهري يبرره، ألقي عليهم نظرات مشفقة، شاعرًا بالتعجب والفضول، هل يخشى عمال الجراج من الوباء؟ هل يعطسون في وجوه بعضهم بعضًا؟ ألا يخشون من المرض؟ من الموت؟
ألف سيجارتي، أحشوها بالتبغ، أشعلها، أطلق أول نفسين في الهواء، لعلهما يعثران بالفايروس ويمحوانه، قالوا إن الفايروس دهني، وأنه لا ينتقل في الهواء، لكنه سيصيبك حتما ما لم تقبع بالبيت، وهاهو البيت، أكتشفه لأول مرة كأنني انتقلت إليه حديثا، الشقة واسعة، ثلاث حجرات خالية من الأثاث، ومطبخ وحمام، وحمام صغير للضيوف، ثلاجتي كانت معظم الأيام خالية، لكنها لم تعد هكذا منذ يومين، وضعت أكياس المكرونة والأرز وعلب التونة والصلصة فيها، ثم حينما تعفنت كيلوات الخضار الأولى في المطبخ وظهر بها العفن الأخضر، أدركت أنني أخطأت، وهكذا عرف الخضار والفاكهة طريقهما إلى الثلاجة، وطُردت أكياس المكرونة والأرز خارجها.
كان العالم خارج باب شقتي مضطرب.. وكذلك داخل مطبخي..
للمرة الأولى أتخلى عن نظام حياتي الرتيب، وأبدأ تأسيس نظامًا جديدًا، كنت أذهب للجريدة في الصباح الباكر، وبعد قضاء شيفت ثمان ساعات، أخرج إلى مطعم مع زملاء لنأكل، طبعا كنت آكل وجبة إفطاري على مكتبي بجوار زملائي في حجرة “الديسك المركزي“.. نعم.. هي تلك الحجرة التي يعمل فيها أسطوات الكتابة، أساتذة إعادة الصياغة، حجرة عامرة بالدخان والنكات الجنسية الفاحشة والنميمة المتواصلة كذرات الهواء.. باتت الآن خالية من أي حس أو خبر..بتنا جميعا نعمل من المنزل.
لم أكن أتناول غذائي وحيدًا أبدًا، كنت إما أتوجه إلى نقابة الصحفيين وأصعد للطابق الثامن، حيث آكل أرخص وأشهى طعام، أو أتوجه إلى مطعم وبار هابي سيتي فأتناول نصف دجاجة مشوية مع زجاجتي بيرة، لكن هذا يحدث فقط في بدايات الشهور، وتتناقص زياراتي لهابي سيتي حتى تنقطع مع الأيام العشرة الأخيرة من كل شهر.
كل الجراثيم التي كانت محببة الآن باتت مرعبة، كل العادات السيئة التي كانت محببة، باتت الآن مرذولة، الأكل على عربات الفول، وضع السندوتشات على المكاتب بجوار اللاب توب أو أجهزة الكمبيوتر، الأكل ثم العمل مباشرة، دون أي غسل للأيدي، الآن بت أغسل يدي كل خمس دقائق، دون أن أأكل، ودون أن ألمس شيئا.
الآن صار “هابي سيتي” مغلقا، وصارت “النقابة” مغلقة، ولم يعد من الممكن أن أأكل في الخارج..بات من الواجب أن أتعلم “تدميس الفول” ونقع “الفول المدشوش” وطحنه في “الكبة” لكي أنعم بطبقي فول وطعمية، وبات من الضروري أن أتعلم سلق المكرونة، وطهو الأرز، وتتبيل “الدجاج“.
الأيام الأولى من العزلة احترقت مني حلل المكرونة والأرز، سلة قمامتي التي كانت دوما فارغة، باتت ممتلئة الآن بفضلات أكل محترق، أو تعفن، عشت ليال طويلة على علب التونة، تحولت العزلة إلى كابوس، وتحول الحجر الصحي إلى سجن.. المنزل الذي كنت أقضي فيه سواد الليل، بدأت أتعرف عليه كأنه بيت جديد تسعد حوائطه بالكائن البشري الذي يتجول بينها، ويحاول أن يتحدث إليها، شقتي التي ورثتها عن أبي وأمي، وكنت أتعامل معها كفقاعة تحتوي جسدي ليلاً، وتلفظه نهارا، صارت الآن في مواجهتي.. صارت متجسدة أمامي.. شقة يعوزها الكثير من أعمال الصيانة، لمبات حجراتها محترقة، وفيشها لا تعمل، دهان الحيطان تقشر في أغلب الحجرات، وباتت الجدران باهتة قذرة، الأرضيات بها بلاط قديم لم ألحظ قبحه وقدم موضته إلا حينما بدأت أكنس التراب الذي تراكب فوقه طبقتين وكنت أمسك المقشة للمرة الأولى منذ سنوات، أما حمام شقتي.. فالأركان شديدة الاتساخ، شعر متكوم فوق البالوعة سدها تقريبا ونجح في حجز الماء فوق القيشاني خلال نهارات الأيام التي كثر فيها دخولي واستخدامي للحمام.
هذا بجانب اكتشافي أمر خطير.. وهو أن غسالة أمي لا تعمل، وموضتها قديمة، غسالة من الغسالات العتيقة ذات البدن الأسطواني، المزودة بعمود في جانبها يحمل عصارة الملابس بالذراع المتدلي من جانبها، كان صوتها الذي ينبعث في الصباح مكتوما متحشرجًا يدل على أن أمي استيقظت وبدأت يومها بنشاط مكثف، كانت تدير الغسالة كي تعلن عن بدء الحركة ومطلع الشمس، ماتت أمي، وصمتت غسالتها إلى الأبد، وتحولت الآن إلى جثة من الصاج، يتدلى سلكها بجوارها، وتنتصب عصارتها كرأس خيال مآته يطل على حقل تشققت أرضه ومات زرعه.
منزل لا يحوي غسالة، بات اقتناء واحدة أمرًا ضروريًّا، بعدما أصبحت المغسلة القريبة مجبرة على الغلق وقت حظر التجوال، وهي أصلا كانت تبدأ العمل بعد الظهر، وحينما انتشرت أخبار الوباء، وتطبيق قرارات العزل الصحي، ثم فرض حظر التجوال، اختفى المكوجي الشاب الذي كان يعمل فيها، فصار صاحب المغسلة وحيدا، لا يقدر على إنهاء غسل كل ما يتلقاه من ملابس “العزاب” أمثالي، ثم صار يؤخر الملابس.. بات من الضروري أن أقتني غسالة لأول مرة في حياتي.
*****
الشوارع أغلب ساعات اليوم صامتة كجبانة.. لكن دقات صاحبة الكعب توقظني.. تذرع سقف بيتي من أقصاه إلى أقصاه.. كأنها تزاول تمارين المشي الرتيب.
الناس تخزن الطعام بجنون كأنها لن تجد السوبرماركت في الصباح التالي، ما حاجتنا لكل هذا الطعام إذا قامت القيامة؟ خواطر مرت على ذهني سريعا وأنا أتامل الرجل الذي يسبقني في الطابور وهو يخرج الكريديت كارد ليدفع ما قيمته ستة عشر ألف جنيه، كان معه ثلاثة حمالين ليعاونوه في حمل مشترياته، كانت فاتورة طعامي كلها لم تبلغ الستمائة جنيه، اشتريت عشر كيلوات أرز، ومثلهم مكرونة، وعلب صلصة، ودقيق، وعلب التونة المحببة، وأكياس الفول السوداني والطماطم والخيار والكرنب الأحمر، والخس الأخضر، والعيش البلدي، والعيش الفينو، وعلب اللبن.
بينما أعود بأثقالي، كانت كلاب الشوارع متراصة كأنها جثث، رغم إيماءات ونباح ضئيل لظننت أنها لفظت أنفاسها، لكنها بالتأكيد تعاني من الوهن.. مرت برأسي أسئلة كومضات:
من يطعم الحيوانات ساعة الحظر؟
من يلقي للكلاب والقطط طعامها؟
من يسقي الأشجار.. والجناين؟
ومن يتنفس هواء الشوارع الفائض عن الحاجة؟
الكلاب تنبح ساعات الليل.. لا ريب أنها جائعة..
أفكر بينما أكدس في مطبخي أكياس الأرز والمكرونة، وأرمقهم بشك، هل سأنجح في طهيهم؟ أم سأحرق الحلل؟
كنت قد جلبت أكياس الكلور، على الانترنت يكتبون وصفات لكل شيء، يكتبون وصفات لتخفيف الكلور بالماء، وتطهير المنزل، تطهير الأحذية، حتى بدأ البعض يكتب وصفات كاذبة فيها الكثير من التدليس لإعداد كحول إيثيلي منزلي.. نفدت المطهرات من الصيدليات.. آخر زجاجة كحول ابتعتها كانت بحوالي ثلاثين جنيها.
وضعت الكلور في قنينة مزودة برشاش، وحملتها مرتديا قفازا طبيا، ورششت كل ما جلبته، رششت الأكياس، وعلب الجُبن، ومعلبات الشاي والقهوة، والخس والجرجير، رششت طعامي بالكلور المخفف، أي وباء يجعل الإنسان يفضل أن يُسمم نفسه بالكلور، على أن يموت تدريجيا بصعوبة التنفس وآلام تليف الرئة المبرحة؟
في الفجر لم يزل المؤذن يبكي بينما يردد صيغة الأذان الجديدة: ألا صلوا في بيوتكم.. ألا صلوا في رحالكم..
لم أصل بانتظام، إلا من أجل أخذ ساعتين راحة من شيفت “الديسك” يوم الجمعة، خلال هذين الساعتين يتوقف العمل في الجريدة، المحررون يهرعون للصلاة، وبالتأكيد محرري الصياغة أيضًا، وهكذا كنت أذهب لأداء صلاة الجمعة كوسيلة للهرب من العمل ليس إلا، أما باقي الأيام.. باقي الصلوات.. فلم أكن أقربها، لكنني الآن بينما أسمع المؤذن، أكتشف أنني لست وحدي الذي يجرب أشياء جديدة في منزله، أنا والآخرين.. المصلون.. نجرب منزلنا.. هم أيضا صاروا ملزمين بتجربة منزلهم وتحويله إلى شيء آخر لم يعهدوه من قبل.. تحويله إلى زاوية.. أو مسجد صغير.
*********
عادت دقات كعبها تطرق سقف حجرتي..
هذا الصباح قررت أن ألعب لعبة.. كلما تحركت صاحبة الدقات.. خمنت فعلاً تفعله..
بدأت أركز في تحركاتها في سقف حجرتي.. كانت تبتعد عن منتصف الحجرة.. كأنها تذهب باتجاه الباب.. حيث تقبع هناك قليلاً.. حاولت تخمين ما يمكنها أن تفعله عند الباب؟
شعرت أنها تقف إزاء وحدة أدراج من الاستنلس.. المستخدمة في المكاتب والشركات.. تستخرج منها ملفا، وتطالعه.
حاولت أن أذهب بعيدا بهواجسي وخيالاتي.. حاولت أن أتخيل أنها عند الباب.. تراقب شخصًا ما.. زميل آخر..
لكنني لم أسمع خطو غير خطواتها، ولم يظهر في سقف حجرتي سواها.
تحركت إلى حيث تقف، ورمقت بدقة محاولاً أن أتخيل ماذا تفعل في هذا الموضع، كانت تحديدًا تقف على عتبة باب الحجرة، تواجه الحمام، والمطبخ، وإلى اليمين صالة الشقة، فلماذا تطيل الوقوف في هذا الموضع؟
ظللت واقفًا كالأبله على عتبة حجرتي، محدقا كالمعتوه في السقف، متخيلاً أن صاحبة الكعب، تقف أعلاي الآن، تدريجيًّا بدأ عقلي يعمل بطريقة أخرى.
بدأت أتخيل ملابسها، بدأت أتخيل أنها رشيقة العود، وليست بدينة، وإلا ما طاقت أن تذهب وتجيء بالكعب العالي، بالتأكيد هي طويلة، قد تكون قصيرة، لكن طولها لم يكن هو شاغلني، ما كان يشغلني في الحقيقة هو بدنها، جسمها، هي بالتأكيد جذابة، هي على نحو ما ممتلئة القوام، ليست بدينة، وليست نحيفة، لكنها من المؤكد ممتلئة، عامرة، قوة دقات كعبها توحي أن فوق هذا الكعب بدن عامر، بدن لحيم، لما لا.. وإلى أن يثبت العكس، استسلمت لهذه الفرضية، فرضية أن بدنها عامر، وهذا يعني أنها لن ترتدي بنطلونات جينز، فالبنطلونات بكل تأكيد تزعج صاحبات البدن الممتليء، ولا يرتحن صاحبات هذا اللحم الوافر، في بنطلون ضيق يكمم لحمهن الفائض، هن يرتحن بكل تأكيد في ارتداء التنانير، فالتنورة تتيح للجميلات الممتلئات أن تطلقن عجيزتهن دون أن يحددنها بملابس تحددها، وتثير شهوات العابرين، وتلفت أنظار القذرين.
هكذا وأنا واقف أكثر من خمس دقائق عند عتبة باب حجرتي، رسمت صورة متخيلة لصاحبة الكعب، وبت واقفًا طوال هذه الدقائق الخمس محملقا في السقف، وقد امتدت خيالاتي، وبت مقتنعًا أنني أحملق فيما بين فخذيها، أسفل تنورتها، وهكذا بعد خمس دقائق، تحركت صاحبة الكعب، ودقت الأرض بساقيها، مبتعدة، وانتفضت أنا مستيقظًا، محاولا تتبع خطوها فوق رأسي، كانت تتحرك بسرعة، كأنها تلملم أشياءها وتستعد للرحيل، وفوجئت بها تتحرك مغادرة الحجرة، هرعت إلى الصالة وأنا أحملق في سقف الشقة كالأبله تمامًا، فاصطدمت في تلك الأثناء بمقعد لم أره كان في طريقي، سقطت على وجهي، ارتطمت أنفي ببلاط شقتي، كأن أحدهم هوى على رأسي بلكمة قوية، أو بضربة هراوة، نزف الأنف بسرعة على البلاط، كانت دقات الكعب تبتعد في اتجاه باب الشقة، بينما أنفي ينزف.
في المساء كانت أنفي قد كفت عن النزف..
ظللت رافعًا وجهي محملقًا في السقف، بجرح في الأنف لم يندمل، محدثًا نفسي بعبارة تظل تروح وتجيء.. هي أنني أريد أن ينتهي كل هذا.. أريد أن أغادر منزلي.. الذي ربما الآن بات يثأر من سنين إهمالي له.. فالبيوت تموت إذا ما غاب سُكانها، أو إذا أهملوها، وإذا ماتت البيوت.. لا تموت وحدها.. بل تموت وتضيق على من فيها.