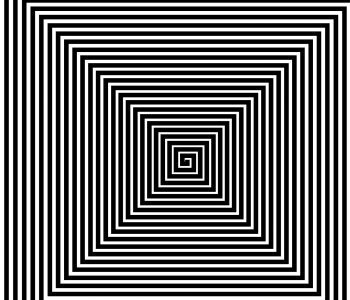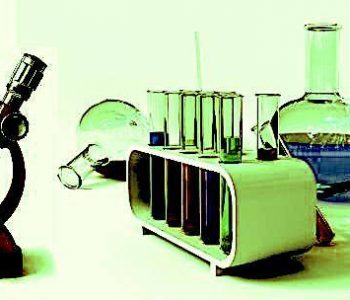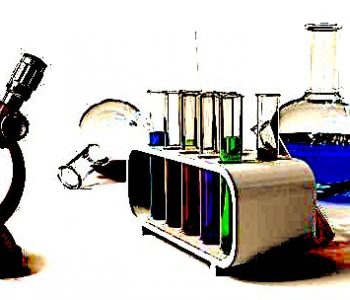الباسوورد هو كلمة سر العالم الجديد والعمل عن بعد!
كان دولوز قد لاحظ قبل زمن بعيد جدًا موضوع الانتقال من مجتمعات التأديب إلى مجتمعات السيطرة حيث لا ضرورة لحجز الناس، بل فقط الطلب إليهم ادخال الباسوورد في كل انتقال من حال إلى حال. لكن هذا الانتقال حتى عشية الجائحة، لم يكن ناجزًا. استمرت الحاجة إلى إرسال الأطفال إلى المدارس، والعمال إلى المصانع، والمساجين إلى الزنازين، والموظفين إلى علب مكعبة تسمى مكاتب. لكن المصانع، مع الوقت، انتقلت إلى الصين، وهولندا تؤجر سجونها لدول أخرى أو تقفلها لقلة المساجين، والأطفال يقضون وقتًا أطول مع الروبوتات والشاشات منه على المقاعد الخشبية التي كانت تؤلم مؤخراتنا. وقبل الحظر بأسابيع قليلة، كنا في العمل قد اعتمدنا نظامًا جديدًا للعمل عن بعد في بعض أيام الأسبوع تحت شعار الاهتمام بالموظفين وراحتهم. كان دولوز أيضًا قد لاحظ أن مجتمعات السيطرة أيضًا ستعني معاملة كل إنسان كمريض محتمل عليه أن يراقب معطياته الحيوية وحالته الصحية بل وأن يبلغ السلطات عنها. ولئن كنا قد اعتدنا على أن المرء يفكر يوميًّا في وزنه وأكله وشربه وسعراته الحرارية، ويحضّر جسمه لشيخوخته ويقيس ضغطه والسكر، لكن الجائحة عنت بالضبط اعتبار كل شخص، بما في ذلك النفس، ومعاملته ومعاملة الذات كحامل ربما للفيروس القاتل الغامض الذي يترك المصابين به في ثمانين في المئة من الحالات دون إشارات ولا عوارض!
لكن الجائحة، في وصفها كارثة، لم تجترح هذه الأحوال في ذاتها. الكارثة هي ما يمر ويترك كل شيء بالضبط على ما كان عليه، مثلما لاحظ موريس بلانشو، كما لو أن لا أثر يدل عليها. في كلام أقل تكثيفًا من قوله، الكارثة لا تُنشِئ بل تكتفي بالكشف عن خطوط الانهيار التي نتعامى عنها في صورتنا عن نفسنا وعن العالم، توسّع الجراح التي تشطب جلدها، وتسرّع الشقوق المتكاثرة في دهانها. هي ربما كالألم عارض يكشف لنا عضلات أو مفاصل أو عظامًا لم نكن ندرك أنها فينا ولا وتيرة استعمالنا لها، لكن الألم ليس أثرها ولا السرعة يمكن اقتفاؤها.
ليس سرًا أن المثال التقليدي للتعلم بات بائدًا مملًا للطلاب مقارنة بوسائط الإنترنت والحواسيب التي سترافقهم طيلة حياتهم، ولا أن سلاسل التوريد البالغة الطول والمتعددة المصادر لتصنيع منتج واحد تتحدى أي عقلانية غير مالية، ولا أن تركيز العمالة في الصين معضلة تبرز نتائجها في كل حين وكل استفتاء أو انتخاب في الغرب، ولا أن انهيارات البيئة وتغيرات المناخ والقضاء على الطبيعة التي يمكن للحيوانات والحشرات أن تعيش فيها يهدد تنفس البشر وليس فقط صحتهم، فضلًا عن اضطرار الملايين منهم إلى الهجرة، ولا أن استكمال المكننة لن يكون إلا بإحلال الروبوتات محل العمالة وإن رخصت، وقذف ملايين جديدة إلى صحراء البطالة، وأن الأزمات المتكررة الناتجة عن انفصال البورصة والمصارف عن الاقتصاد الحقيقي لا مخرج منها الآن لأن الحياة السياسية نفسها قد احتلها المنطق المحاسبي المالي نفسه، ولا أن الهوة المتفاقمة بين دخول الأغنياء ودخول موظفيهم، بل العاطلين، أصبحت تقارن بأرقام فلكية تجعل من استمرار قدرة هؤلاء الموظفين أو العاطلين على تمويل نمو ثروة الأغنياء أنفسهم موضع شك. لم تجترح جائحة الكورونا أيًّا من ذلك، لكنها فقط جعلت من المستحيل إشاحة النظر عنه.
لهذا ظن كثيرون في البداية أن عالم ما بعد الكورونا سيكون أفضل، لأن البشر لا بد سيعالجون هذه المشكلات. غير أن أولى الإشارات الواصلة إلينا تعاكس ذلك تمامًا. المنطق المالي يزداد تغولًا، التحركات السياسية أضعف من أن تقاومه، اليسار خاوٍ واليمين انتهازي، الأجانب والمهاجرين أكباش محارق قادمة، أما معايير البيئة فتنهار عند معارضتها بضرورات استمرارية الوظائف وربح رأس المال سهل الانتقال بخلاف الأشخاص. كأن مستقبلنا بات قديمًا وأصبحنا نتأمله في قلق ونحصي جراحه المفتوحة.
التسريع الحاصل لإتمام الانفصال عن مجتمعات التأديب نحو مجتمعات السيطرة، بوسائط التعليم والعمل عن بعد، ورقابة التطبيقات الهاتفية على صحة الأفراد، ووسائل الرقابة الإلكترونية على تنفيذ العقوبات، وإعادة النظر في تنظيم المكاتب والمصانع لتفادي اللقاء الجسدي، والتوجس العام لدى كل فرد من الغرباء بما يمنع حتى اللقاءات العاطفية، وأحلام إطلاق “باسبورات المناعة” شرطًا للسفر، قد لا يكون الرد الأنسب على معضلات العالم الخطيرة. ذلك كله قد لا يعدو انتشارًا مخيفًا لبعض أسوأ مناحي الحياة. هو فرع على شجرة وجودنا يتغول عليها منذ وقت بعيد، لكنه انتقل إلى مرحلة الانتشار السريع الخانق لأشكال الوجود الأخرى.
ترسم الكارثة أيضًا خط التماس أو خط المعارك القادمة، بين لئام لا يرون فكاكًا من المنطق المالي/الانعزالي/الاستعلائي/فردي الخلاص وبين من يرون الخلاص الفردي مستحيلًا إذ لا تمنع الجدران لا اللاجئين ولا الحرائق ولا الجراثيم ولا التصحر، ويرون أن الألم والمرض ما يجمع كل إنسان حاملًا بالبشر جميعًا ويضم البشر كتلة واحدة تملك موارد مواجهتهما عبر إعادة توزيع أولوياتها على هذه الجبهة بدل جبهات الحروب المدمرة. إما ذاك وإما أن المشكلات نفسها ستكتفي باتخاذ مظاهر جديدة، تسمح للبشرية أن تتنفس قليلًا دون أقنعة، لقليل من الوقت، قبل أن تأتي كارثة جديدة لتظهر ألا وجود بشريًّا دون الانهيارات والجروح والشقوق المتكاثرة كالطحالب السامة أو كشبكات العنكبوت العاصرة لضحاياها.