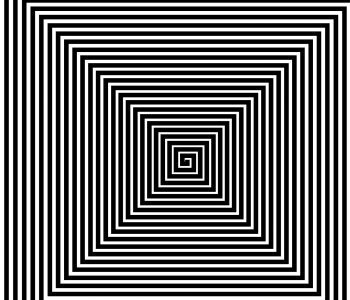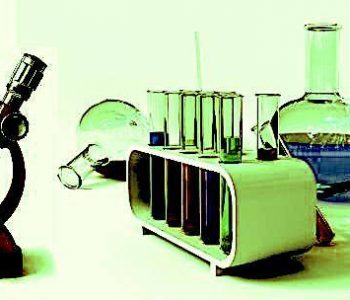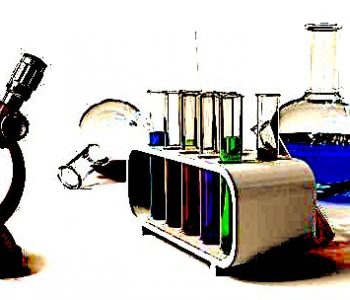في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
ملازمًا لغرفتي الصغيرة جسدي، مستسلمًا تمامًا على سرير من الملل، أغطي جسدي من القدم إلى الرأس بغطاء من اللامبالاة، بعد ساعات طويلة من الحرب مع الأرق والتفكير فيما الذي يمكن أن يحدث في الأيام القادمة، عقلي محشو بصراعات الغربة والموت والمستقبل، بينما يظل بصيص الأمل الذي ما يزال يدفعني للمقاومة؛ بريق عيني ابنتي.
قبل أشهر من الآن كنت قد غيرت نظام حياتي، ومع أول أيامي في مسقط وعدت نفسي بأن أحاول الاستفادة من الوقت، أستيقظ مبكرًا مع أنها عادة قديمة، في سنواتي الأول بالقاهرة ارتبط مفهوم الفشل بالاستيقاظ متأخرًا حتى لو نمت في السادسة صباحًا، وارتبط البقاء في المنزل لدي بالبطالة، 12 عامًا لم أجلس في بيتي لأكثر من يومين حتى لو نزلت لزيارة الطريق فقط؛ بحثًا عن عمل، أو أي محاولة لأثبت لنفسي أنني أحاول، لم أيأس، لم أخرج من قريتي الصغيرة لأعود أحمل خيبتي فأعاير بها إلى ذلك اليوم الذي أموت فيه، إنه إرث حملته على ظهري مهما سخرت اليوم منه.
12عامًا طاردتني فيها ملاسنات كثيرة – المنطقة الصناعية عايزه عمال – شوف لك شغلة – صحافة إيه كان غيرك أشطر – لكنني وفي كل مرة كنت أنتصر قبل الخروج الأخير، كانت الدنيا قد سلبتني أبي وأمي، ومنحتني بفعل قسوتها المبالغ فيها قوة وجلدًا على تحمل ما لا يمكن لغيري تحمله.. في اللحظة التي أسقط فيها أنظر إلى ذراعي اليمنى، فأراني أحمل رأس أبي أو أمي قبل وفاتهما، ذراعي اليمنى كانت شريكتي الوفية في تلك اللحظات، أدفن رأسي به تشم أنفي رائحتهم فأستعيد عافيتي، أو لنقل أسترد القدرة على مقاوحة الدنيا، وأقول لن يمر عليَّ أقسى مما مر.
أيامي الأولى في الحجر المنزلي بسبب كورونا بدأت في 16 مارس، عدت من القاهرة بعد زيارة سريعة لأجدن نفسي في المنزل مضطرًا وإلا عوقبت قانونيًّا، لكنني على الرغم من ذلك عملت من المنزل، لم يتركني الجورنال لحظة واحدة، انتهى الأسبوعان، وعدت للعمل أسبوعين ثم مجبرًا كالجميع حصلنا على إجازة أسبوعين من رصيدنا السنوي بديلاً على خفض الرواتب في ظل أزمة كورونا، وتقبلتها عن طيب خاطر على الرغم من كل شيء.
عشت في أيام العزل والإجازة الإجبارية مشاعر كنت ظننت أنني نسيتها، فلسنوات طويلة قاومت إحساس إبن القرية الذي عاش في نطاق ضيق يعرفه الجميع ويعرف الجميع، حين ينتقل إلى القاهرة بأضوائها وزحامها القادرة على جعلك تتلاشى تمامًا، القاهرة التي تذيبك فيها خاصة وأنني كنت وحيدًا تمامًا بكل إرادتي ذبت فيها انصهرت تمامًا لكن الخوف أن أموت وحيدًا لم يتركني. في الصغر رأيت من يموتون خارج القرية.. الاستعدادات التي تحدث؛ من المساجد التي تفتح للمناداة على اسم المتوفى كانت جملة “الدفنة عند وصول الجثة“ مرعبة، مات وحيدًا بعيدًا عن أهله، ميتة صعبه، على الرغم من أنني لسنوات أيضًا تعمدت السخرية من ذلك الإحساس “أوفر قوي“، لكنني لم أتخلص منه أبدًا، كنت أظنه الأكثر قسوة على الإطلاق، لكن على ما يبدو أنني كنت أمام شعور آخر.
في بلاد أخرى غير بلادي هذه المرة، ليست القاهرة، أنا في مسقط في غرفة 4 في 4 أمتار بلا أصدقاء، زوجتي وابنتي في القاهرة بعيدًا عني، شعور آخر أشد قسوة، في العمارة التي أسكن بها لا يوجد أحد غيري قال الشاب السوداني (يعمل سمسارًا ويدير العمارة)، إن البعض ترك الشقق إلى أخرى أصغر، وأن آخرين كانوا في زيارة لبلادهم قبل أن تغلق المطارات فلم يعودوا.
الآن أنا هنا، أواجه الكثير من مشاعري السلبية ومن مخاوفي، أقاومها دون أن أسقط، وحين يسيطر القلق علي أتشبث بضوء عيني ابنتي داليدا لأبقى، أقول أمامي الكثير ستمر هذه الأيام، الكثير مر، كنت قويًّا حين تشم رائحة أبيك وأمك، ألا يستحق بريق عيني ابنتك أن تواجه ذلك القلق. أسخر من نفسي بجملة سينمائية “بلاش أفورة يا يوسف يا وهبي“، أكمل مشاهدي التمثيلية على أكمل وجه، أضع قليلاً من الماء في الكاتِل، الشاي الذي انتهيت منه للتو لم يكن مقنعًا لنشرب واحدًا آخر.
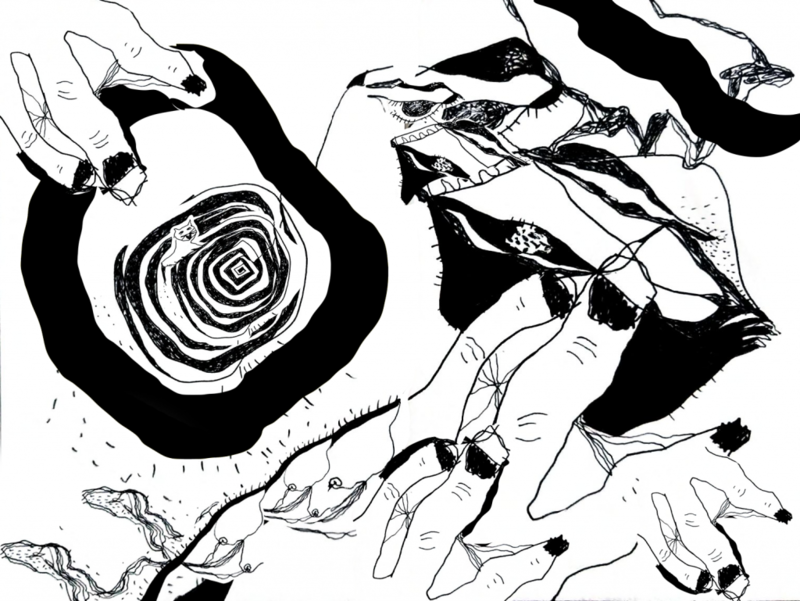
أمس وقعت عيني مصادفة على الكتب التي أصحبها في ترحالي الدائم. كانت حزينة تنظر إليَّ بلوم، كأنها تقول أنا مهملة ومنسية، كنت قد نسيتها عن عمد في نوبة الغضب الأخيرة، ضربتها بغل أطحت بأوستر والطيب صالح ونجيب محفوظ وميلان كونديرا على الأرض، ركلت مياس بقوة، ظلت الكتب أسبوع كامل ملقاة على الأرض قبل أن أضعها بإهمال على الكنبة.
تذكرت حين حزمت ما أحب من الكتب كي تصاحبني في سفري الذي ظننته طويلًا كأنني لن أعود، كنت قد قرأت هذه الكتب أكثر من مرة لذا فلم تكن معي بداعي الاطلاع قدر التماسي منهم أن يؤنسوا وحدتي، في غرفتي التي تخنقني جدرانها لكنني لم اقرأ، لم أكمل الكتابة في مجموعتي القصصية، توقفت عن ممارسة الرياضة وعادت الشحوم إلى جسدي مرة أخرى بعدما ظللت 4 أشهر أحاربها حتى فقدت منها 22 كيلو، كل شيء كان ينذر بالخسارة، يتسرب إلى داخلي القلق الشعور بالندم، الإحساس بأنني كنت متسرعًا، ومع شروق الصباح أقول كل شيء سيكون على ما يرام، أفتح هاتفي، أرى صورتي أحتضن داليدا، ثم أقول ما يزال لدي حياة أخرى حياة بابتسامة ابنتي.
أحب الاقتباسات، ولدي عادة حين أقرأ أمسك بورقة وقلم، أدوِّن اقتباسات أشعر بأن الكاتب كأنه يحادثني، آخرها أمس، حين أمسكت الأعمال الكاملة للطيب صالح في روايته الأهم “موسم الهجرة إلى الشمال“ تقع عيني على كلماته: “سأحيا لأن ثمة أناسًا قليلين أحب أن أبقى معهم أطول وقت ممكن، ولأن عليَّ واجبات يجب أن أؤديها، لا يعنيني إن كان للحياة معنى أو لم يكن لها معنى وإن كنت لا أستطيع أن أغفر فسأحاول أن أنسى.”
هذا ما أريد أن أقوله أيضًا لدي حياة وأحبها لدي ابنة وزوجة وأصدقاء، لدي الكثير لأقدمه، أريد فرصة لأسهر في وسط البلد، وأن أسير إلى جوار صديقي محمود عبد الدايم، أمارس طقوسي في هابي سيتي، وأسمع سخرية مينا: “نفسي أشوفك بتشرب“ يضحك كلانا.. ثم يطلق إحدى نكاته القبيحة، ونواصل السخرية من كل شيء.
أفتح الفيس بوك، بما تفكر؟ أكتب: “على الإنسان أن يتعود ما يفرضه عليه الزمن.. الوحدة، الضجر، الفراق، الهزيمة التي نتلقاها من الخارج، أو من أنفسنا، التقلبات المتكررة، والهبوط بعد صعود مضنٍ، المرارة التي تصيبك في لحظة فرح.
الزمن عدو قاسٍ، هذا ما أقول دائمًا، وأقاومه بكل قوتي، على الرغم من أنني في النهاية أستسلم له، لكنني مع كل ذلك لا أنكر أبدًا أن الكثير من اختياراته كان فيها على صواب وكنتُ أحمق، لكن على ما يبدو كلانا مستمتع بلعبة الاختيار والمقاومة“.
في كل يوم تأخذ زوجتي العهد عليَّ “لن تتركنا وحدنا مرة أخرى” فأقسم لها بأنني لن أفعل مرة أخرى، تعرف أنني غادرت من أجلهم، الحياة خانقة حين تسيطر عليك مشاعر الأبوة؛ تفعل أي شيء لا تؤمن به، رفضت من قبل عرضين، كنت سأصبح أنانيًّا لو رفضت الثالث، وحين ينتهي حديثًا أراجع شريط أيامنا، وأقول من جديد لدي حياة أخرى في انتظاري.