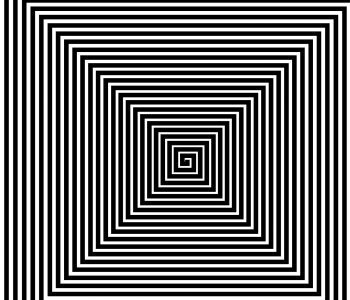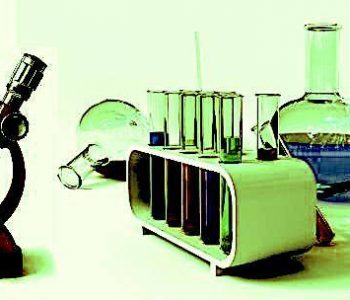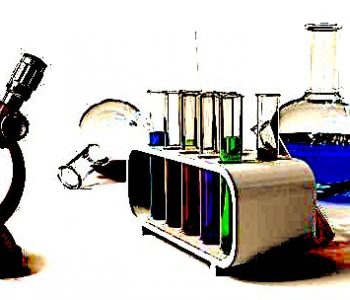في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
كانت لحظتي الأقسى في أول أيام الهلع من الوباء في القاهرة، عندما تبادلت مع صديق، وحيد كحالتي، أرقام هواتف الأقربين إلينا، لكي يحظى الواحد منا بمراسم وداع لائقة حال وصلت المصيبة وتربعت تيجان كورونا فوق رئة أحدنا، على الفور داهمتني الصور الواردة من إيطاليا؛ ما هذه المحارق الهائلة يا الله؟ كيف تسمح بأن نغادر الحياة بهذه الطريقة الفاجعة؟
لم أكن أشعر بعظم الأزمة، حسبتها ستمر دون أن تكلفني عناء إفساح مجال لها في عقلى المزدحم بأفكار شتى، ماذا يمكن أن يقدم كاتب للعالم ضد وباء؟ لم أحفل بالعلم قط مع أنني، بالطبع، أحترمه وأجل العلماء، لكنني لا أجيد ولا أملك سوى الكتابة وحبر قلبي لا يستطيع شفاء مريض واحد، فما بالي بجائحة تلتهم الآلاف وتستمر في الفتك ببني البشر بضراوة.
رتبت جدولًا جديدًا للحياة في ظل الوباء، قائمة مشاهدات لأفلام الإيطالي سيرجيو ليوني، قراءة تخطيط نظرية الجمال عن الإسباني چورچ سانتيانا، والثورة العرابية كما كتبها صلاح عيسى، وبعض من مقالات جوزيف مسعد القديمة.
لا أبالي كثيرًا بتبعات العزلة، في الواقع أحبها وأفضلها، لذا لم أعان بسبب الحجر المنزلي بعد تفشي الوباء في العالم، أقرأ، أكتب، أشاهد، أستمع وأتأمل عالمًا منكوبًا بالهلع، يؤلمنى خوف الناس، ويسرِّي عني فراغ شارع قصر العيني في تمشية يومية عند الخامسة مساءً، وأقول بصوت حزين للمجاذيب المستلقين على أرصفته كفراشات كسالى: كيف نسوكم هنا يا جماعة؟
لا أعتبر نفسي من كارهي العزلة، وبالتبعية لا أعبأ كثيرًا بمصاعب الحجر المنزلي وما أسمته الحكومة التباعد الاجتماعي، لقد عشت نصف عمري وحيدًا، أطوي الساعات تلو الساعات أقرأ أو أفكر في جملة أعجبتني.. على سبيل المثال حينما قرأت رواية جبرا إبراهيم جبرا الفاتنة “البحث عن وليد مسعود” قضيت وقتًا طويلاً في تأمل جملة ترد على لسان وليد في وصف إحدى حبيباته: “أتأمل جمالك مثلما يتأمل الصوفي في ذات الله”، وتداهمني تساؤلات؛ كيف كتبها؟ لماذا أعجز عن اجتراح جمل مثل تلك؟
وحدتي الطويلة والممتدة لا تعني أنني أكره البشر، في الواقع أنا أحب بني آدم حبًّا جمًّا، وأحاول أن أبني علاقات جيدة مع الناس، وفشلي لا يدفعنى أبدًا إلى عدم المعاودة مجددًا، ومثل الراحل صلاح عيسى أفضل أن أفتح نافذة في قلب جارتي -لا جاري- لكي أنظر إلى الواقع العربي.
تعودت منذ عام بالضبط، عندما قررت كرهًا أن أتخفف من كل أعمالى المهنية التي تتطلب مني الالتزام بدوام كامل، أن أصحو فجرًا أقضي بضع ساعات كل يوم بمقهى في حي المنيرة، أقرأ أو أتأمل، ثم أمشي، أذرع الأرصفة حتى تكل قدماي، أتفرج على الكتب الجديدة عند باعة الصحف، أشترى ما تيسر منها ومن المجلات الثقافية، ثم أعود إلى منزلي، أهدر ما تبقى من ساعات في مراقبة المارة من شرفتي المطلة على معهد تعليمي يركض بداخله الطلاب وراء بعضهم البعض ويتحرشون بزميلاتهم علنا بنزق شبابي، ثم أقرأ أو أشاهد فيلمًا قبل النوم عند العاشرة مساءً.
اعتذرت عن كل المقابلات وتحججت بالسفر أحيانًا، أو بالانشغال بكتابة نص أدبي جديد، وبالفعل نشرت مجموعتي القصصية الأخيرة منتصف 2019، حتى ظن أصدقائي أنني نقلت محل إقامتي، لم أعاود التواصل مع الناس إلا بداية عام 2020، قابلت أصدقائي؛ الشاعر مرتين، والروائي أربع مرات، منهم واحدة مع صديق ثان عزيز، وأخرى مع شاعر، والتقيت صديقًا صحفيًّا مرة واحدة. قررت أن الوحدة ستفتك بروحي لذا عليَّ النزول للعمل، وقد أنجزت في عام من البطالة الاختيارية ما وددته من الغوص في أعماق روحي لاكتشاف بواطنها ومراجعة أفكار قديمة ورؤى إشكالية في عالم يحفل بالقمامة كما يقول شاعري صلاح عبد الصبور، في تلك الأثناء وقعت جائحة كورونا.
الوباء عنى لي أنه لا مقاهي ولا أصدقاء ينقذونني من الوحدة، وقد صار حظر التجوال يبدأ في الخامسة عصرًا، لذا كان عليَّ البحث عن مكان مناسب أقضى فيه ساعات للقراءة دون مطاردة من الشرطة، بحثت وبحثت حتى عثرت على مكان في شارع قصر العيني، لا هو مقهى ولا ناد ولا مكان ترفيه، شيء متقشف وملتبس، ربما لذلك غفلت الحكومة عنه، وظل مفتوحًا يستقبل رواده الفقراء في الغالب من الثامنة صباحًا حتى آخر ساعات الليل، تصادقت مع العامل المهذب في المكان وهو حاصل على ليسانس حقوق من جامعة أسيوط، حتى إنه صار يهاتفني عندما أغيب.
أخبرت أحد أصدقائي عن مكاني السري واستقبلته هناك عدة مرات، وفي إحداها عند نحو العاشرة مساءً، سمعنا صوتًا عاليًا ومنظمًا لمجموعة من البشر ولم نستطع تفسير الهتاف، كنا نتحدث أصلاً بسخرية عن مثالية أوقات الأوبئة والحظر لإمكانية حدوث انقلاب من داخل النخبة الحاكمة، على الفور اعتقدنا -صديقى وأنا- أن التهريج تحول إلى واقع، وتظاهرة تتقدم تجاه البرلمان، قفزنا من مقاعدنا وركضنا إلى الخارج، عند البوابة وجدت صديقى العامل يفرد ذراعيه ليمنعنا من الخروج ويضحك بشدة، فهم أننا ظننا أنها تظاهرة، لكنها لم تكن كذلك، أخبرنا ولم يفارقه الضحك أن كتيبة صاعقة مهمتها حراسة المباني المهمة حولنا وتعسكر خلفنا مباشرة، وأنها تتدرب يوميًّا في هذا التوقيت، لم يحبط صديقي، ابتسم وجر قدميه ناحية طاولتنا وهتف بسخرية ضد الوباء.
لا أعد نفسي ضمن الانطوائيين، ليس خجلاً من ذلك، بل لأنني أرى أن منهم عمالقة في الأدب والفن، وهما طريقان أحاول من خمسة عشر عامًا أن يكون لي فيهما شارة أو علامة. هؤلاء الانطوائيون الواحد منهم “طاف بمدن العشق السبع وما زلنا نحن في منعطف جادة واحدة”، كما يقول جلال الدين الرومي عن فريد الدين العطار، فيما يراني آخرون كذلك؛ بدائي وغريب الأطوار، أتلعثم حينما يجب عليَّ الكلام وأسهب عندما يكون الصمت تاج الفصحاء، أعيش في أزمنة غابرة، حين كان البط يسبح بجوار التماسيح، والخراف تثغو قرب الذئاب، والرواة يحكون للمحرومين حكايات مسلية قبل النوم، والنسوة الجميلات يمنحن أنفسهن للشعراء الرُحل لقاء قصيدة، حين كان الحكام أبرياء كالأطفال، واليأس صديقًا للأمل، والحانات تفتح أبوابها للمشردين، حين كانت بائعات الهوى أسفل أعمدة الإنارة أكثر رومانسية من أخواتهن في مواقع المواعدة اللعينة الممتلئة بقلوب حمراء زاهية لكنها تخلو من الألفة والحب، والجند أقل رعونة في الأكمنة المنتشرة مثل الفقر في ربوع البلاد، وكنت أنا -الأعزل إلا من يقيني بالناس- أحب العالم أكثر من الآن.
قضيت جل وقتي أراقب شوارع مفعمة بالحياة تذبل كوردة عطشى مثل قصر العيني، أفكر وينفطر قلبي على عزوتي يد الطبقة الماجدة، الشغيلة على باب الله -الفقراء كفراشات- وأرزاقهم الضنينة في هذا الوقت العصيب، أفكر كيف تعامل چورچ سانتيانا صاحب الفلسفة الآسرة عن الجمال في عالم يجتاحه الخوف من الفناء في أثناء معاصرته وباء الطاعون أو الإنفلونزا الإسبانية، أغضب كثيرًا عندما أتذكر كيف جرى تحويل إبداعات ذئب مستوحد يعوي بشراسة ضد الرأسمالية مثل چورچ أورويل في “تحيا نبتة الصبار” أو “متشردًا في باريس ولندن” وغيرهما، إلى بوق دعائي فج في أيام الحرب الباردة، وخيبة أملي المفجعة في نصه المتأخر مزرعة الحيوانات. عقلي مزدحم للغاية، أحاول الكتابة، أقرر أن أكتب عن أمر ما، لكنني أنجرف دون إرادة مني إلى موضوع آخر، ربما لأنني عندما أكتب تقوم ذات أخرى بالفعل نيابة عن ذاتي الظاهرة كما يقول إدوارد سعيد.