في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
توافد المدعوون والمدعوات من عِليه القوم على قصر شفيقة لحضور حفلة الزار التي اعتادت أن تقيمها بين الحين والحين، وكان الصاعد إلى السرادق الذي أقيم على سطح الفيلا يرى كرسي الزار وقد وضع على صينية ضخمة مستدير صفت على أطرافها أواني الزهور وصحاف تحمل الوانًا مختلفة من الطعام والحلوى والفاكهة، وزجاجات الشمبانيا والويسكي وغيرهما من الشراب الفاخر. الخدم في ملابسهم المزركشة يحملون الهدايا الثمينة من كبار المدعون والمدعوات ويضعونها على مائدة أعدت لذلك. المدعوون يشربون ويضحكون وقد انتظموا شللًا.. كل شلة في ركن وبدأت الزفة وكانت شفيقة هي عروس الزار. ودارت الزفة حول كرسى الزار وانهالت عليها الجنيهات الذهبية التي تناثرت كالمطر!
وفي نهاية الزفة ظهر سيد درويش الذي لم يكن تفوته أية مناسبة سعيدة من مناسبات شفيقة. كان حريصًا على حضور هذه المناسبات بنفسه، وصافحته شفيقة فقبلها على وجنتيها قبلتين، ثم انتحى بها جانبا وأخذ يبثها حبه وغرامه، فقد خشي أن يكون قلبها قد تعلق بحب هذا الشاب الذي رآه معها لأول مرة، وقال سيد إنه لم يعد يستطيع أن يتذوق طعم الحياة بدونها، فقالت له شفيقة أنهما– هي وهو – لا يساويان شيئًا بلا معجبين!
وأنها في ظرف يجعلها لا تملك أن تكون له وحده، وأبدت رغبتها في أن يظلا صديقين حميمين!
وظهر أحمد!
فاستأذنت من الشيخ سيد في أدب، وجرت إلى معبودها تستقبله بالعناق والقبلات، وانزوت به في مكان بعيد عن مجتمع الحفلة، وبينما كانا يتهامسان بعبارات الحب والشوق ولوعة الفراق الذي لم يكن يزيد على بضع ساعات، إذ سمعت صوت أخد الخدم وهو يمنع شخصًا من الصعود إلى السطح، فحارت ماذا تفعل، ولكن أحمد أذن لها في أن ترى ما حدث، وأطلت من أعلى السلم فرأت مارد شارع نخلة ببذلته الصفراء الكالحة وطربوشه الغارق في الزيت وحذائه الأسود الثقيل القذر وهو يحاول الصعود بالقوة والخدم يمنعونه، فنزلت وأمرت الخدم بأن يتركوه. ودخلت الشقة وأشارت له بأن يتبعها فتبعها، وتعجب الخدم وأخذوا ينظرون إلى بعضهم البعض في دهشة ويتساءلون في صمت ترى من يكون هذا الرجل؟
ونظر إليهم إبراهيم وهو يدخل في أثر سيدة البيت، نظرة تحمل معنى التشفي والانتصار!





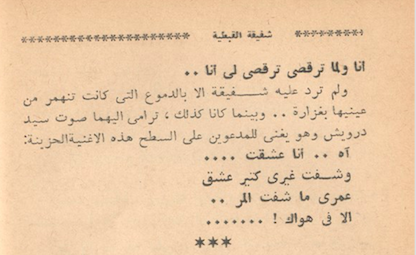

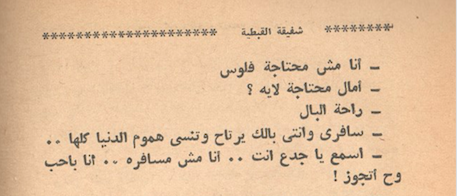 المجد
المجد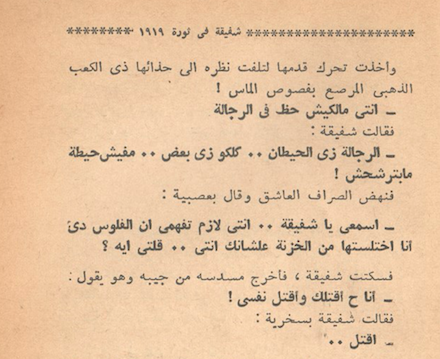
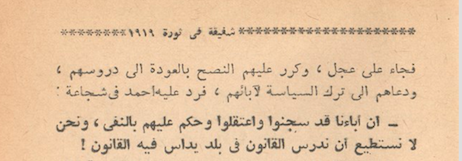 وكان
وكان




