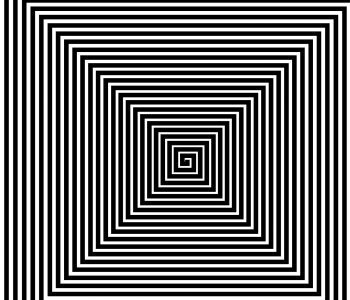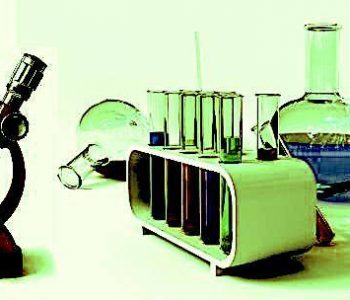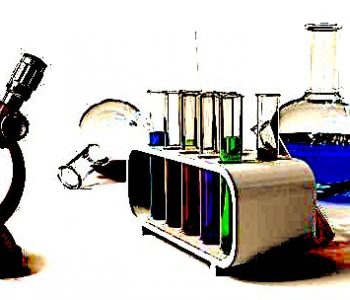في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
لم أحص على وجه الدقة كم مرة زارتني، لكنني كنت أتعجب من حرصها على التبرج، ووضع الروج، على الرغم من ارتدائها تلك البذلة الطبية الواقية الخضراء، التي جعلتها لرواد الفضاء أقرب من كونها ضمن أطقم التوصيل والدليفري المختصين بتوصيل الطعام للمعزولين والمحجورين قسرًا أمثالي.
كنا في الأسبوع الخامس والثلاثين بعد المائة لتفشي الوباء.. لم تعد مناسبات عديدة تُذكر، أو حتى نهتم بالاحتفال بها، فقط كنت أعرف أعداد الأسابيع من الخطوط المائلة التي كنت أرسمها على الحائط، وكلما بلغ عددها خمس أسابيع كنت أرسم خطًا أفقيًّا على الخطوط المائلة يقطعها ويشكل معها شكل الحزمة.
قُضى على أنفس كثيرة، الشوارع خلف نافذتي ميتة كالقبور، الجنازات انقطعت من فترة، بعدما لم يجد الميتون من يدفنونهم، كانت روائح الموت تنبعث من النوافذ والشرفات التي لطالما انبعث منها الغناء والضجيج وأغاني المهرجانات، الشاب الذي كان منذ أشهر يغني بحس مرتفع من شرفته:
- بهوايا.. أنتي قاعدة معايا.. عينيكي ليا مراية..
سكت حسه إلى الأبد، كنت في البداية أعرف أنباء الموت، من النواح والنائحات اللاتي يرفعن أصواتهن به، الصويت والصراخ، والبكاء، البلكونات التي لطالما وقف فيها المعزولون والمحجورون يغنون منها، ويتبادلون الأخبار، خرست إلى الأبد، قنوات التليفزيون انقطع بثها، عربات متروكة مفتوحة في الشوارع، وأنوارها ظلت مضاءة حتى نفدت بطاريتها وماتت هي الأخرى، الحيوانات المتوحشة انتشرت في الشوارع، وباتت الآن تعرف كيف تشبع بطونها التي خوت في الأسابيع الأولى من التفشي، بعدما انقطع الناس عن النزول وانخفضت فضلاتهم، زاد سُعارها بعدما كانت تنبح طوال الليل بحثا عمن يرمي لها أطعمة، الآن تحولت حيوانات الشوارع الضالة إلى وحوش، تدخل البيوت وتعثر بنفسها على طعامها من جثث الناس الذين جرفهم الوباء بمنجله، كنت أسمع أصوات التهام متواصلة وتناحر بين الكلاب على مأدبة جثث جيراني، من شدة الرعب بت أراكم الأثاث خلف بابي، بعدما سمعت خربشات أظافر هذه الوحوش لخشبه.
النزول من المنزل قبل العزل وبعد فرض حظر التجوال، بات ممنوعًا الآن بحكم انتشار الحيوانات المفترسة والوحوش التي تلتهم الجثث في الشقق التي باتت أشبه بالجبانات.
تجوب الوحوش السعرانة الشقق، وتعود إلى الشوارع بأجزاء من أيدي وأرجل وأبدان، على مرأى ومسمع من القوة المتوقفة من رجال الجيش المقنعين بالخوذات الطبية، والمدافع الكهربائية التي بوسعها أن تجندل المخالفين للتعليمات، آخر مشهد رأيته كان بعض هؤلاء رجال الجيش وهم يحملون جثامين مسجاة في نعوش ويهبطون بها من العمارة المقابلة، وسط صمت تام، كصحراء ابتلعتنا جميعًا.
طرقت بابي في ذلك الأسبوع، وكنت أنتظر رجلاً من رجال الجيش. في الأسابيع الأولى من الوباء، كان رجال الجيش يفوتون ويطرقون كل الأبواب، ويمنحون سكان العمارة والعمارات المجاورة علبًا من الكارتون تحوي أكياس سكر وأرز ودقيق وعيش بلدي ومكرونة وعلب تونة، وعلب لحم معبأ، وبلوبيف، وكبريت، وصابون، وملح وزيت.
أحيانا كانوا يُدخلون على هذا التموين تعديلات في المكونات، كأن يضيفوا عليه ثمرات برتقالة وتفاحة وأصبعي موز، لكل فرد من أفراد الشقة، ثم حينما بدأ الأموات يتزايدون، مع استشراء الوباء، ضاعفوا هذه الكميات، الغالب أنه كلما مات شخص، حصل حيُ من الأحياء على نصيبه، وهكذا صار للموت ميزة بعدما كان أمرًا مرعبًا.
ثم تغير نظام الإمداد بالغذاء بعد مرور أربعة أشهر من انتشار الوباء.. وسقوط المزيد والمزيد من الأموات. خرج رئيس الحكومة الذي كان قد سبق وأعلن أن الدولة لديها ما يكفيها من مخزون يساعدها على تحمل ومواجهة الوباء لأشهر طويلة، خرج معلنًا بكل أسف وفاة العديد من عمال مصانع الغذاء، وتوقف هذه المصانع عن العمل، كما أعلن عن توقف الأراضي الزراعية عن الطرح، بعدما تحور الفايروس الذي كان يصيب رئات الناس، ليستشري بين البذور، مفتتًا قدرتها على النمو والإثمار، ماتت محاصيل، وجفت عروق أراض بغتة، كأن الوباء اتحد مع الجراد.
راقب الآلاف مثلي من منازلهم، وجه رئيس الحكومة الذي نكسه أرضًا بينما يلقي خطابه، غالبًا كان يخفي علامات الطفح الجلدي المستشرية في وجهه، عجز عن أن يخبيء نبأ موته، خرج لينبئنا من بين سطور حديثه بأن علينا أن نتدبر أمورنا.. وأنه منذ هذه اللحظة.. لم تعد هناك موارد.
غادرنا منازلنا بعد الخطاب، تدفقنا في حشود تعاون الوباء على التفشي على محلات السوبرماركت، الأموال لم يعد لها قيمة، الأرفف خالية، وبعض المحلات نهبها رجال مسلحين بالهراوات، بينما البعض الآخر تدبر بسرعة التسليح بالاستعانة بعصي، وبنادق منزلية الصنع، كل من كان محظوظًا بإرث تضمن بندقية جده، حولها إلى مدفع بوسعه إطلاق الرصاص والخراطيش القاتلة، أشهر سلاسل المحلات بمنطقتنا لم يحمها قربها من مديرية الأمن، اقتحمها ملثمون ومقنعون، يرتدون ماسكات طبية وأقنعة تعصب وجوههم إلا أعينهم، لم يستهدفوا أدراج “الكاشير” في هذه السوبرماركات، بل استهدفوا أجولة الأرز والسكر والمكرونة والدقيق وكراتين البيض والزيت.
عدت خائب الرجاء والسعي إلى بيتي متفاديًا الفوضى والبلطجية، محاولاً قدر الإمكان ألا أتورط في أي معركة، وأن أنجو من أي ضربة هراوة صادقة، عدت في الوقت المناسب، إذ فُرض الأمن بالقوة، انتشر رجال الجيش في الشوارع، يرتدون بذلات رواد الفضاء، وأسفل منها لا بد الدروع المقاومة للرصاص، يتبادلون إطلاق النيران مع ميليشيات البقالة المسلحة تسليحًا عشوائيًّا وخطيرًا، أصوات الرصاص تزلزل النهار، وتسقط أشعة الشمس من السماء، فما بالكم بنا، نحن القابعين خلف النوافذ نسمع تراشق الرصاص بينما ينفجر في الهواء، ثم حينما تهدأ الأصوات وتسكت، نلمح الجنود المرتدين الخوذات، بينما يرشون الجثث بالسوائل المطهرة، كانت المعارك في أغلب مواقعها محسومة بالطبع لصالح رواد الفضاء، بما يمتلكون من نيران رصاصها معقم ومرشوش بالكلور والكحول الإثيلي بدرجة تركيز 70%، تبودل إطلاق النار على نطاق واسع، انتشرت طائرات الهليوكوبتر في السماوات، بينما في الأرض كانت النيران تستشرى في العربات المفحمة، وأجولة الأرز والمكرونة المستولى عليها من العصابات التي اقتحمت “كارفور” و“هايبر“. روائح البارود تنبعث من أجساد الخارجين عن القانون الذين حاولوا فرض قانونهم، انتشرت جثث في الشوارع، ولم تجد الغربان أحدا لتعلمه طرائق دفن الجيف.
كان بمقدوري رؤية الجثث المتناثرة المتخلفة عن المعركة من شرفتي، من خلف الشيش، إذ لم أعد أخطو في البلكونة منذ أن اخترقت إحدى حيطانها رصاصة طائشة ضلت طريقها من رصاص متطاير في معركة جرت في الشارع الرئيسي، كان طرفا المعركة بالطبع رجال الجيش وعصابات السوبرماركات، وميليشيات البقالة، شاهدت هؤلاء وهم يتراجعون في الشارع محاصرين ويطلقون الرصاص بعشوائية مرعبة، بينما رواد الفضاء يحملون الأسلحة المتطورة الطنانة، يقتحمون مدخل الشارع ويمطرونهم بالرصاص المسكوب سكبًا، رصاصة من هذا الرصاص المنهمر كخيوط الضوء اقتحمت جدار بلوكنتي وصنعت فيه ندبة غائرة، ولم ينزف الجدار.
أحكم الأمن قبضته، عاد الهدوء المقبر إلى الشوارع، خرست تماما الفوضى، انتهت بالطبع المغامرات، ونفد كل الأدرينالين من جسدي، ليال ظللت أتخيل أن أحد أفراد ميليشيا السوبرماركات سيقتحم علينا الشقق، ويجبرني على إطعامه أي شيء، طبق محشي، حلة مكرونة، أو ربما علبة جبن رومي.
عادت مواكب الجنازات المؤلفة من أربعة أشخاص يحملون النعش، تحت حراسة رجال الجيش المقنعين بالملابس العازلة الفضفاضة، كان يجري تعبئة الجثث في أكياس قمامة سوداء، ثم تُرص في الشوارع أمام البنايات، أحصيت مائة جثة جُلبت من العمارة المقابلة، جاءت جرافات، وكسحت هذه الجثث كأنها شكائر رمل، ورفعتها بروافعها وألقتها في ناقلة قمامة عملاقة، تحول الناس إلى أكياس قمامة يجب التخلص منها، سمعت أحدهم يخبط على باب السائق ليجعله ينطلق، صائحًا فيه:
على المحرقة.
تدفقت العربات المدرعة ومركبات مكتوب عليها “الحرب الكيماوية“، عزل رجالها الأحياء عن بعضها البعض، أقيمت المتاريس، طُهرت أبواب البيوت، يبدو أن الجبانات امتلأت عن آخرها، لأن بعد أسابيع كان الرجال المدججين بأنابيب أسطوانية عملاقة معلقة على ظهورهم يذرعون الشوارع ويصعدون إلى البيوت، ويغلقون أبوابها على أهلها الذين قضوا نحبهم داخلها، ليتعفنوا إلى الأبد دون أن تلتهمهم الوحوش السعرانة، ويرشون أبوابنا بسوائل ظنناها أول الأمر ستقضي على روائح العفونة المتصاعدة، وعلى كل الأحياء الباقين في شقق أخرى، ثم فوجئت بانقطاع مواء القطط ونباح الكلاب، حينما غامرت بالخروج ذات مرة من باب الشقة وسرت في الطرقات الممتدة بين شقتي وبين شقق جيراني، حتى الطوابق السفلى، فوجئت بجثث القطط والكلاب متراصة في كل أرجائها، لقد قضى الكيميائيون المقنعون على الحيوانات الضالة.. قضوا على الوحوش التي كانت تلتهم أجساد المتوفين.
بدأ أحدهم يطرق بابي ليواصل جلب التموين، فوجئت أنهم يمنحون الجميع علبة تحوي مكرونة مسلوقة وقطعة لحم صغيرة وشوكة مغلفة، وكمامة، حينما وزنت قطعة اللحم فوجئت أنها نحو خمسين جرامًا.. فقط خمسين.
قلت مدهوشًا متوقعًا معاملة صلفة:
فين السكر.. فين الشاي.. فين الزيت.. فين الرز.. فين الخضار.. فين التفاحاية والبرتقانية؟
لم يعلق الرجل على أسئلتي المتلاحقة، فقط جذب باب شقتي إليه، ليغلقه عليَّ، انعكس فعل الطرد ليصبح فعلاً عكسيًّا، صرت أنا المطرود داخل شقتي، وصار من هو خارجها يطردني.
بدأت أدخر قطع اللحم الصغيرة، وأكتفي فقط بأكل المكرونة المسلوقة، لم يكن الطعام يشبعني، ولم يكن لدي مال لأشتري أي شيء، أو حتى أبادله مع أحد بالطعام، لم يعد هناك أحد، لكن في الصباح التالي لم يكن هو من جلب لي عُلبة المكرونة، كانت “حُكيازادة“.. وهذا هو الاسم الذي اخترته لأطلقه عليها.
كانت ترتدي بذلة العزل الواقية، وخوذة بلاستيكية مزودة بخرطوم لولبي يساعدها على التنفس بعمق من أكسجين نقي مفلتر لا يحمل ذرات الوباء، يأتيها من أنبوبة معلقة على ظهرها، بينما قاعدة الخوذة متصلة بقمة البذلة لتعزل أية نسمة هواء وتصدها عن النفاذ إلى ما تحت الخوذة، جاءت تطرق بابي، وتمنحني علبة المكرونة المسلوقة، التي تحوي قطعة اللحم الصغيرة، وقبل أن تمشي، لمحت من باب شقتي مكتبتي الشاهقة، العامرة بالمجلدت وكعوب الكتب القديمة، والعتيقة، قالت لي وهي مترددة بين أن تطيل المكوث لدى بابي، وبين التأخر في توزيع باقي عُلب الطعام:
عندك مكتبة كبيرة.. من زمان ما شفتش كتب في أي مكان.. يا بختك!
وقبل أن أعقب على ما قالت، كانت قد اختفت.
ظلت كلمتها الأخيرة ترن في أذني..”يا بختك!”.. ما نفع الكتب في زمن الطاعون؟ نظرت للمرة الأولى إلى مكتبتي، ووضعت علبة الطعام جانبًا، كان الغبار قد استشرى في المكتبة، وغطى كعوب الكتب، وأتى تقريبًا على كل الأركان، تذكرت أنني قد أهملت القراءة منذ أن بدأ الوباء، قلت لما لا، ربما تكون المنجية، وذهبت إلى مطبخي، وجلبت قماش قديم، وبللته بالماء، ثم عصرته، وبدأت أزيح الغبار عن الأركان، وعن الكتب، بدأت أتناول بعضها، وأمسحه مسحًا رقيقًا ناعمًا، كأنني أضع على جبهات هذه الكتب كمادات تمحو عنها ما حاق بها من أدران من جراء الغبار.
لم أستطع أن أندمج في القراءة تمامًا، إلا أنه مع حلول الليل حدث ما لم يكن في الحُسبان.
دق بابي..
كانت “حُكيازادة“..
جاءت ترتدي تنورة فضفاضة، وقميصًا شتويًّا وبلوفر، وتترك شعرها ينسدل على كتفيها في حرية، وضعت أحمر شفاه كان ظاهرًا من خلف الكمامة البيضاء التي بدت شفافة، وبودرة منحت لخديها لمعانًا خفيفًا، ورسمت عينيها بكحل أسود جعلها فاتنة ومثيرة، مكياجها بدا كأنها ذاهبة لحفل في الأوبرا، كانت من الأناقة بحيث خطفت قلبي مباشرة، وتربعت فيه بكامل كيانها، وكيف لا أعجب بزهرة متفتحة وسط المقابر؟ كانت تمسك في يديها ثلاث عُلب طعام، تحوي الأصناف نفسها، وكان بيديها زجاجة كحول إيثيلي، وزجاجة واين أحمر، من أين جلبت الواين، لم يبرح السؤال عقلي، فتحت الباب على مصراعيه مدهوشا، فمرت، وضعت الأشياء على أقرب ترابيزة، ووقفت في مواجهة المكتبة، هُيء لي الآن، أن العالم بدأ خلقه هكذا.. رجل وامرأة.. وكتب كثيرة.. ولا أحد سوى ذلك.
خلعت حذاءها وسارت حافية حرة إلى المكتبة، ووقفت أمامها وبحثت بسرعة وبفضول، قبل أن تفرد ذراعها على قدر استطاعتها وتشب واقفة على أطراف أنامل أصابع قدميها، لتلتقط بأصابع طويلة معتنى بأظافرها وملونة بلون أحمر قانٍ مثير، مجلدًا ضخمًا، عتيقًا، أوراقه شديدة الاصفرار، وإن ظلت قوية كصفحات من الكارتون، تذكرت هذا المجلد، كنت في رحلة إلى إيران، وابتعته من هناك، بعدما فوجئت أنه نسخة باللغة العربية من المؤلف الأشهر حول العالم، ألف ليلة وليلة، التفتت إليَّ بابتسامة ظافرة، واتجهت نحو بساط الصالة المصنوع من الكليم، وجلست متربعة، فرشت تنورتها حولها، ووضعت خلف ظهرها وسادة مخملية من وسائد الأنتريه الكبيرة، وفتحت صفحات المجلد، وبدأت تحكي قائلة:
«بلغني أيها الفتى المحجور..
في زمن الطاعون الملعون..
أنه عثر راع ذات يوم على قفص مليء بالجواهر والياقوت.
فترك غنمه يشرد منه ويهرب في الكلأ، ومضى بالقفص، مغادرا المرعى بأقصى ما واتاه من قوة وسرعة، لكنه صادف خلال عدوه فتاة صبية، فاتنة محبوكة الخلقة، دعته إلى أن يترك القفص المملوء بالجواهر، ووعدته بمكافأة أجمل منه، ظل الراعي مترددًا، أيختار الصبية، ويترك الجواهر، أيختار الفتنة ويهجر الدعة والثراء؟ فترك القفص، وتبع الصبية.
إلى أن أتى دارا مليحة..
قدامها رحبة فسيحة..
وهي عالية البنيان..
مشيدة الأركان..
بابها بشفتين من الأبنوس، مصفح بصفائح الذهب الأحمر، فوقفت الصبية على الباب، ودقت دقًّا لطيفًا، وفتحت الباب صبية رشيقة القد قاعدة النهد ذات حسن وجمال وجبين كغرة الهلال، وعيون كعيون الغزلان، وحواجب كهلال رمضان، وخدود مثل شقائق النعمان، وفم كخاتم سليمان، ووجه كالبدر في الإشراق وبطن مطوي تحت الثياب كطي السجل للكتاب».
قطعت القراءة وظلت ترمقني في وقفتي المشدوهة المشدودة، كنت لم أزل متسمرًا لا أصدق ما يجري، وما تفعله، رفعت ذراعها الأيسر عن الكتاب وأشارت لي بأصابعها الرقيقة أن أجيء وأجلس بجوارها، فتحركت مشدوها كبطل القصة التي تقرأها، وتوسدت الأرض بجانبها، ألصقت جسدي بجسدها متعمدًا فلم تنفر مني أو تبتعد، بل عادت لتقرأ.
«فلما نظر إليها الراعي، قال: ما رأيت عمري أبرك من هذا النهار؟ وقادته الصبية إلى قاعة يتوسطها سرير من المرمر، مرصع بالدر والجوهر، وإلى يمينه حوض استحمام، تتصاعد من مائه الأبخرة والدخان، وقامت فتجردت من ملابسها، وصارت عريانة، ولعبت في الماء، وغسلت أعضائها وقفزت كما هي في حجر الراعي، وأشارت إلى فرجها وقالت له: ما اسم هذا ؟ فقال: فرجك، فضربته على مؤخرة عنقه قائلة: بل حبق الجسور.
وجاءت صديقتها ففعلت نفس فعلتها، ورمت نفسها في حجر الراعي، وقالت له وهي تشير على فرجها: ما اسم هذا يا نور عيني؟ فقال: حبق الجسور، فقالت: بل السمسم المقشور.
وبرزت فجأة صديقة ثالثة جاءت من غرفة محجوبة من غرف الدار، وفعلت فعلة السابقتين، وسألته السؤال نفسه، فقال: السمسم المقشور، فقالت: بل خان أبي منصور.
وفعل الراعي نفس فعلتهن، تجرد من ملابسه وألقى نفسه بين أحضانهن، وسألهن عن اسم ذكره، فاحترن في الإجابة، وقد أدركن وتيرة اللعبة الملغزة، فقال لهن مبتسمًا في ظفر: البغل الجسور، الذي يرعى حبق الجسور، ويلعق السمسم المقشور، ويبيت في خان أبي منصور».
فلما انتهت من حكايتها وجدت نفسي أعانقها، وفعلنا مثلما قال الراعي.
ولما أصبح الصباح، وأضاء بنوره ولاح، كنا قد فعلناها أكثر من مرة. كانت “حكيازادة” عذراء، بكت قليلاً بعد المرة الأولى، ثم دخلت فتحممت، ودخلت عليها عاريًا، وفعلناها مرة أخرى أسفل الماء الساخن اللاهب، الذي أوصت به منظمة الصحة العالمية لمقاومة الوباء، وعدنا لتناول علبتي مكرونة باللحم القليل الضئيل، ثم قالت لي:
لازم أمشي..هرجع بالليل.
أنا لسه معرفش اسمك إيه..
سميني حكاية..أو “قصتي“..
ونهضت ترتدي ملابسها، وتأملت للمرة المائة جسمها ممشوق القوام البض المثير، وانتبهت على استثارتي، ونهوض شيئي، فهببت من مكمني، وتوجهت أعانقها، فابتسمت ابتسامة مغرية وهي تقاومني باسترخاء:
لازم أمشي.. شيفت توزيع الأكل هيبدأ.. ولسه هروح وأتعقم.. ويقيسوا حرارتي، قبل ما ألبس بذلة التعقيم..
لكنني لم أرد بكلمة، بل بقبلة، قبلة طويلة، وسحبتها إلى فراشي، وفعلناها مرة أو مرتين، قبل أن تنتزع نفسها من فراشي انتزاعها، وتغادر.
بعد رحيلها كانت زجاجة الواين الأحمر مغلقة لم تزل لم تمس، فتذكرت أن ما جرى بالتأكيد ليس حُلما، وإلا من جلب هذه الزجاجة هنا، وذهبت أبحث في مطبخي عن وسيلة تعينني على فتح الزجاجة، دون دفس سداداتها المطاطية داخل الزجاجة، ولما لم أجد شيئًا كمسمار قلاووظ، أو سكين مدبب ذو نصل مشرشر، استسلمت وتركت الزجاجة، فإذا بـ“حُكيازادة” تطرق بابي، في اللحظة التي قررت فيها الاستسلام، لتناولني علبة المكرونة ذات قطعة اللحم زنة الخمسين جرامًا، ثم فجأة وجدتها تناولني فتاحة زجاجات الواين، ذات الذراعين الأشبه بجناحين، والعمود المشرشر مدبب البوز المتدلي بينهما، ثم غمزت لي من خلف خوذتها قائلة:
متشربش وحدك.
لا أدري كيف مرت عليَّ ساعات النهار؟ كنت للمرة الأولى أنتظر زائرًا، لأول مرة منذ أسابيع أنتظر حدثًا يبدد غبشة الضجر وظلمة الفراغ، حدثًا سعيدًا بدلاً من الخوف من صوت الرصاص المتطاير وهجمات الوحوش على أبواب البيوت، وانقضاض الخارجين على القانون على الشقق لسرقتها من بقايا أصحابها الذين تحولوا إلى جثث متحللة.
في المساء جاءت مرتدية فستانًا، أطلقت شعرها لينسدل على كتفيها، لم تكن ترتدي كمامة، تدلى من أذنيها قرطان ذهبيان، شفتاها بدتا لامعتين بعدما طلتهما بروج أحمر قانٍ كلون أظافر أصابعها، كان ينبعث منها رائحة عطر شديدة القوة، لفت رأسي فورًا، بعدما هبَّ عليَّ عبيره، كان الممر المؤدي إلى شقتي مظلمًا تقريبًا، فبدت فيه كلوحة فسفورية شكلتها النجوم، قالت وهي تدلف وتغلق الباب:
متركزش كتير في الممر..
قبل أن اسألها عن السبب، كانت قد عانقتني، وطبعت قبلة على خدي الأيمن، ثم تحسست ذقني النابتة، وطبعت قبلة ثانية على شفتي، ثم ألقت بحقيبتها جانبًا، وخلعت حذاءها، ورشته من زجاجة أخرجتها من حقيبتها بسائل مطهر، ثم أخرجت في حرص تلاث عُلب من المكرونة المسلوقة، واللحم زنة الخمسين جرامًا، ومضت من فورها إلى المكتبة، وجلبت مجلدًا آخر غير الذي كنا نقرأ فيه أمس، وذهبت إلى موضعها المفضل في صالة شقتي، ثم بدأت تقرأ:
«وفي شهر رمضان تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية، وهجم جملة واحدة، وعظم أمره جدًا، حتى صار يخرج من القاهرة كل يوم نحو عشرين ألف جنازة، وقد ضُبط في مدة شهر رمضان وشعبان من مات في هذا الطاعون فكان نحوًا من تسعمائة ألف إنسان، من رجال ونساء، وكبار وصغار، وجوار وعبيد، ولم يسمع بمثل هذا الطاعون فيما تقدم من الطواعين المشهورة إلا الطاعون الجارف، الذي عجز فيه الناس عن دفن موتاهم، فكانت الوحوش تدخل إلى البيوت، وتأكل من لحوم الموتى، وكان الناس يسدون على الأموات باب الدور، حتى لا تدخل إليهم الوحوش، إلا وحش، دخل إلى بيت فوجد فيه طفل ملقى على ظهره، فأرضعه الوحش، فأتلف إليه الطفل، وجعل ينتظر الوحش حتى يرضع ويمص من ثديه، فانتشى ذلك الطفل وكبر وصار غلاما، وطلعت له لحية، فصار معروفا بالغلام الملتحي، وغادر بيته إلى المدينة، فوجدها صامتة إلا منه، فبدأ يؤسس فيها ما يرغب من تأسيسه، بدأ يحوذ بعض من أشياء الناس ويجمعها، ويبدو أنه عثر ذات مرة على رسوم تشرح طريقة التزاوج بين الرجل والمرأة، فطبقها على الوحش الذي أرضعه، فإذا بالمدينة تشهد نوعًا جديدًا من المخلوقات، أطفال يسيرون على أربع، ولهم لحية، عراة لم يتوصلوا بعد لطريقة خياطة الملابس، ولا لضرورة ارتدائها، إذ نبت لهم ريش، كفاهم البرد وبرودة الفجر، وندى الصباح، وبدا الغلام الأول، والد هؤلاء الأطفال، مزهوًا بما أنجب في المدينة من وحوش صغيرة، لكن لم يعكر صفوه إلا سؤال ظل يتردد عليه: ماذا لو ظهر فجأة البشر.. وقرروا له ولذريته الفناء؟ كيف يتصرف وأين يهرب».
ظللت مبهوتًا مشدوهًا، متأملاً الحكاية التي اختارتها، متسائلاً عن أسباب جنوحها لحكي حكاية كئيبة ومحزنة كتلك، ألا يكفينا ما نحن فيه من رعب وخوف، فقالت، وهي تشير لي بذراعها الممدودة تجاهي وأصابعها المتراقصة الداعية لأقترب:
الحكايات وحدها تقدر تنسينا الرعب.. حتى لو كانت حكايات مرعبة..
فاقتربت وجلست، فإذا بها تخلع فستانها، وإذا بها عارية تمامًا لا ترتدي أي ملابس تحته، وغبنا في قبلة طويلة ثم تمددنا، وهي تخلع عني ملابسي بلهفة، وبينما نفعلها، فوجئت بشفتيها تهمسان في أذني:
في الأسبوع الخامس والثلاثين بعد المائة، وبعدما كانت المدينة قد أوشكت على الفناء، خرج حبيبان من كهفهما، وفي أيديهما عشرات الأطفال، وأطلقوهم في الشوارع الخالية من الأحياء، والممتلئة بالرمم والجثث، نصح أبوهم أن يأكلوا من كل شيء، إلا من الشجرة التي تحوي ثمارًا حمراء متدلية، فانطلق الأطفال ينتزعون قطعًا من الأبدان الملقاة في الشوارع، ويضعونها على أحجار، ثم يشعلون فيها النار، حتى إذا تصاعدت روائح الشواء، أدرك الأطفال أن لحوم الجثث قد نضجت، فشرعوا يأكلونها، وعند الكهف، وقف الحبيبان ينتظران أبناءهم، لقد كان هذا فجر يوم جديد.. فجر يوم لم تشهده المدينة من قبل.. يومًا دون وباء.
كان ما تقوله في أذني يستثيرني أكثر، لم يكن يرعبني، لم يخمد شهوتي، بل قلبتها على بطنها، وشرعت أضربها على وسادتيها، ثم أسقطت حملي فوق عمودها الفقري الناصع الممتليء، محيطًا خصرها بساعدي في شهوة، ثم تسارعت أصابعي متسلقة بطنها ممسكة بنهديها بينما أعضها من شحمة أذنها، كل هذا جرى بينما ضرباتي تتسارع، وجسدي يلتحم بجسدها، وفجأة جاء الانفجار الكبير.
من أين تجلب النساء هذه القوة لخبز العيش بعد ممارسة الجنس؟ ما أن منحتها ظهري، حتى فوجئت بها قد نهضت من جانبي كالعصفورة، وذهبت لتجلب لنا الطعام، أكلنا، ونمت، وحينما بزغ الصباح لم تكن “حُكيازادة” بجواري..
خرجت من باب شقتي للمرة الأولى، كان الليل يفترش الطريق، ويتمدد بظلمته في جميع أنحاء الطريق.. ويبسط عباءته على من بقي من الخلق.. جاء رجل وفي يده مصباح، بدد ظلمة الليل.. وضيَّع هيبته.. جئت وأنا أردد حكايات “حُكيازادة“.. التي قصتها عليّ في سنتين وثمانمائة أشهر.. نسيت بحكاياتها الوباء والناس.. وعدت للدنيا ووجدتني وحدي فيها.. سرت في الطرق الخالية إلا مني ومن صاحب المصباح.. وأنا أدعوها باسمها.. وصوتي يتردد صداه ولا مجيب.