في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

نأمل إذن في العثور على "مفتاح مدينة" ما لم يكن لها أبواب؟! مع ذلك نحن نعتقد أن محطات القطار تحلّ، أو هي قد حلّت بالفعل محل تلك الأبواب التي اختفت منذ وقت طويل
يكتب بيير سانسو ( Pierre Sansot (1928-2005، الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي في العام١٩٧٣ كتابا تحت عنوان “ شعرية المدينة” والغريب ان الكتاب لم يترجم الي العربية من قبل ، رغم انه يطرح اسئلة مازالت حارقة علي سكان المدن في البلاد التي تتحدث وتقرأ بالعربية … وكان هذا اكتشاف ياسر عبد اللطيف الاديب و المترجم المشغول في كتاباته بالمدينة ..وعندما تجول بين اوراق كتاب سانسو الذي كان في الاصل اطروحة دكتوراة اختار ل”مدينة” هذا النص عن “ محطةالقطار “ التي تعتبر المدخل الفضل لكل مدينة… لماذا؟ يكشف سانسو اننا نحتاج احيانا ان مع يكون للمدينة بابًا، يكون مدخلنا عند الدخول وباب وداعنا عندما نغادرها، حتى نحسَّها بيتًا ومقامًا. وهذه عواطف تشكل جزءاكبيرا من العالم النفسي و الذهني لنا نحن سكان المدن ، وهي واحدةمن اكتشافات كتاب سانسو الذي ننشر منه هذا الفصل الممتع و الكاشف.
من الذي قد يحلم بدخول المدينة مجتازًا أبوابها– ويبدو موغلًا في البعد ذاك الزمن الذي كان يتوّجب فيه على جان جاك روسو المبيت خارج جينيف لأن أبوابها قد أُغلقت – إنّه المنتصر أو السفير أو ضيف الشرف يقدّم نفسه لهذه الأبواب فيفتحونها له على مصاريعها ليتقدم في طريق النصر الضاج بالتهليل وبالفرق النحاسية والزينات. إنّه طريق تتلخص مهامه في الاعتراف تحت الضجيج بفاتح المدينة. أيام للعيد وأيام للموت! نحتفل هنا، لكننا نُعدم أعداء النظام ونشنقهم هنا أيضًا. هنا لافتات الترحيب والزينات، وأيضًا المشانق والجثث التي تتحلل تحت الشمس! هنا الوجوه المنعّمة للسياسيين والدبلوماسيين ووجهاء هذا العالم، وأيضًا جموع الأطفال والضائعين والدهماء؛ المشوار اليومي المنضبط والدقيق لمن أقاموا هنا طوال عمرهم، والمظهر المنهك لمن صارعوا الجوع والعطش والقيظ قبل أن يصلوها، وهم في واحة النوافير والنضارة تلك مندهشون من أن لا غبار هنا يهبّ. فيما يبدو أن مدينة ما ، كي تصير مسكنًا ينبغي التماسها كبيت بإلحاح، فهما إذا غابا، نفقد اللحظات الثمينة للدخول والخروج. بدون هذه الممرات المهيبة التي تفوق في قيمتها الواقع الذي تفضي إليه، تختفي المدينة بشكل ما، بما أننا لم نجتز أبدًا العتبة، التي تؤكد أننا بصدد ولوجها. وتثير الأبواب – فوق ذلك – أحلام اليقظة الدائمة بالأقفال والمزاليج والمفاتيح. وفيم نأمل إذن في العثور على “مفتاح مدينة” ما لم يكن لها أبواب؟! مع ذلك نحن نعتقد أن محطات القطار تحلّ، أو هي قد حلّت بالفعل محل تلك الأبواب التي اختفت منذ وقت طويل، وهذا ما سنحاول أن نعرضه. غير أننا لا نبحث عن تماثل في التفاصيل، لكن عن تناظر في المزايا والوظائف.

في البداية كان الوصول عبر محطة القطار يمثّل قطيعةً جدية. لا نعني فقط المرور أمام مُحصّل بوابة الخروج المهم: إذ قد يفقد المرء تذكرته، وهو ما يجرّ عليه مصاعب حقيقية – فالتذكرة التي تصدرها شركة السكك الحديدية، كانت أكثر من مجرد علامة مجردة: فلها سلطة الوثائق الرسمية، وهي وبشكل سحري دلالة على السماح باجتياز عدد معين من الكيلومترات؛ هي دعوة للسفر. ولخشونتها ولونها وحتى لرائحتها علاقة ما بعالم المقطورات وعربات الركاب وقطارات البضاعة.
لكننا نفكر في قطيعة أخرى أكثر جدية، في تلك القطارات الشعبية البطيئة، التي يأكلون ويشهقون ويزفرون ويسعلون ويتحادثون فيها دون أي حرج، لتتشكل صداقات، وتتأسس علاقات حميمة. خلال رحلة بطول الليل كان المرء يبوح أحيانًا بما يصمت عنه حتى لأقرب الأقربين. إن المقصورات وعربات الركاب والمقطورات التي كانت تقطع الأرياف، ذلك الاندماج المدهش للخلايا المتمايزة كان يلتحم فيه المسافرون بعضهم ببعض. حتى إذا بلغت “القافلة” غايتها، يستعيدون المسافات فيما بينهم بنوع من الأسى. شي ما سينحلّ، ومع بهجة الوصول يذوب الحزن. هناك إذن قطيعة حقيقية، وانفصال لا يوجد له نظير عند الوصول بالسيارات.

صور لبوابات المدينة المتحركة تصوير ياسمين حسين
ثمة صفة أخرى مميزة: لقد كان وصولًا جماعيًّا. يهبط مسافرون بمتاعهم وآمالهم وأطفالهم وحشدهم المضطرب لملاقاة حشود أخرى: هؤلاء من ينتظرونهم، ثم لاحقًا حشود المشاة والمراكز والعمائر وكل تلك الشوارع. إن وصول القطار هو الوصول الوحيد الذي يكاد يكون مساويًا في جدارته للمدينة التي يدخلها . ثمة ما يشبه التبادل والتفاهم بين نوافذ القطار ونوافذ العمائر التي نشاهدها، بين وجوه المسافرين والوجوه التى تُرى في الشارع أو في نوافذ البيوت. لا بد وأن يتحصل القطار على استطالة ما وأن يكون قافلةً بمعنى الكلمة: إن العربة المفردة ذاتية الدفع (Autorail) لا تملك الحجم الكافي وتبدو متسللةً كمحتال. ومن هنا، تأتي المشاعر التي تستولي علينا ونحن نحدّق في فيلم وثائقي أو روائي قديم نرى به قافلةً عسكرية – ظافرةً أم مهزومة – مسرَّحين أو في إجازة قصيرة. من المؤكد أن المغزى الضمني للحرب، لعذاباتها وظلمها، كاف لايقاع الاضطراب لدى المشاهدين… لكننا نجد فيها بعدًا آخر: تلك الحشود ببزاتها وقبعاتها العسكرية مع مسعفيهم، بأناشيدهم أو رعبهم الصامت، تبدو مساويةً للمدينة التي تستقبلها. من أجل الطريق ينبغي تخيل رتلًا من المدرعات والشاحنات، وهكذا تولدت لحظة تحرير باريس. لم تكن هناك حاجة أبدًا لمثل هذه الظروف الاستثنائية في قطارات ما قبل الحرب الغاصة بالبشر. نعرف، مجرد معرفة أن جمال مدينة ما يكمن في تعدادها، في حركات الجموع ، في حجمها الملحمي – والمتسكّع (Flâneur) يحصل على متعته في الشارع من الذوبان في الشغف الإنساني الرهيب. لكن المدينة بتفوقها الساحق ، لا تجد أبدًا محاورًا ندًا لها. كان القطار، أو القطارات بغرَّتها الدخانية ونزقها تحقق هذه المعجزة: صنع ثقل موازن للمدينة، وبالأحرى إبراز ضخامتها. تلج المحطة بكثير من القوة المعتمة، حتى أنها، وللمرة الأولى تجعل المدينة تتقهقر، وترغمها على التماسك والتصرف بلياقة.

قد يكون في النهاية وصولًا لشخص مجهول. من المفهوم جيدًا أن معظم المسافرين كانوا مُنتَظرين من قِبَل أصدقاء أو أقارب، لكننا نريد أن نقول أن القادم يشعر بنفسه كمسافر بين الآخرين. وهو يتقلد هذا الدور إذ يهبط من القطار مع كل من كانوا مسافرين، تحيط بهم كل هذه الجموع التي تداهمهم. فيما يستمتع الرجل الذي لا يصحبه أحد بوحدة قد ينتفع بها في استكشافه للمدينة. إن خطواته ووجهه ويديه ستكون في المدينة لمسافر وليست أبدًا لمجرد رجل يتنزه. وبينما سيواصل قطع المدينة بحقيبة يده الصغيرة سيظلّ المسافر المتاح والقابل لأي شيء. والدراما تكمن في أنه يتوجّب عليه تركها عند لحظة معينة، فيصبح إنسانًا مثل الآخرين. يحتفظ بها البعض – على غير العادة – لفترة أطول، وينقّلونها من فندق لآخر. وتصبح الموضوع الجوهري الذي ينمحي أمامه السرير وقاعة الطعام والشوارع. إنها تبدو كمقابل مضاد للخزانة العملاقة في المسكن الريفي.

تفوّض الشرطة عددًا من مُخبريها في المحطة حيث تستطيع غربلة المسافرين، وإجراء بعض الاعتقالات إذا لزم الأمر. ألا يخيم نوع من التوجس على الأرصفة وعلى طابور العربات اللامتناهي، ناهيك عن ممرات المخازن أو الهناجر. أثناء الاحتلال كانت أكثر اللحظات خطورة تقع في ممرات المحطات حيث كان يتوجّب استخدام الحيلة وشيء من القوة أحيانًا. ولاحقًا، كان على السينما أن تتولى ما كان واقعيًا فعرضت علينا اختراقات جريئة أو جثثًا ممددة على الأرصفة ذاتها. وليكن مفهومًا، فاقتراحنا ليس وصفًا للمغامرة ؛ فما يهمنا وما نريد أن نعرضه هو أن المحطة تشكل معبرًا: فضاء متحرك إذن، مثير للقلق أو مُسكر بحسب مزاجك أو مشروعك. إن تلك الاستدعاءات من السينما أو من التاريخ الذي لا يزال حاضرًا تُرينا لمَ كان المسافر – محقًا – يستطيع أن يصنع لنفسه صورةً معينةً، هي صورة المسافر، لا فقط صورة إنسان ينتقل بسرعة وفي غفلة من مكان لآخر.

في النهاية، هناك وصولان فقط يستحقان اعتبارهما وصولًا بمعنى الكلمة: وصول المنتصر أو بالأحرى “النصر”- و قدوم المجهول. أن تكون على مرأى من كل الناس ومرئيًا منهم – أو ألا تكون مرئيا من أحد بينما أنت ترى كل الناس. بالتأكيد فإن عاِلم النفس أو الأخلاقي سيرى في هذا الخيار الأخير هاجسًا بالإفلات من الآخرين. أما المنتصر فهو لم يعد يرى أي وجوه، فقط حشدًا شديد الاهتياج. والمجهول من جانبه يطرح نفسه من تطفل كل إنسان. بما أنّهم يقدمونه لنا بشكل خيالي كمعتمر لقبعة ضافية تُلقي بظلالها على وجهه. بإمكاننا أيضًا أن نعتبر هذه الرغبات كإرادة لإضفاء قدسية ما على الوصول إلى المدينة، وطرحه من الابتذال اليومي. إن الحالم بوصول منتصر ، ما لم تكن له روح ديكتاتور، لا يرجو في النصر هذه الهتافات المتصاعدة نحوه، ولكن المدينة الهاذية، مدينة العيد التي تشبه تمامًا تلك التي كانت في الحلم. ويملك وصول المجهول بحسبنا، وعلى الرغم من تفاهته الظاهرية، نفس القدرات الخيالية… بدون أن يلحظه أحد يصير المسافر متلصصًا يرقب استعراض هذه المدينة الجديدة التي يندس داخلًا إياها.
نود، كي نختتم هذه النقطة، أن نرسم صورة سريعة أخيرة تؤكد ما هو جوهري في الموضوع الذي نحن بصدد تطويره. وهي تتعلق بالوصول على الخط العكسي (في السكك الحديدية) والذي نراه كثيرًا في حكايات “المقاومة” أو في الروايات البوليسية، ومرةً أخرى، نحاول أن نبيّن كيف أننا من الاستثنائي أو من الأدب، وبدفقة خيال أصيلة ننزع الحجاب عن المدينة. وفي حالة المقاومة كانت الصورة قد اكتسبت دلالة إضافيةً: أحد أعضاء الخلايا يتصرف بهذه الطريقة بالتواطؤ مع موظفي السكك الحديدية أو بالأصح مع “عمال الدريسة”. وهكذا يتم إبراز عالم الشغل، والتبدي الصامت لطبقة من السكان، وصلة الرفاقة التي تُقرِّب أحياناً بين برجوازيين وبروليتاريين. بعبارة أخرى، نحن لا نستطيع أن نتغافل عن ذلك البعد من “العمل السري”- وإن كان قد ولِدَ في حقبة معينة. إننا نمتلك مدينة ما بشكل أقوى عن طريق المفاجأة: يشحذ العمل السري حواسنا وشهيتنا للاكتشاف. ولم يكن للمدينة الوقت الكاف لتداري ارتباكها.

إن الوصول على السكة العكسية يشبه تمسيد الشعر عكس اتجاه نموه، يشبه التوقيت الخاطئ، وما هو مقلوب، والتفسير المغلوط، إذ نستخدم الإدراك أو القراءة وفقًا لنظام غير معتاد يصبح الوجه أو الكتاب غير واضحي المعالم، لكنّهما لا يسفران عن الفوضى قدر ما يسفران عن نظام مجهول ومحظور وعبثي بعض الشيء. إن الاتجاه وشَعْر الرأس والبنى القديمة تقاوم، ونحن نستمتع بالشعور بتلك المقاومة تحت راحة كفنا ونظرتنا وعقلنا. وفي الواقع فإن الإنسان إذ يحطّ في مدينة قادمًا من السكة العكسية، فهو يمرق عبر باب صغير إلى شارع مهجور ، أمام عمائر متداعية لفظت لتوها صور المباني الصرحية والواجهات المجيدة، وسينبغي عليه أن يغير بوصلته حتى يعثر على المحاور الكبرى للمدينة. ولاحقًا، عندما يكون قد أدرك المركز سيكون المسار المستعار قد واصل تضبيب إدراكه صبغه بمذاق غريب. وبعيدًا عن تلك المتعة الفريدة، سيكون قد عرف المدينة نفسها بشكل مختلف- مقلوبها، ووجهها الخفي- وسيكون عليه قبل أي شيء أن يعدّل استكشافه لأن المدينة تتشكل بحيث تترتب مسارات الحافلات، ولوحات أسماء الشوارع، والتفافات الطوارات، والأشجار المغروسة وفقًا لبعض النقاط العصبية، مثل الخروج الصحيح من محطة المسافرين. سيكون قد أجرى قراءةً أخرى للمدينة إذن ، واتخذ مسارًا آخر فيها.

إن الخيالي يستوجب اتساقه الذاتي، وهو ما نريد أن نعبر عنه مبينين أنّ للمغادرة “من المحطة” أصالتها الخالصة، تمامًا كالوصول عبرها : نحن لا نغادر المدينة بشكل حقيقي إذا أخذنا طريق السيارات، فبه العديد من المسالك الممكنة، ثم هل نعرف إذا كنا لا نزال نتقدم عبر الضواحي أو إذا كنا قد اجتزنا بالفعل الحدود الصارمة للمدينة؟! تبدو أرصفة المحطة كابيةً في الصباح. إنه مسار كاب ومرير، بينما يسعى المرء لتدفئة نفسه بمشروب حارق. الناس لا يثرثرون، وينكمشون في أنفسهم – باختصار، هم واعون أنّهم مغادرون تاركين خلفهم بعض الماضي إلى الأبد. أليست هذه علامة كل رحيل. توجد أشكال أخرى من القطيعة أكثر تجريدًا أو أقل حسية: في المطار يبقى المسافرون لبعض الوقت في مدينة وقد غابوا فيها عن أبصار من يصاحبونهم. وبالنسبة لمسافر كبير كماكس بُل فوشيه، فإن الرحيل بحرًا هو الأكثر بهجةً على الإطلاق. أما القطار فهو ينطلق ببطء، ومع إنزال زجاج جميع النوافذ نستطيع ان نرى الكائن المعني يختفي : إنه اقتلاع مؤلم بشكل خاص حتى أنه يحدث شيئا فشيئا مع مرور الثواني. وسنولي انتباهنا عندها من جديد إلى ما هو جوهري، أي الديكور الحضري. إن الرحيل من محطة القطار هو أن يتم تركيب المدينة ككلية، وبطريقة مميزة. وهنا أيضًا، نعرف جيدًا مجرد المعرفةٍ أن أي مدينة تقدم نفسها ككلٍّ متكامل – ولكننا عندما نتجول فيها لا نقابل أبدًا سوى جزر صغيرة، وشذرات و أقسام من هذا الكل.
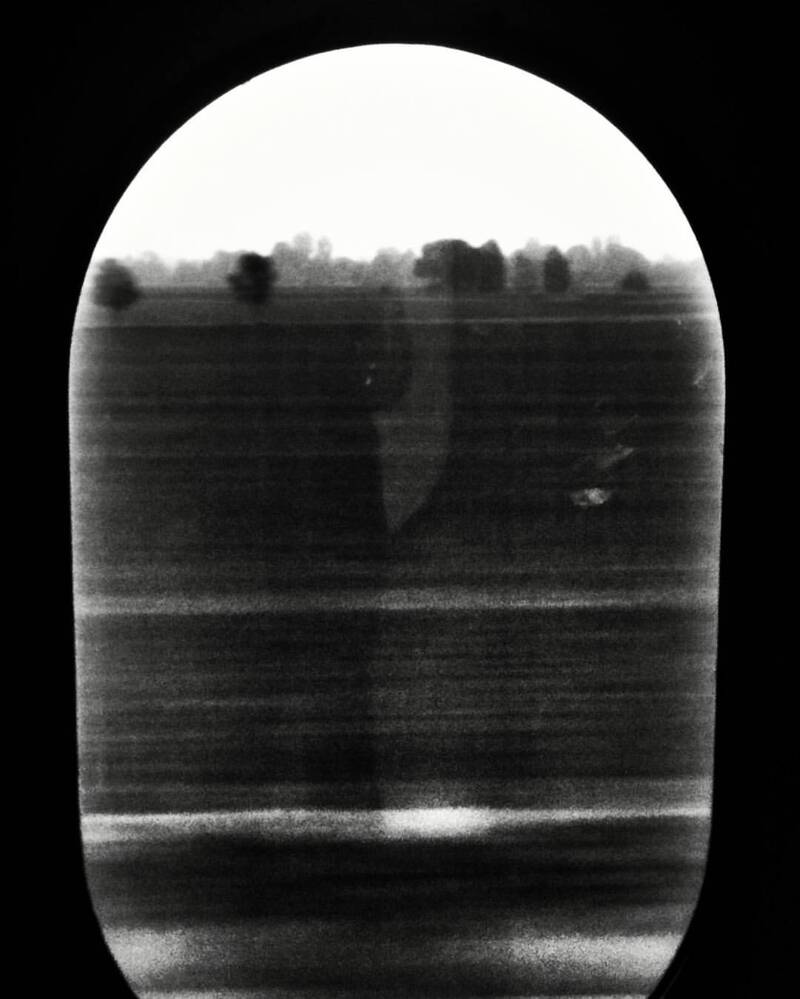

وفي المحطة، قبل المغادرة يكون لدينا الإحساس بأننا نخلف وراءنا المدينة بأسرها فيما لا تزال هي حاضرة، غير مختصرة في أحد تمثلاتها البعيدة. في الواقع، إن المحطة، كما سنرى لاحقًا هي داخل المدينة وخارجها في الآن نفسه. وبإمكاننا هكذا أن نراوح وجهات النظر: هي قريبة للغاية من المدينة بحيث تكون متأكدًا من وجودها، وبعيدة بما يكفي عنها لإدراكها ككلية.
أينبغي أن نعتبر هذا ميزةً حصريةً لمحطة القطار؟ ألن نجد الظاهرة نفسها في موقع فٌرجة مرتفع (Belvédère)، أو في أي موضع أكثر علوًّا من المدينة سواء كان من صنع الطبيعة أو من إنشاء الإنسان؟ إن موقع الفرجة المرتفع يسمح لنا بالهيمنة على مدينة ما، وبرؤية يوفورية لها، بما أننا نشعر بأنفسنا فوق المعمعة، وأننا نفرض نظامًا على واقع متشابك (وعلى الأقل فإن المسافة هنا لا تحثنا على الوعي بانفصال مؤلم) ونحن لا ننفي عن هذه التجربة كل أصالتها، ليس لأن ما ألهمته مجرد مواقف رومانسية وحركات غنائية. ومع ذلك، تبدو لنا تجربة محطة القطار أكثر أصالة. إن إدراك مدينةً عندما ينطلق من موقع الفرجة المرتفع ينحسر بسهولة إلى أحد التمثلات. بعض من الضباب، وشائعة غير مؤكدة تنحشر بين المتفرج والمدينة التي تستسلم لهافي الحقيقة : حشد من البيوت، وثعبان كسول أو خلية نحل تطن. أما من تحت سقيفة المحطة، فنحن ندرك بشكل مؤلم، ودون أي التباس، المدينة بأسرها: دون تجزئة، ودون تقليصها في بعض الصور الانتقائية.
