في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

اكتملت سيرته إذن؛ غرق يوسف شاهين في نوم عميق. وغالبًا سيتخيله عشاقه مستفزًا لأنه لن يحوِّل أحلامه إلى فيلم جديد. هو الذي منح حياته كلها للفن، واخترق أكبر تابو في السينما العربية؛ الحكي عن الذات: سيرته وأحلامه، نزواته ورغباته. جو يبتسم من برج المشاهدة حيث هو الآن، يتمتم بكلمات غاضبة في الوقت نفسه. يحاول أن يحكي أحلامه ويرسمها على شاشة السماء الكبيرة، ولا يجد دار عرض. لن يسمح لجنازته بأن تكون مشهد النهاية. سيحاول أن يجد طريقة ليقفز خفيفًا على سلم قد يصعد به إلى حياة ثالثة.

بكى يوسف شاهين عندما أنهى تصوير مشهد “هاملت” في فيلم “إسكندرية نيويورك“. هاملت هو صورته الغائبة في المرآة؛ ظل يلهث وراءها من فيلم إلى فيلم. في “إسكندرية ليه” كانت البداية حلمه إخراج فيلم عن سيرة أمير الدانمارك المتردد، المعذب الباحث عن نفسه وسط صراعات العائلة من أجل السلطة. مصير قلق بين مناخ حروب ودماء وخيانة. الفيلم تحول إلى أول باب في سيرة يوسف شاهين الذاتية. لكن شبح هاملت ظل يلاحقه. قالت له الممثلة المسرحية “هاملت دا هايجننك!“. هاملت كان موجودًا أيضًا في “الاختيار” و“حدوتة مصرية “و“عودة الابن الضال“، وفي” إسكندرية نيويورك” كان المشهد الأول بين جو وعبد الحي أديب مؤلف فيلم “باب الحديد” عن حلم كل منهما بهاملت، والثاني بين صورته في الشباب (أحمد يحيى) وصورته في الشيخوخة (محمود حميدة) على خشبة المسرح القومي، تلعبان ” هاملت”.
هاملت شبح نرجسي؛ يبحث عن نفسه الغارقة بين أطلال مشاريع كبرى خاسرة. كان يوسف شاهين يخجل من حذائه المقطوع، هو الفقير بين أرستقراطية الإسكندرية في فيكتوريا كوليدج (تخرج فيها ملوك وتجار ونجوم من الملك حسين إلى إدوارد سعيد مرورًا بعمر الشريف)، أحلامه كبرى، متعثرة، لا يقدر على شراء بدلة على الموضة، ولا حذاء أبيض، يملك فقط خفة الدم، ومهارة الرقص مع البنات في كوكتيلات الطبقة العليا. هذه أدواته في لفت الانتباه وسط محيط الأغنياء المتعجرفين.
ولد يوسف شاهين يوم 26 يناير 1926 لعائلة مهاجرة، وتحلم بهجرة أخرى. الأجداد تركوا “زحلة” النائمة في أحضان جبل لبنان وأبحروا إلى الإسكندرية؛ مدينة “العالم” التي كان يعيش بها 600 ألف “خواجة” تمتزج ثقافاتهم وأفكارهم وتتصارع رغباتهم في ملعب الطموح السياسي والمالي، بينهم كان يوسف: نصف خواجة، بربع إمكانيات مالية. وعناد شخصي لا حدود له؛ أبوه محامٍ يحلم بأن يعبر الابن من خندق الفقر عبر الاقتراب من عالم الأثرياء، الإنجليز أصحاب السلطة والسطوة، والمصريون الذين سيختارهم الإنجليز وزراء وأصحاب نفوذ. العائلة متوترة، على سطح من رغبات مكتومة في هجرة ثانية إلى درجة أعلى في سلم البرجوازية، وكان الشاب مرتبكًا دائمًا ويتكلم بسرعة لكي لا يلحظ أحد توتراته الداخلية. ظل معذبًا برغبات العائلة وأحلامها في الصعود. وبمحاولة إقناع المحيط الغريب من حوله بإمكانية قبوله. ذات مرة كان عليه أن يذهب إلى حفلة ولم يستطع، لأن الاختيار كان إما أن يشتري بدلة مناسبة، أو أن تشتري أخته فستانًا جديدًا؛ لم يذهب، لكنه عاد في اليوم التالي إلى المدرسة بفكرة اكتشف معها طريقة جديدة لاستعراض مواهبه. وإثبات تفوقه؛ والسيطرة على الانتباه؛ وقف أمام فصل من 30 تلميذًا “همج كما وصفهم“. وألقى مونولوج الملك “ريتشارد الثاني” أحد أبطال تراجيديا شكسبير، وكان المونولوج في لحظة الحكم على الملك بالتنازل عن كل شيء؛ مصير قاس لشخص يهوي من على عرش إمكاناته وجبروته إلى التسليم، لعب الشاب يوسف شاهين بكل أعصابه للسيطرة على المشاعر الهائجة والساخطة، وأنهى المشهد بدموع ساخنة، فاستقبلوه بتصفيق حاد. يومها اكتشف الفن كطريقة من طرق إثبات الوجود، واكتشف المسرح، وشكسبير. وبالتدريج إبتعد عن حلم اللحاق بطابور الجامعة (والتخرج ليصبح محاميًا مثل والده أو موظفًا في بنك ينتظر المرتب أول كل شهر كما تمنت أمه) إلى التمثيل والنجومية؛ إلى هوليوود. وهنا جمعت العائلة كل طاقاتها المالية (باعوا قطعًا من الأثاث والبيانو) لكي يسافر الشاب الطموح ويركب السفينة إلى “باسادينا” في العالم الجديد (أمريكا)، وهناك اكتشف أنه لا يصلح لكي يكون ممثلًا. هذا قبل أن يعود (يحب أن يشبه عودته إلى مصر ببطل فيلمه “ابن النيل“؛ المغامر الذي اكتشف وجه المدينة الشرير، وعاد ليبحث عن تحقق في بلده. عاد هو ليكون مخرجًا مصريًّا.. ليس فقط لأن أحوال عائلته المالية، بعد موت الأب، تدهورت بشكل كبير). عاد يوسف؛ وقابل المصور الإيطالي إلفيزي أورفانيللي الذى فتح الباب أمام اول تجربة له “بابا أمين” ليصبح مخرجًا وعمره 23 سنة فقط!

فيلم بابا أمين
المسافة طويلة بين هذه البدايات وبين نهايته السعيدة؛ فهو أشهر مخرج سينما في مصر والعالم العربي. نجم ينافس نجوم التمثيل، ومعه أصبح الفيلم يمكن أن ينسب إلى المخرج لا الممثل فقط.عرفه الناس كما يعرفون النجوم وحفظوا لزماته وأثارتهم تهتهاته. على الرغم من النظرة العمومية التي تراه مخرجًا “متحذلقًا”، وهي واحدة من اختصارات مخجلة صاحبت النصف الثاني من رحلة يوسف شاهين، وجعلته علي لوحة التنشين دائما.
الجمهور كسر أبواب السينما في حفلات فيلم “باب الحديد” واتهموا يوسف شاهين وقتها أنه مخرج لا يفهم (1958)، وابتعد عنه المنتجون، وبدأت مشكلاته مع شركة القطاع العام، فـ“هاجر” إلى بيروت، وبعدها سنوات طويلة خرجت بعض الأقلام على طريقة “مصر هي أمي” تعترض على مشاهد الفقر والعشوائية في فيلم قصير أخرجه شاهين تحت عنوان “القاهرة منورة بأهلها” فيلم وثائقي بنفس روائي خفيف؛ لكنه جرح رومانسية العشاق النمطيين الذين رأوا في شاهين “مستشرقًا” يعري مدينته من أجل عيون الخواجات. قبلها كان الاتهام بأنه يسرب دعاية للتطبيع في فيلمه “إسكندرية ليه” لأنه يقدم شخصية يهودية ودودة كانت تعيش في إسكندرية الأربعينيات. ومرة أخيرة حين اتهموه بالكفر لأنه يستوحي قصة النبي يوسف في فيلمه “المهاجر“. وقتها أصبح أحد الأهداف المتحركة لإرهاب فكري استفز طاقته وكان نقطة تحوله إلى “معلم” و“رائد تنوير” بعد أن تحول إلى “ناقد سياسي” ردًا على هزيمة يونيو 1967. هذه التحولات خارج السينما. تبعًا لمؤسستي الفكر والسياسة. وعلى أيدي مهندسين في الخلفية (مثلاً لطفي الخولي في “العصفور” وصلاح جاهين في “عودة الابن الضال“). وقد ساهمت هذه التحولات في صورة سينما يوسف شاهين أكثر ربما من المغامرة في الأساليب. وفي كل مرة كانت المعارك تستدعي مهارات التحدي والاستجابة. وكان يوسف شاهين يلبي صورته الجاهزة في الأذهان؛ المتمرد المشاغب القادر على إثارة المفاجآت، منتقمًا من أول مرة فشل فيها فشلاً عموميًّا حين تحوَّل عرض مسرحي أخرجه وهو طالب بكالوريا إلى فوضى كاملة.
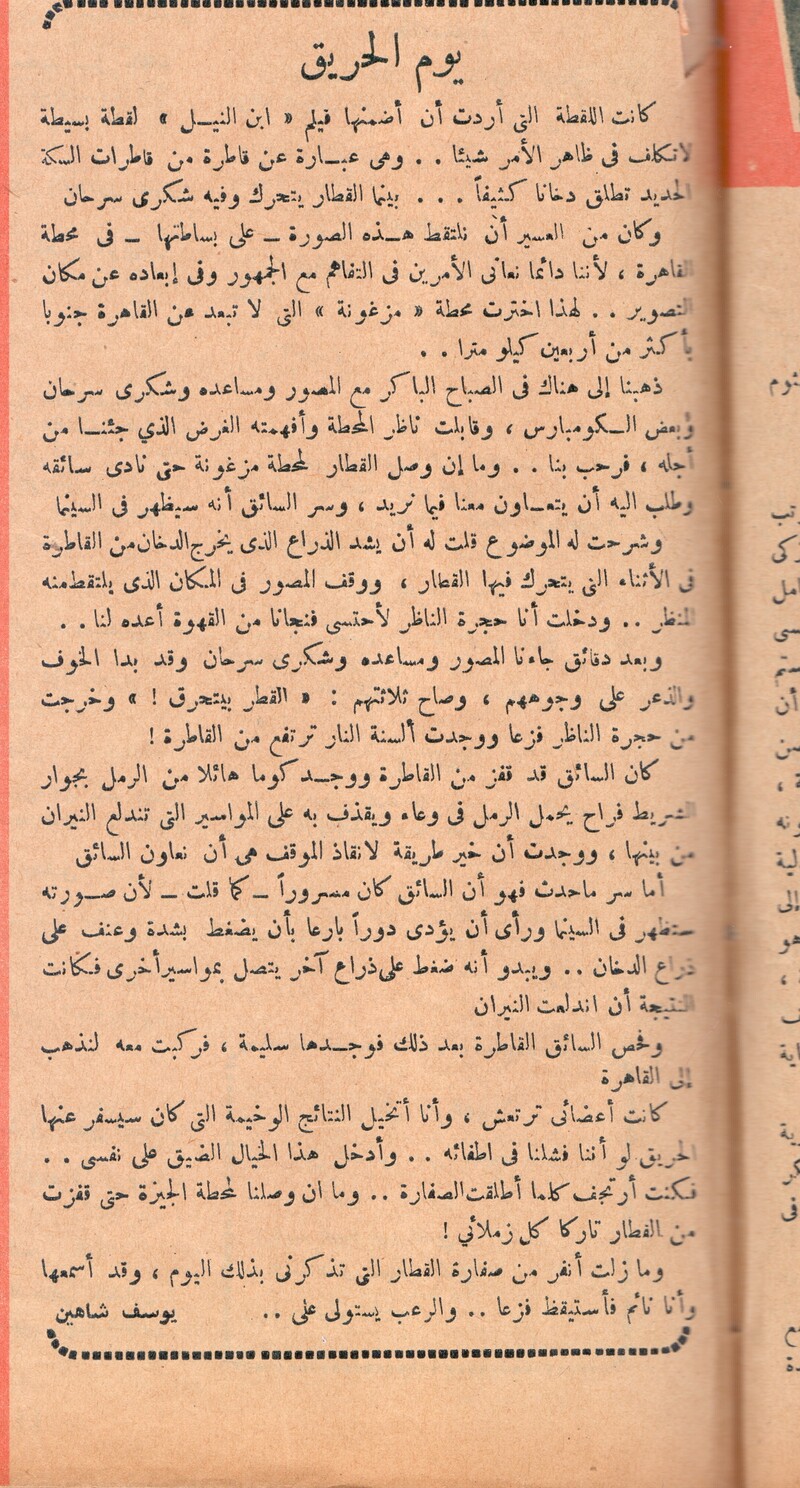
كانت اللقطة التي أردت أن أضمها إلى فيلم “ابن النيل” لقطة بسيطة لا تكلف في ظاهر الأمر شيئا… وهي عبارة عن قاطرة من قاطرات السكة الحديد تطلق دخانا كثيفا… بينما
القطار يتحرك وفيه شكري سرحان. وكان من العسير أن تلتقط هذه الصورة على بساطتها- في محطة القاهرة، لأننا دائما نعاني الأمرين في التفاهم مع الجمهور وفي إبعاده عن مكان التصوير، لهذا اخترت محطة “مزغونة” التي لا تبعد عن القاهرة جنوبا بأكثر من أربعين كيلومترًا.
ذهبنا إلى هناك في الصباح الباكر مع المصور ومساعده وشكري سرحان، وبعض الكومبارس، وقابلت ناظر المحطة وأفهمته الغرض الذي جئنا من أجله، فرحب بنا. وما إن وصل القطار لمحطة مزغونة حتى نادى سائقه، وطلب إليه أن يتعاون معنا فيما نريد. وسر السائق أنه سيظهر في السينما، وشرحت له الموضوع، قلت له أن يشد الذراع التي يخرج الدخان من القاطرة في اللحظات التي يتحرك فيها القطار، ووقف المصور في المكان الذي يلتقط منه المنظر.
ودخلت أنا غرفة الناظر لأحتسي فنجانا من القهوة أعده لنا.. وبعد دقائق جاء المصور ومساعده وشكري سرحان وقد بدا الخوف والذعر على ملامحهم، وصاح ثلاثتهم: “القطر بيتحرق!” وخرجت من غرفة الناظر فزعا ووجدت ألسنة النار ترتفع من القاطرة!
كان السائق قد قفز من القاطرة ووجد كوما هائلا من الرمل بجوار الشريط، فراح يحمل الرمل في وعاء ويقذف به على المواسير التي تندلع النيران من بينها، ووجدت أن خير طريقة لإنقاذ الموقف هي أن نعاون السائق.
أما سر ما حدث فهو أن السائق كما قلت- كان مسرورا لأن صورته ستظهر في السينما، ورأى أن يؤدي دورا بارعا بأن يضغط بشدة وعنف على ذراع الدخان.. ويبدو أنه ضغط على ذراع آخر يتصل بمواسير أخرى فكانت النتيجة أن اندلعت النيران.
وفحص السائق القاطرة بعد ذلك فوجدها سليمة، فركبت معه لنذهب إلى القاهرة.
كانت أعضائي ترتعش، وأنا أتخيل النتائج التي كان سيسفر عنها الحريق لو فشلنا في اطفائه.. وأدخل هذا الخيال الضيق على نفسي.. فكنت أرتجف كلما أطلقت الصفارة.. وما إن وصلنا لمحطة الجيزة حتى قفزت من القطار تاركا كل زملائي!
وما زلت أنفر من صفارة القطار التي تذكرني بذلك اليوم، وقد أسمعها وأنا نائم فأستيقظ فزعا.. والرعب يستولي عليَّ.
يوسف شاهين
*أحد المقالات التي كتبها (أو ربما استكتبها) يوسف شاهين!

محسنة توفيق لعبت دور بهية التي ترمز طبعاً لمصر في فيلم العصفور
ظلت أفلام شاهين في مكانة بعيدة لأنها ممنوعة من التداول العمومي؛ محاصرة في قاعات خاصة. وحكايات منقولة عن نخبة مشاهدين يدورون في حلقات سعيدة بعلاقتهم السرية مع أفلام تختصر في التعبير الغامض “سينما المثقفين“. ويقصد بها سينما مختلفة لا تفهمها سوى شريحة مميزة عن “الجمهور العادي” الباحث عن “متعة حسية” أو “تسلية” أو “حدوتة” لا تخدش استقراره بل وتطمئنه. المثقف وحده الجدير بـ“المتعة الذهنية“. وهي كلمة كنت مبهورًا بها في المراحل الأولى. كانت دليلاً على التميز كما كانت لعبة الشطرنج دليلاً على الذكاء والمهارة “الاستثنائية“؛ الذهن مميز وألعابه هي العبقرية. هذا ما جعل أفلام يوسف شاهين مثل أشعار أدونيس “شارات” الثقافة الرفيعة. وهي أيضًا تعبير عن مفهوم يرى الفن تابعًا لمؤسستين كبيرتين هما السياسة والفكر. الفن أقرب إلى نقوش على جدران معبد كبير تروج لفكرة، أو تشرح فلسفة. بمعنى آخر الفن هو زهور التعبير عن الحب وليس الحب نفسه، تطلعت إذًا إلى أفلام يوسف شاهين عندما لمعت فكرة معاداة الجمهور في لحظة كنت أبحث فيها عن طرق غير تقليدية ومخابئ من سطوة المجتمع.
وهنا لعبت الصورة المختزلة ليوسف شاهين دورًا كبيرًا. كان حسن الإمام هو مخرج “ميلودراما” الترسو، وفي مواجهته لا بد لكي تكون مثقفًا أن تحب (وهذا يعني أن تجبر نفسك على فهم) سينما يوسف شاهين.
ليس كل يوسف شاهين، بل مرحلته بداية من “الاختيار” ومرورًا بمجموعة “العصفور” و“فجر يوم جديد” و“عودة الابن الضال” و“إسكندرية ليه” (ومعها أفلام سيرته الذاتية). وقتها كان “باب الحديد” قد أصبح فيلمًا “عاديًّا” يعجب به الناس في التليفزيون، ويعتبرونه مع “الأرض” و“الناصر صلاح الدين” من الكلاسيكيات.
وبعدما أصبحت أفلام شاهين من عدة المثقف لم ندرك وقتها أن هناك مخرجًا سياسيًّا للأفلام (بعد نكسة يونيو 1967 لمعت أدوار كل من لطفي الخولي في العصفور، وصلاح جاهين في عودة الابن الضال، كما كان حدوتة مصرية فكرة يوسف إدريس) هؤلاء هم صناع الخلفية السياسية لأفلام شاهين، وهم أيضًا الذين ارتبطت بهم صورته المختزلة كمخرج “مثقفين” على الرغم من أن أفلام سيرته المباشرة لم تكن الأولى التي يبحث فيها يوسف شاهين عن نفسه. في الفيلم الأول “بابا أمين” كان هناك نقد خفيف للأب، وفي الفيلم الثاني “ابن النيل” كان النقد لأحلامه المفصولة عن سياق اجتماعي. كان يبحث عن قصص وأبطال يظهر هو من خلالهم “في البداية كنت أريد أن أكون ممثلاً لا مخرجًا، ولكني أدركت في المعهد، وبعد شهر فقط من بداية الدراسة، أنني يجب أن أكون مخرجًا لا ممثلًا، فتركت التمثيل برغم أنني كنت أحبه كثيرًا. أدركت أن شكلي ليس شكل نجوم تلك الفترة، ففضلت الإخراج، ومنذ بدأت الإخراج صرت أبحث عن ممثلين أمثل من خلالهم، ويا ويل الممثل الذى لا يكون أنا. عمر الشريف وغيره من الممثلين تعذبوا معي كثيرًا، فالممثل هو نفسه ولا يمكن أن يكون أنا؛ فحصل اصطدام وتناقض وانفجار، ووصلت إلى فترة شعرت فيها أنني في مأزق كبير طالما أنني لا أجد الممثل الذي يمكن أن يكون أنا. فقيل لي: لا، يجب أن تجد نفسك، أنت ترغب في التمثيل فمثِّل في فيلم واحد. وكان (باب الحديد)” (من حوار مع وليد شميط في كتابه: يوسف شاهين حياة للسينما).
لم تكن في هذه الصورة حكايات قديمة عن علاقة جو بالسينما. على الرغم من أنها أطرف، وتشير إلى سيرة ثرية أكثر وتمنحه تنوعًا ضخمًا.
لم يكن من الممكن في ظل الحضور الطاغي لهذه الصورة أن نعلن بصوت عالٍ عن محبة فيلمه مع فريد الأطرش وشادية “أنت حبيبي” وهي مرحلة طريفة في مسيرته. قدم فيها “بين ايديك” و“نساء لا رجال“؛ مرحلة كان يمكن أن يقبل فيها مكالمة من فريد الأطرش(المنتج) يقول له فيها إن الفيلم (يقصد جددت حبك) ناقص 2 كيلوجرام (الوزن المعتاد للأفلام 23 كيلوجرامًا) ويصور شاهين فعلًا الكيلوجرامات الناقصة. إنها سيرة مع السينما لا ينكرها صاحبها. تقول عطيات الأبنودي إنها حين سألته ( في حوار لمجلة “المجلة” 8 يناير 1991) عن أفلامه المنسية، كان رده كالطلقات المتقطعة “كل أعمالي أنا المسؤول الأول والأخير عنها، وهناك في القائمة ما يمكن أن أتجاهله أو حتى أسقطه من حسابي، باستثناء عملين فقط هما “حب إلى الأبد” (1959 مع نادية لطفي وأحمد رمزي ومحمود المليجي) و“رجل في حياتي” (1962 مع سميرة أحمد وشكري سرحان) وبلا خجل فقد أخرجت العملين في ظروف سيئة أقرب إلى الكابوس. كنت متعبًا ومرهقًا فكريًّا وعصبيًّا، وكان ذهني في تلك الفترة لا يتوقف عن التساؤلات” طبعًا لم أفهم العبارة الأخيرة، خصوصًا وأنه ينكر أنه أخرج الفيلمين بسبب “الضغوط المادية“، ربما محاولة اتساق مع الصورة، أو تركيب سيرة جديدة بناءً على النهاية وليس البداية… يوسف شاهين مفكر؛ وهو تصور في الثقافة العربية أعلى مرتبة من الفنان.. شاهين في هذه الأفلام أحب صورة المفكر ولعب عليها، واحتاج معها إلى خشبة مسرح.

يوسف شاهين مع الممثلين في فيلم إسكندرية نيويورك..والصورة غالباً أثناء مهرجان كان ويظهر فيها يسرا و ليلبلة و يسرا اللوزي و أحمد يحي
حكى يوسف شاهين حلم الخروج من الإسكندرية في “إسكندرية ليه” الذى انتهى بمشهد اللحاق بالسفينة في اللحظة الأخيرة، وأكمل الحكايات في “حدوتة مصرية” و“إسكندرية كمان وكمان” لتكون سيرته على مرآة السينما. حكي فيها بلا رقابة أقرب إلى المحاكمة لا الاعترافات، في لعبة يستمتع بها وحده غالبًا. يلعن فكرة العائلة. ويكشف مستورها، حتى إنه في “حدوته مصرية” يلمح إلى مغامرات أمه الجنسية “فكر بأمي وبغيرها، كانت صبية جميلة جدًا وكان والدها يقفل عليها في الغرفة ويمنعها من الخروج. زوجوها من رجل بشع يكبرها بحوالي 25 سنة هو والدي. عندما دخل عليها لم تكن تعرف ما هو شكل الرجل. ولا يمكنك أن تطلب منها أكثر مما فعلت“؛
محاكمة استعاد فيها أسئلة زمن المراهقة؛ استعادها وهو يشعر أنه اقترب من الموت عندما أجرى عملية قلب مفتوح. كانت شجاعة النقد أهم ما في أفلام السيرة الذاتية، وإذا حررتها من فكرة الجرأة والنقد الذاتي سترى أنها –باستثناء الفيلم الأول: إسكندرية ليه– تعتمد على لعبة مسرح يمكن أن تراها بصورة مكبرة في “حدوتة مصرية“؛ حيث الخشبة مكان مواجهة الذات. محاكمة واعترافات وتشريح للعائلة وانتصار البطل بمصالحة مع طفولته المعذبة.

“ماجدة الخطيب(لعبت دور أخته) وسهير البابلي(لعبت أمه) في “حدوتة مصرية
كان المسرح في هذه الأفلام تعبيرًا عن مزاج القلق والارتباك، وهذا مختلف عن أفلام النهايات التي اجتاحت فيها نزعة الخطابة، ونزعة المعلم المالك لخطاب يريد أن يقوله والمرشد إلى طريق، العارف بـ”المصير” والقادر على تعريف “الآخر”. استدعت فكرة امتلاك الخطاب مهارات المسرح القديمة عند يوسف شاهين في رسم المشاهد؛ يتحرك الممثلون في المشهد وكأنهم على خشبة، أمام جمهور وليس أمام وسيط محايد هو الكاميرا. خطة الحركة تعتمد على إيقاعات السخونة والبرودة على الخشبة. والحوارات في الغالب مونولوجات واستعراضات ذهنية للشخصية. هذه النزعة إلى “ميزانسين” المسرح بدت واضحة تمامًا ومناسبة في “الاختيار”؛ فأماكن التصوير تكاد تكون ديكورات مسرح: بيت بهية الأقرب إلى مكان خيالي لحرية الحواس، وبيت الأديب البارد المسطح بلا أماكن دافئة. ولكي يكتمل المزاج المسرحي ظهر يوسف وهبي نجم المسرح وأيقونته الشهيرة باسمه الحقيقي. يصب بناء الفيلم أمام مرآة يرى فيها نفسه ممزقًا بين الوجه والقناع؛ الواقع والخيال.. المسرح أيضًا يصلح للعبة أخرى هي الشفرات والرموز؛ يمكن اختزال اللغة إلى شفرات ذهنية، ومحاورات وأسئلة وجودية، وصناعة رموز من كتاب الشخصيات المعذبة: البطل في “حدوتة مصرية” هو المسيح المصلوب، وهاملت الممزق. رموز كبيرة طوال الوقت على خشبة ذهنية.
تحوًّل يوسف شاهين مثل أغلب بقية جيله من فنان قلق، يعري ذاته المتخفية وراء خوف برجوازي ثقيل، إلى مرشد، معلم، يقول الحقيقة الكاملة، ويعلم الناس. في هذه الأفلام أصبح النقد السياسي والتفكير وألعاب الذهن أقرب إلى خط منفصل تقريبًا، مثل نتوءات أو حواجز يجب على المشاهد تفاديها لكي لا يشعر أنه ذهب إلى خطبة أو حصة مدرسية.
وارتبط هذا الإحساس بعودة يوسف شاهين إلى المجرى العام، أصبح نجمًا عموميًّا (بعد المهاجر، والمصير، وحربه على الإرهاب)، شاركه تليفزيون الحكومة في الإنتاج، ورفعت قرارات المنع غير المعلنة، وعرضت أفلامه القديمة للجمهور العادي. وهنا فقدت نصف هالتها تقريبًا. وأصبح من الممكن أن نراها أفلامًا عادية ومملة وغير مبهجة أحيانًا. لم يعد أمام شاهين شيئًا من بضاعته القديمة؛ لا خطاب مقاومة الهزيمة (العصفور وما تلاه) ولا لعبة الاعترافات الشخصية (إسكندرية وما تلاه)، لم يعد أمامه إلا نثار خطابات عمومية جاهزة أقرب إلى الكيتش الوطني. وبهذا الكيتش الوطني غادر يوسف شاهين موقعه؛ ارتدى قناع المثقف حامل الرسائل الكاملة بخوذته وأسلحته الموجهة إلى جمهور غافل بلا وعي.

يوسف شاهين يشهر سيفه ويحمل رسالته الكبرى
أول فيلم ذهبت إليه في قاعة عرض للجمهور العادي كان «حدوتة مصرية» وخرجت بالأغنية؛ أغنية «محمد منير»، وقد لاحظت بعد تأمل ما أن أفلام يوسف شاهين المهمة ترتبط بأغنية، ربما كان من ميراث سينما الطرب مع فريد الأطرش، أو من أجل ترسيخ المقاولات في دراما موسيقية. وخرجت أيضًا بمشاهد غير مألوفة في السينما المعتادة “إشارات إلى سينما أخري“، بعد فترة رأيت أنها عادية (لم يكن الفيلم حدوتة تقليدية، بدا أن يوسف شاهين في «حدوتة مصرية» يلبي صورته في الذهن، مخرج خارج السياق متمرد، استعراض لجلد الذات، كشف مستور عائلي، أحلام ورغبات الذات محور للرغبة في الانتصار جوائز المهرجانات العالمية) وكذلك هزائم. أعجبتني اللعبة بين يوسف شاهين والممثل «نور الشريف»؛ لعبة مرايا، المخرج يري نفسه في ممثل يلهث وراء صورته.
في لعبة المرايا احتاج دائمًا أن يبحث عن نفسه في مواهب خارجية، استعراض ما ولو كان مونولوج هاملت الضائع بين صورة الناس عنه وصورته عن ذاته، لم تظهر المشكلة مع الممثل إلا في أفلام بدت قريبة من هذا الصراع، مع عمر الشريف في «صراع في الوادي» و«صراع في الميناء» كلاهما عن «الصراع» مع عالم مغلق على صوره الثابتة. وكان الممثل صورة للرومانسية المقتحمة، بطلاً قادمًا بملامح عاشق في معركة من أجل إثبات الوجود (الغريب أن هذا الصراع موجود في فيلم أقل شهرة هو «بين ايديك»؛ حين لعب شكري سرحان دور عاشق فاتنة من الطبقات الأعلى، ولم يكن الصراع في الفيلم تراجيديا على طريقة فيلمي عمر الشريف، بل كوميديا، حين قررت العائلة إعادة تربية العاشق لتأهيله الالتحاق بها، لكنه بعد موافقة سريعة يتمرد ويقفز على السور ويتحول إلى معلم لطبقات خارج التاريخ). لم يكن شاهين في هذه الأفلام مهتمًا بالصراع الداخلي للبطل، بل بالإحالات إلى الخارج، وإلى الثورة التي جاءت لتعيد ترتيب الطبقات، لم تصطدم نظرته مع النظرة السائدة عن انتهاء العالم الشرير قبل يوليو 1952، خطاب تفاؤل عادي، ببطل إيجابي كما يقول كتالوج الواقعية ذات الحس الرومانسي البعيد عن تحليل الطبقات وحقول العمال فيما بعد في «باب الحديد»، ثم أساسًا في «الأرض». لكن أفلام يوسف شاهين لم تكن مثل السينما المعتمدة على أدب يوسف السباعي (غالبًا مع عز الدين ذو الفقار وإحسان عبدالقدوس) ومع بركات «توليفة رومانسية الثورة»، استدعى السباعي رومانسي منقرضة، واستعان بفرسان الأقدار في مواجهة الكوارث واختلطت المآسي المدمرة بالحب في مزيج جعل من أفلامه علامة لا تنسى على «سينما الدموع»، واختار إحسان أسلوبًا استمده من عمله الصحافي، ودخل مخادع الطبقات العليا القديمة ليجعل منها مادة مثيرة لدروسه «الأخلاقية»؛ وفي المقابل كانت بيوت الطبقة الوسطى الجديدة وملامح العائلة البرجوازية الهادئة هي مكان غزله والنموذج الذي يبشر به.
اكتفى يوسف شاهين من سيره مع تيار يوليو بمهارات الإبهار في صناعة فيلم «الناصر صلاح الدين» (وقد تسلمه من عز الدين ذي الفقار الذي كان مقررًا أن يخرجه لكن المرض منعه)، بطلاً ورمزًا على هوى جنرالات القومية العربية ثم «جميلة» نجمة حرب التحرير في الجزائر وأخيرًا “أبو سويلم” فلاح التمسك بالأرض التي ضاعت في حرب التحرير. اعتمدت هذه الأفلام على صناعة بطولة كبيرة قوامها الإبهار، وحركة مجاميع ضخمة وتصوير معارك على طريقة السينما الأمريكية، وحكايات مثيرة لتعاطف أوسع مساحة من الجمهور. لعبة المرايا في هذه المرحلة متوترة صعود وهبوط، تشغيل مهارات السينما المحترفة كما تعلمها بالقرب من هوليوود، حلمه الرومانتيكي ومثاله الأعلى هذه المهارات عملت في مجال صراع البقاء في السوق خصوصًا بعد أن قرر تكوين عائلة خاص والاستمرار بقوانين منتجي الأفلام التجارية، هذه مرحلة فريد الأطرش وأفلام أخري لم نعلم عنها إلا من فيلموجرافيا ذكرت أفلام مجهولة نسبيًّا مثل «شيطان الصحراء» –كان شاهين يريد حذفه من الفيلموجرافيا– و«رمال من ذهب». الأول فيلم أنتج بين فيلمي «صراع…» عمر الشريف الذي لعب البطولة أيضًا، والثاني في مرحلة بيروت التي هرب فيها يوسف شاهين من سطوة القطاع العام بعد «باب الحديد» و«فجر يوم جديد». المهم أن القائمة بكل تنوعاتها تعكس تحولات مثيرة للدهشة، وصورًا متعددة لمخرج يختصر في صورة واحدة.

“يوسف شاهين مع النجم الفرنسي ميشيل بيكولي ومحسن محي الدين وبوستر “وداعاً بونابرت
بعد أكثر من 15 سنة من «حدوتة مصرية» تابعت اللعبة نفسها بين نور الشريف ويوسف شاهين، لكن في فيلم آخر وسياق آخر «المصير»، لم يدخل نور الشريف المتاهة التي دخل فيها ممثلون مثل محسن محيي الدين أو عمرو عبدالجليل، وغيرهما، لم يحافظوا على مسافة الوجود خارج عالم يوسف شاهين وأكلتهم الأدوار المصنوعة بمزاج المخرج الذي يحب صناعة صورة حول نفسه، ديكتاتور يحرك الممثل، ليس صحيحًا أنهم أصبحوا يشبهون يوسف شاهين، لكنهم بعده شعروا بفراغ الماريونت التي أدت دورها المرسوم وبعد العرض لم تجد سوى رف في مخزن الأدوات القديم، نور الشريف وأحمد زكي وقبلهما عمر الشريف كانوا في صراع، لم يستسلموا تمامًا لفكرة رغبة «الأستاذ». في المصير أدخل يوسف شاهين نور الشريف في لعبة ابن رشد، الفيلم عن قصة حياته لكن ابن رشد غائب، وينتهي الفيلم وابن رشد يبتسم للجنود الذين أحرقوا كتبه، يبتسم لأنهم أعطوا إشارة البدء لرحلة يقظة جديدة، مشهد لا يخلو من سادية يتعمدها يوسف شاهين خاتمةً لرسالته التي أراد توصيلها في إطار الصراع العنيف الدائر الآن على أرض الواقع. فيلم شاهين «رسالة دعائية» ضد سيطرة الأصوليين على تفكير الناس في مصر، سيطرة دفعتهم لكراهية الحكاية. وابن رشد في الرسالة مجرد رمز وقناع يخوض به المعركة ضد الأصوليين على الطريقة الشائعة منذ سنوات، رمز من التراث في مواجهة رمز مضاد من التراث نفسه؛ ابن رشد في مواجهة ابن تيمية، بل كان ابن رشد قناعًا ليوسف شاهين الذي أراد أن يحكي قصته مع منع فيلم «المهاجر»، وهكذا أعاد نور الشريف اللعبة المزدوجة، وأصبح الرمز مركبًا، لم يعد الفيلم صعبًا على الناس، لكنه أصبح في موقع الاستقطاب، في تيار يستمد أوصافه ومفرداته من خطاب عمومي عن جماعات الإرهاب الأصولي. لم يفعل سوى الدخول في معركة جاهزة بأسلحة قديمة، التزم بصورته، حامل رسالة كبرى إلى جمهور لا يعرف ونسي هستيريا قلقه، وتكلم لغة فصيحة دون تهتهة كانت تميزه.
هل هذه نهاية سعيدة لهاملت؟
