في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.
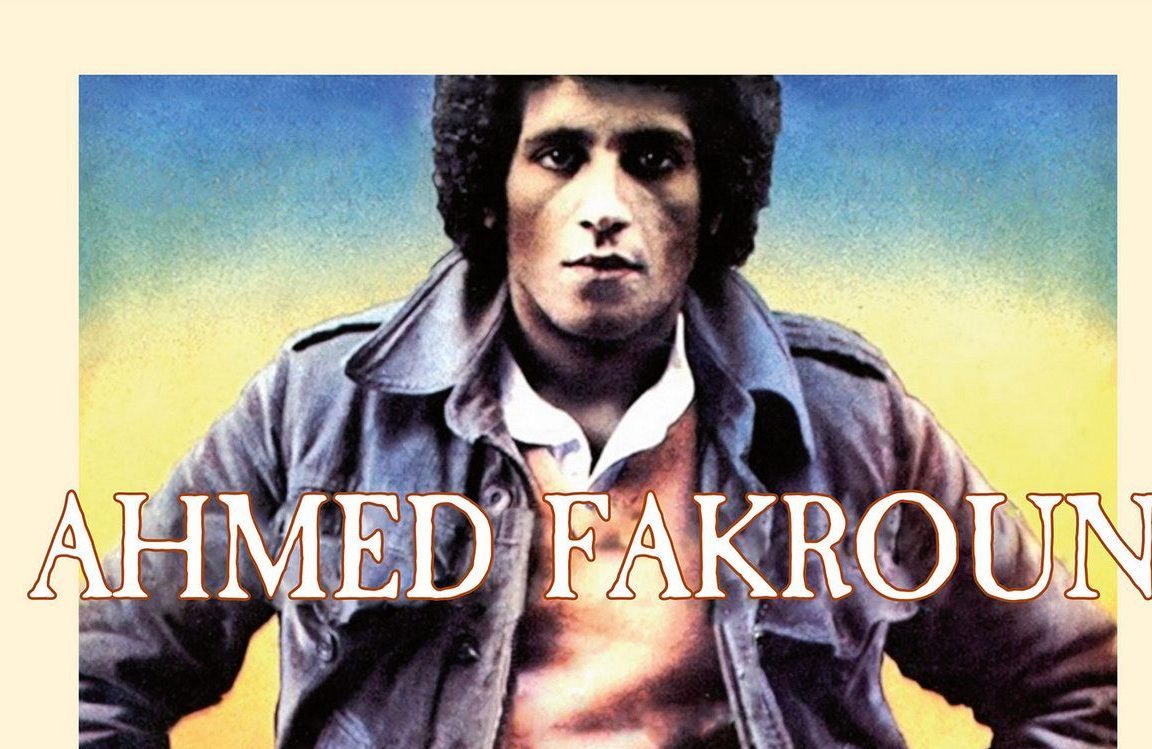
مقدمة مدينة
الموسيقى هي التي تعيش مع أنهم يدمرون كل شيء!
وبالفعل خرج صوت أحمد فكرون من تحت الرماد. كنت أحتاج شرحًا كثيرًا عند بث أغنية أو كتابة عابرة عن أغنيات وموسيقى صاحبتني في لحظات التمرد على كل الكتالوجات العمومية في الحياة.. مصاحبة الموسيقى لسنوات تحولاتك لا تنسى. أبي شرح لي قصيدة الأطلال؛ فوقعت في غرام أم كلثوم ووضعتها مثل النجمة في كراسات الابتدائي. كانت علامة تميز وسط مزاج عام تقع أم كلثوم فيه على قمة جبل التقديس؛ يحوم حولها كهنة وحواريون يرسخون للقداسة ويثبتونها، بينما العالم يتغير، كنتُ مميزًا بشرح أبي ودندنة القصيدة كأنها سفر من أسفار حياتي. وقتها قبل أن أتم العاشرة كنت في مرحلة التباهي مع “الموديل المثالي” المقبول اجتماعيًّا، وفي نفس الوقت مميز كما يليق بالطالب المتفوق. كان الانسجام الذي فرضته الدولة باحتكارها كل شيء يتفكك بالتدريج؛ حتى إن التليفزيون الرسمي يعرض تحقيقًا مصورًا من الشارع حول خطورة ظاهرة اسمها أحمد عدوية القوة القادمة من منطقة شعبية كانت تتوارى تحت سطوة أفندية الثقافة، وأقلقت الدولة ومعارضيها في نفس الوقت. بل إنهم تبادلوا الشتائم؛ فالمعارض التقدمي اعتبر انتشار صوت عدوية خطة ممنهجة لنشر الانحطاط السياسي، والقضاء على الرومانتيكية رفيعة المقام كما قدمها عبد الحليم حافظ، وأحلامه الاشتراكية العروبية. هذه قصة طويلة جدًا لكنني فيها مراهق يترنح بين الاندماج والتمرد. التغني بحلاوة الانسجام الميري والبحث عن أصدقاء لهذه الروح المتمردة الحائرة في غربتها. وهذا ما وجدته في جنوب ليبيا التي هاجرت لها عائلتي في آخر السبعينيات من القرن الماضي، في واحدة من هجرات البحث عن الراحة المالية بعد انتهاء حرب كتوبر وتباشير عصر الانفتاح، وانتهاء زمن الموظف السعيد. وجدت هذه الموسيقى التي تجمع الحائرين. لم أكن أعرف صاحب الموسيقى ولا الصوت الذي يغني ولا النوع الذي اندمجت فيه الإيقاعات والنغمات بهذه العجينة التي تختلف عما كنا نسميه في مصر “فرانكو آراب”. كانت هذه الموسيقى ” الهجين” هي لقاء أصوات هائمة من سلالات تصل إلينا ممتزجة ومتفاعلة. ونحن نسمعها في ممر نبحث فيه عن أصحاب يشبهوننا؛ دون أن نغادر الكتلة الجماعية الكبيرة التي ننتمي إليها.
لم أعرف اسم صاحب الموسيقى إلا عندما بحثت عنه بعد العودة إلى مصر، وعثرت على أول شريط/ألبوم يحمل اسمه: أحمد فكرون، في كشك صغير بممر الأمريكيين عند تقاطع طلعت حرب مع 26 يوليو. كانت فرحتي بالشريط تساوي اللقاء مع أصحاب الاكتشافات الأولي في التمرد. استعدت معه مدينة كاملة كانت تغرق تحت أوهام وهيستيريا “الجماهيرية” وكل ما لم أستطع معرفته في ليبيا رغم إقامتي بها. بل ورحلة الامتزاج الفريد الذي تبلور في موسيقي الفانك.. وامتزج فيه أنواع أحبها مثل السول والجاز والإيقاعات التي تبتلع الآلات والألحان والمستمعين داخلها.. قابلت سلالات أفريقيا المهمشة والصحراء التي اصبحت تعني أكثر من مجرد فراغ ممل مخيف.
لم يكن أحمد فكرون مشهورًا ولا من الأصوات التي لها جمهور كبير في مصر، وذلك قبل أن يخرج من تحت أطلال ليبيا مع اكتشافه من الأجيال الجديدة مع أغنية “يا بلادي حبك موالي”، وأكد من جديد أن الموسيقى هي ما يبقى رغم أن هناك من يدمر كل شيء حولنا.
وهذا ما أفرحني في تدوينة الروائي محمد النعاس الذي أهدى روايته”خبز علي طاولة الخال ميلاد” إلى أحمد فكرون، ودفعني الي طلب إعادة نشرها على مدينة، لنحدثكم معًا عن رحلة مهمة في التمرد والبقاء رغم الدمار.
والآن استمتعوا بمقال النعاس
وائل عبد الفتاح…
لم أعرف أحمد فكرون مبكرًا، استمعت في طفولتي لناس الغيوان ومحمد حسن والكابّو وأم كلثوم، كلٌ حسب من أرافقه من أبناء الأجيال المختلفة في العائلة. تسللت في بدء الثورة الليبية أغنية “يا بلادي حبك موالي”، لأغرم بها وأبحث عن الفنان الذي غناها؛ فمن منا من لا يريد أن يبحث عن الفنانين الذين غنوا حبهم للوطن؟
غنى أحمد فكرون أشكالاً موسيقية عديدة، كان كالنورس، طائرًا حرًا يبحث دائمًا على نوعٍ جديدٍ يدمج به الألحان والكلمات الليبية ويبحث فيه عن حياة جديدة، تأخذ موسيقاه الطابع التجريبي في الراي، والريجي، والسُول، والبوب والبروجريسف روك، إلا أنني هنا، سأتحدث خصيصًا عن الفانك، النوع الموسيقي الذي لم أسمعه إلا من أبناء أمريكا السود، كبرنس وجيمس براون وفي بعض من أغنيات مايكل جاكسون.
لا أفهم الكتابة عن تاريخ الفنانين، صفحات ويكيبيديا والمقالات الانطباعية مليئة بها، تسرد تاريخ الفنان الفني منذ أول مرة أمسك بها آلته الأولى وحتى آخر أعماله وتواريخ الألبومات التي أنتجها. ولكن توجد فراغات تاريخية في مسيرة حياة فكرون، راودتني على البحث في مسيرته، فالفنان الذي غادر ليبيا في سبعينيات القرن الماضي، يحتفل بنجاحه في عواصم أوروبية من لندن إلى باريس وروما، عاد إلى بنغازي، التي ولدته وشرب من تجربتها الفنية، في إحدى أكثر الصفحات المغيَّبة في التاريخ الليبي، منتصف الثمانينيات. عاد إلى شعب تقلبت طباعه في نظام يناصب العداء لكل ما يمثله.
حالف الحظ الكابّو؛ عبد الحميد الشاعري الذي وجد منجاه من نيران جماهيرية السبعينيات والثمانينيات في مصر، احتضنه الجمهور المصري، واحتفى بإبداعه وترك له الساحة ليؤسس لونًا فنيًّا جديدًا. خطوة لم يأخذها بجدية، فكرون وناصر المزداوي ونجيب الهوش؛ الأخيرين كانا أكثر حظًا من فكرون لحصولهم على بعض من الفرص في مصر- الآباء المؤسسين للموسيقى “الحرة” في ليبيا.

وجدوا أنفسهم أمام سوقين، أحدهما متطلب يصعد فيه النجم في ليلة ويغيب في فجرها بأوروبا، والآخر، سوق نائم تشتعل فيه نيران الكراهية تجاه كل ما هو غربي الهوية. اشتعلت تلك النيران حقيقةً في الثمانينيات، بعد نداءات لحرق الجيتار والساكسفون والبيانو، والعودة مجددًا إلى العود والقانون. وثق فيديو لوكالة الصحافة الفرنسية، مشاهد لذلك العداء الثقافي الذي انطلق من خطاب زوارة (التاريخي) في ١٥ أبريل ١٩٧٣ للعقيد الشاب.
كان فكرون في منتصف الثمانينيات منتشيًا بنجاحاته بعد إصداره لمجموعة من التسجيلات، بدأت بإنتاج أغنية “اوعدني” في ١٩٧٤ بالمملكة المتحدة، خرجت بعد ذلك “نسيان”، البداية الفعلية لنجاحه الفني، واستمرت حتى إنتاج ألبوميْن آخرين بعنوانين “سوليل سوليل” – العنوان الفرنسي لأغنية ليل السهرانين-، و”موت دامور”؛ العنوان الفرنسي أيضًا لأغنية كلمات حب- في العام ١٩٨٧. كان الألبوميْن من عنوانيهما الفرنسيين موجهيْن للجمهور الأوروبي. توّج نجاح فكرون بفيديو كليب ليل السهرانين، الفيديو الكليب الذي سيعد نوعًا من الجريمة الثقافية إذا ما راودت فكرون نشره في ليبيا في ذلك الوقت.
منذ سنوات قليلة، وعندما هزني الحنين لسماع صوت فكرون مجددًا، وجدت فيديو ليل السهرانين، يبدأ الفيديو برجل فرنسي (سأعرف بعدها أنّه الممثل الكوميدي كولوش) يجلس أمام شاشة تليفزيون، تدخل الكاميرا إلى شاشة تليفزيون، فيظهر خيال فتاة راقصة، ترقص معها كلمات عربية لمجموعة من الأفلام المصرية الكلاسيكية كخان الخليلي، وفي بيتنا رجل، شياطين الليل، وفيلم المليونير من بطولة إسماعيل ياسين.
أخرج الفيديو، المخرج الموسيقي جان باتيست موندينو، يظهر أحمد فكرون شابًا داخل الفيديو يغني بأسلوب يمزج فيه الأسلوب الغربي وأسلوبه الليبي الحماسي، ”تركني والدمعة في العين، لا نظرة لا كلمة لا شوق… لا لا لا لا”.. “حلفت نهونه يا سامعين، لو يرجع نحلف ما نعود” ترتفع حماسة الروك آند رول داخله، بينما تستمر البيز جيتار، الآلة المفضلة له، في تحديد النوع الموسيقي الذي تنتمي له الأغنية، الفانك.
ليل السهرانين، أغنية تحتفي باللهجة الليبية، اللهجة البنغازية بالتحديد، تعاون فيها فكرون مع الشاعر الغنائي نبيل الجهمي، كانت كلمات الجهمي تحتفي بالصحراء، ببنغازي، بالحب الليبي المسكون بفراق الحبيب، بالشوق. الألحان الممزوجة بها الأغنية، أخذت من الصوفية الليبية شيئًا من طابعها.
لم تتلقَ اللهجة الليبية نصيبها من الاحتفاء في الفنون المختلفة، كانت لهجة خجولة، لا تبحث كثيرًا على الإفصاح عن نفسها، ساعدت عزلة البلاد وشعبها في هذا الانكفاء. لم يعمل فكرون على تبسيطها أو تحويرها كما فعل الكابّو، رأى أن عليه أن ينقلها للعالم كما هي، كان واثقًا بأنّها قادرة في الإفصاح عن ذاتها إذا ما أتيحت لها الفرصة، وإلا لما تشجّع وغنى قصيدة قديمة كسوف الجين.
رقصت على ليل السهرانين مع زوجتي في شقتنا، في أكثر من مناسبة، رغم الكلمات الحزينة التي تجلبها معها؛ فالتلاعب على الحزن، إحدى صفات الأغنية الليبية، ليرقص الليبيون على ألحان الفراق بفرح ساحر. إلا أنني لم أرقص عليها في أي ديسكو، كما فعل الأوروبيون الذين أعادوا اكتشاف فكرون بعد أن وجد دي جي برنس لانجويج الأغنية وأعاد إنتاجها في بدايات الألفية. نفض الغبار عنها وأعاد تسميتها لجمهوره المتعطش للرقص تحت اسم يو سون.
غنى فكرون ليل السهرانين (سوليل سوليل- الشمس الشمس) لسنواتِ ثلاث بعد الفيديو كليب في حفلات حول أوروبا، وعند عودته إلى ليبيا، وجد نظامًا اجتماعيًا جديدًا، وبلد مناصب العداء للولايات المتحدة الأمريكية، حاصرت أمريكا البلاد لعقد ونصف من الزمن، أثر ذلك الحصار على مسيرة فكرون الفنية، لم يعد السفر داخل وخارج البلاد سهلاً، كاد أن ينفد نجمه ونجم آخرين غيره؛ لم تجد موسيقاه مكانًا لها في بلاده.

ألبوم سولي سولي أحمد فكرون
في ١٩٧٧، خرج الفانك الليبي، كان الشباب الليبي في تلك الفترة مهوسين بالديسكو، فلم يعرفوا أن اللون الموسيقي الجديد الذي جاء به فكرون يختلف عن الديسكو؛ لهذا سموا كل موسيقى غربية تحثهم على الرقص بالديسكو. وإن كانت بليل السهرانين ألحان تحثك على الرقص السريع، فإنّ نسيان ؛كما غناها فكرون في السبعينات؛ للرقص الرومانسي البطيء.
“وين ضاع الحنان؟ والحُب اللي كان… نقولك يا حبيبي، تقولّي كان زمان”، يبدأ فكرون غناءه، غير مدرك أنها ستغنى يومًا ما من أجله، لأكثر من خمس عشرة عامًا، يغلب فيها لون فني واحد في بلاده؛ عمل الشاعر الليبي الكيلاني، أحد أذرع النظام، على تهميش ألوانًا موسيقية مختلفة في البلاد، وسوّق للونه الفني (النجع) ممثلاً في الموسيقار محمد حسن، فبينما استمرت الألوان التقليدية كالمألوف والمرسكاوي تحظى ببعض الاهتمام، كون الأولى دينية والأخيرتين شعبية، وبينما أفلح الريجي الليبي الاستيلاء على آذان الشباب، وبذلك أفلح في النجاة من النسيان. كان أمثال فكرون وناصر المزداوي ونجيب الهوش مهملين، منسيين من الذاكرة إلا في قلوب عشاقهم والمقربين منهم، كان ذلك قبل أن يعيد الانترنت إحياءهم، إحياء فكرون بالذات.
ونجت نسيان من النسيان، تلقفها الدي جيز كما تلقفوا قبلها ليل السهرانين، وأعادوا تحريرها وتوزيعها. نسيان شكلت صعود فكرون مرتيْن، وكأنها تأبى إلا وتذكره بأنها كانت بداية مجده الموسيقي، هي أغنية تمتزج فيه الإيقاعات والآلات الموسيقية الغربية والشرقية، التقليدية والإلكترونية. لم يجرؤ أحد قبل فكرون، أن يغني كلمات ليبية بهذه الطريقة الخارجة من حناجر السول والجاز الأفرو-أمريكيين.
عاش فكرون في ليبيا في رعب، وفي التسعينيات أخرج ألبوم سندباد، الألبوم الوحيد الذي أنتجه في ليبيا، في طرابلس تحديدًا. كان النظام يقصيه في كل خطوة يحاول خطوها، فبعد أن اكتشف هوس دي جي برنس لانجويج بليل السهرانين، قرر أن ينفض الغبار على ألبوماته الأولى، ويحملها على الإنترنت ويبدأ ببيعها ونشرها، لكنه واجه نظامًا عمل على طمسه حتى إلكترونيًّا، فحجبت الأجهزة الأمنية نظامه، نفس الأجهزة الأمنية التي كانت تحارب النجوم في الثمانينيات.
جهاز “محاربة النجومية”، هو جهاز أمني يتحدث عنه الكتاب والمثقفون، ومع أنني لم أجد دليلاً قطعيًّا بوجوده، فإن ممارسات النظام التهميشية في الثمانينيات والتسعينيات قد تكون دليلاً على وجود ما يشابهه، أو آثار منه، فكان لاعبو كرة القدم في البلاد يلعبون بأقمصة عليها أرقامهم فقط دون أساميهم، بل يحظر على المعلقين حتى ذكرهم، وكانت وسائل الإعلام الليبية المملوكة للدولة هي من تحدد من يظهر فيها أم لا، هذا عدا عن القوانين الصارمة تجاه المطبوعات، فأي ورقة تطبع كان –ولا يزال رسميًّا- عليها قبل أن تُطبع وتُنشر، أن تمر بموافقة أجهزة الدولة. كان ذلك، قبل انفتاح البلاد نحو العالم في بداية الألفية.”
من غير ما أنت تقول… حسيت بالنهاية، عنّي البال مشغول، وفكرك مش معايا”، كأن فكرون، كان يغني لوطنه، لا لحبيبه. إذا أحس بالنهاية، قبل حتى أن تدركه، لكن النهاية…كانت بداية أخرى. إذ تمكن في ٢٠١٠ أن يعيد إنتاج أغنياته ويسوقها للعالم.
سؤال سألت لنفسي، ما أهمية فكرون بالذات، بعيدًا عن اللون الموسيقي الجديد الذي أعطاه للأغنية الليبية، التي كانت تتناسخ في ألحان متشابه في الستينيات. ما يضفي عليه أهميته، هما أغنيتيْن، بعيدتيْن عن الشعر الغنائي، وقريبتين من الشعر الشعبي، التقليدي، الذي كان يقرضه الشعراء الليبيون – ولا يزالون- دون التفكير في الفوز بأغنية تلحنه.
الشعر الشعبي، هو شعر البادية، شعر الحرية والصحراء والتنقل، شعر محموم بتفاصيل البيئة المحيطة من زرع، وطيور وحيوانات وأشجار، كلمات هذا الشعر هي من أصعب الكلمات الليبية، ويصعب على شريحة واسعة من الليبيين فهمها، أواجه أحيانًا فهم الكثير من قصائده.
إحدى أهم قصائد الشعر الشعبي الحديثة هي “ارحم بويْ”، للشاعر الشعبي عبد المطلب الجماعي.
ارحم بويْ، خلاني هواوي.
كيف النجم في قلب السما
لاني غرس منبوته سناوي
ولا زيتونة معصاره زوى
تمكن فكرون من غناء القصيدة، وأخذ مقاطع منها، ليغني للحرية وقلق الليبي البدوي من الاستقرار، لم يحب أحمد الاستقرار، كان الاستقرار مهلكة لموسيقاه؛ فلم يخرج الكثير من الموسيقى في التسعينيات وبداية الألفية، كما أنّه لم يستقر قط على لون موسيقي واحد. ولهذا، فغناؤه لارحم بويْ، كان تحديًا مناسبًا، لتحرير النص الشعري من إلقاء الشاعر، للشكل الموسيقي.
سوف الجين
تعل خبر يا سوف الجين
علي القديمين
عرب كانت تعرفها وين
تعال خبر واحكي بالحق
علي اللي ريته قبل وزال
سوف الجين، الأغنية التالية التي تمكن فيها فكرون أن يتفوق على تحديه، هذه المرة من ميراث الاحتلال الإيطالي، بقصيدة للشاعر والمجاهد الليبي أبورويلة المعداني، التي ألقاها في حث الليبيين للجهاد ضد الإيطاليين بعد أن تمكنت القوات الإيطالية من دحر رجال المقاومة، ألقى المعداني أغنيته في وادي سوف الجين بمدينة ورفلة في وسط ليبيا. توفى المعداني في الأربعينيات، ولم يعرف أن شابًا من الجيل الذي يليه، سيخلد قصيدته، يمزجها بألحان غربية تبدأ بموسيقى “الزُكرة” الليبية.
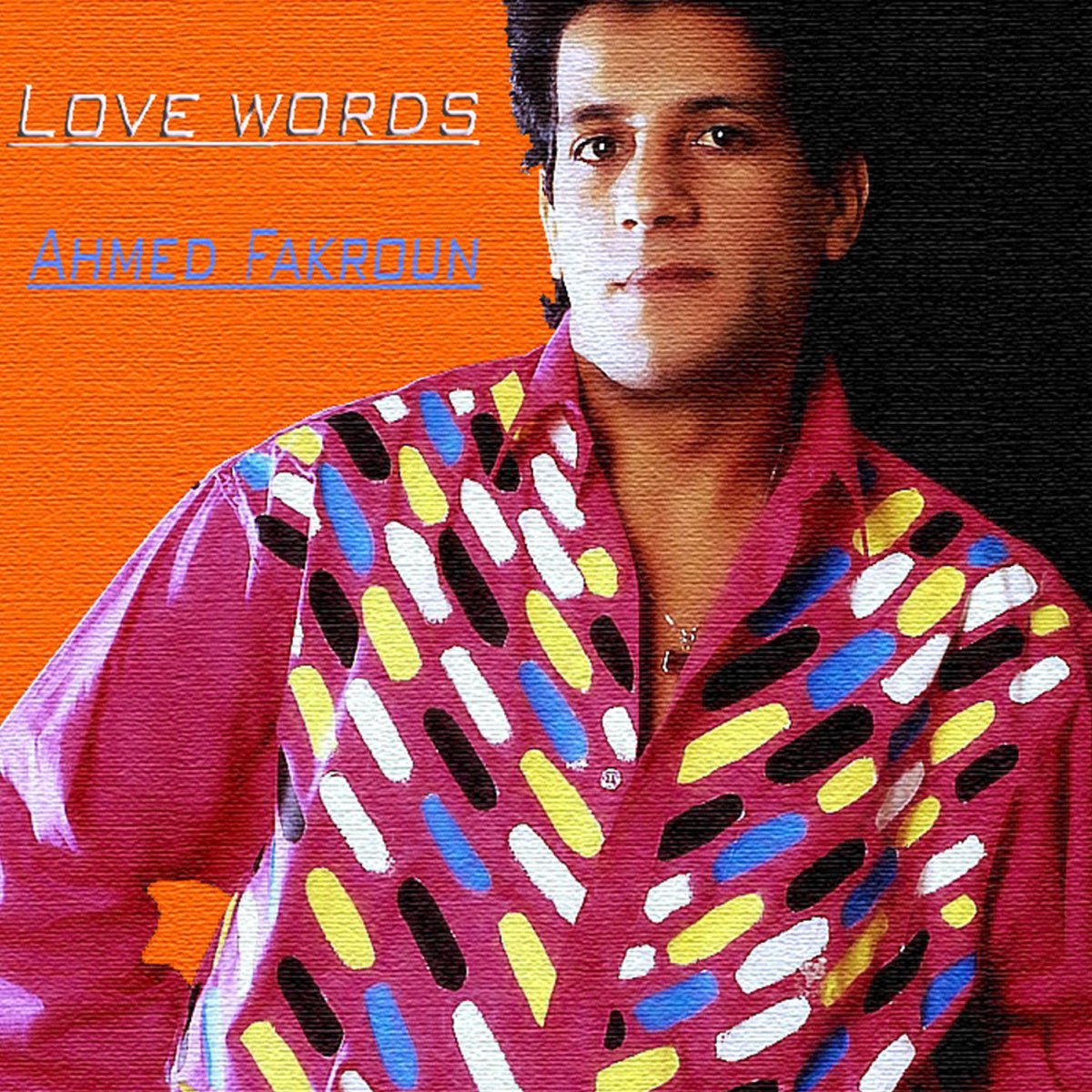
أخذ مني البحث عن الوجه الآخر من فكرون زمنًا، كان وجه يستحق عناء البحث، بحثتُ كثيرًا عن أرشيف أغنياته القديمة على يوتيوب، وفي حفلاته، وفي كل أغنية جديدة أكتشفها، كنتُ أتمنى أنّ تكون “فانك” خالصًا، بعض الأغنيات كانت صعبة التصنيف، لأنها تمزج أشكالاً مختلفة، كأغنية النورس الشبيهة بالسُول، وأغنية “يا ليل ليّل”، كما أنني لستُ ناقدًا موسيقيًا بادئ ذي بدء؛ لأتمكن فعلاً من الادعاء بتصنيفها.
فكرون نفسه، أعاد صياغة مجموعة من أغنياته، بعد أن تحصل على عقود لإعادة إنتاج ما غناه، وأغنية “الشمس” مثال جيد لتحور موسيقى فكرون كالحرباء، وربما اختفاء صوته الشبابي، واكتسابه لخامة أكثر فخامة، وأكثر مناسبة لجو “السول”، جعله يغير من لحن بعض موسيقاه الجديدة. إلا أنه لم يتخل عن إيقاع الفانك الذي تميز به.
أغنٍيات أخرى كانت تمتلك هذا الحس الفانك-فكروني، قِلتي و ” يُمّة يُمة يُمّة“، عوّام وكلمات حب ظهرت مجددًا في آخر ألبومات فكرون المعاد إنتاجها مؤخرًا، يظهر طموح فكرون من ” قِلتي”، طموح وشغف جعلاه لا يتوقف على الغناء، جعله ينتصر على سياسات التهميش وحرق النظام لبيته وسلب ممتلكاته الموسيقية في بداية الثورة الليبية، ويعاود الغناء لأوروبا التي احتضنته قبل عقود، ويسافر عواصمها مغنيًا في حفلات، ويعاود الجمهور الشاب الرقص على ألحانها، على أمل العودة لأرض الوطن ويرقص الليبيون في حفلاته، كما ود أن يفعلوا.