في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

(الفصل الأخير من كتاب سيرة الرواية المحرمة)
بدأنا البث التجريبي لـ”مدينة” بحكاية القاهرة 1959؛ حين كان محمد شعير يبحث عن سيرة الرواية المحرمة: أولاد حارتنا ، وكنا نبحث عن نوع من الكتَّاب والصحفيين يمزجون بين البحث والفن، ليكوِّنا معًا عظم تيار جديد في الميديا.
التقينا مع محمد شعير، وكانت الرحلة الي نشرناها مع رسوم ميجو؛ التي تتخيل القاهرة حين تصارع الجنرالات والضباط على سلطة “تشكيل المجتمع”. ولأنه صراع بلا محتوى غالبًا تحكمه غية التسلط الفارغة، فقد بدأت الحركة كما هي العادة من فعل صغير جدًا: غيرة صحفي من نشر الرواية في الأهرام. الصحفي شاعر أغاني مشهور، حرض شخصًا على إرسال برقية… وهنا تيقظت غريزة القنص لدى طلاب السلطة من الجنرالات والمشايخ.
هذه الحركة المتوترة للسيطرة، فرضت تحكم المنع والتحريم في تشكيل المجتمع الخارج من عصر الاستعمار، وساهمت في تأسيس مواقع المتصارعين على غنيمة” الشعب.”
حين سأل محرر مجلة الجيل نجيب محفوظ عن موضوع روايته المقبلة “أولاد حارتنا”، طلب محفوظ من المحرر أن يعفيه من الكلام عن موضوع الرواية، أجاب: بلاش. اعفني من هذا السؤال، وعندما سأل المحرر عن نوعها، أجاب: ولا هذا.. إنها قصة من نوع جديد، لم أكتب مثله من قبل، لذلك أنا متهيب جدًّا، متهيب جدًّا! كان محفوظ (متهيبًا جدًا) إذًا، لكن هل كان يعرف ماذا سيحدث؟
“الرواية المحرمة” لم تكن محرمة حين نشرت مسلسلة في الأهرام بدءًا بسبتمبر 1059، لكنها صارت محرمة بعد ذلك. لم تنشرها أي دار مصرية وقتها- نشرت في بيروت- أثارت الرواية، غير المنشورة في كتاب، جدلاً استمر طول عقد الستينيات، واستمر محفوظ في الدفاع عن الرواية، والتملص بدبلوماسية من التهم التي ألصقها المنتقدون به، لم يكن المنتقدون هم القراء المعتادون، كانوا كتابًا ونقادًا وسياسيين وصحفيين، ورجال دين بالطبع!
في مايو 1968، وبعد أن طبعت “أولاد حارتنا” في بيروت، أصدر مجمع البحوث الإسلامية أول تقرير يقضي بمنع الرواية، أوصى التقرير نصًّا “بعدم نشر الرواية مطبوعة أو مسموعة أو مرئية”.
في “أولاد حارتنا: سيرة الرواية المحرمة” غاص محمد شعير بين أكوام من الأرشيفات والكتب والشخصيات، ليؤرخ ليس قصة الرواية فقط، بل جانب من سيرة حياة بلاد اعتادت المنع، وتأقلمت على الإخفاء، ولا يمثل لها شيئًا أن تزج بالكتَّاب في السجون، وبالكتب في مفرمة الورق.
محمد شعير لا يتعامل مع الأرشيف بمنطق نباش الجثث، ولا قناص الفرص السهلة. اقترب من موضوع شائك واستهلاكي مثل الرواية الممنوعة؛ أولاد حارتنا، لأشهر أدباء اللغة العربية نجيب محفوظ، دون أن يقع في الفخ. وعبر 317 صفحة من القطع المتوسط قدم رحلة استكشاف ممتعة، تنطلق من مكان قديم ومقفر ليرسم أمام قارئ، ربما يكون منحازًا للمنع أو ضده، خريطة المدينة وحكامها المعلنين والسريين الذين وجهوا سهام سلطاتهم لمنع الرواية من الاكتمال.
ولهذا نحتفى بالهروب من الفخ، وبشهوة الفضول التي بدا أنها اختفت فيما يتعلق بالقاهرة، وبتاريخها، ونحن ننقب عنها كما ننقب عن جسور للمستقبل… نحتفي بالكتاب وصاحبه، وبالدأب والإخلاص، وبمغامرين لا يزال لديهم طاقات للعب في مدينة يبدو من السطح أنها في طريقها للتدمير.
احتفالاً بالكتاب وصاحبه ننشر “الوصايا المنبوذة”؛ الفصل الأخير من الكتاب.
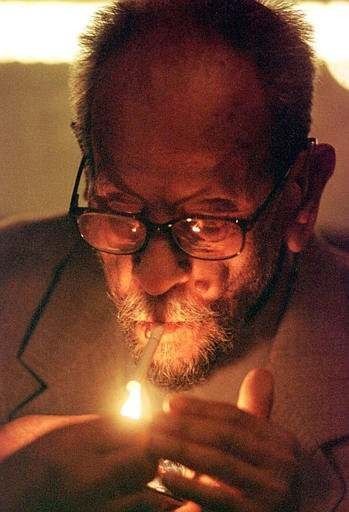
نصيحتان تلقاهما نجيب محفوظ في بداية حياته الأدبية؛ الأولى أثناء التحقيق معه بعد صدور روايته «القاهرة الجديدة».. قال له المحقق: «لماذا تكتب عن فضائح الباشاوات وتعرض نفسك للمشكلات؛ اكتب عن الحب أفضل وأكثر أمنًا».
وكانت الثانية من إبراهيم عبد القادر المازني في اللقاء الوحيد الذي جمعه به، قال له المازني: «إن الذي تكتبه هو الأدب الواقعي، وإن هذا النوع من الأدب يسبب لصاحبه مشاكل كثيرة، والفكرة الشائعة عن الروايات أنها اعترافات شخصية، إذا كنت سوف تستمر في كتابة الأدب الواقعي فسوف تجلب لنفسك المتاعب والمنغصات دون أن تدري». لم يستجب محفوظ للنصيحتين، فلم يكتب عن الحب، وطاردته المتاعب والمنغصات منذ أن بدأ الكتابة.
عندما تسلم؛ من ناشره، عددًا من نسخ روايته الأولى «عبث الأقدار» (1939) حمل واحدة منها إلى بيت الشيخ مصطفى عبد الرازق، أستاذه في قسم الفلسفة بجامعة فؤاد الأول، وهناك وجد مجموعة من شيوخ الأزهر ضيوفًا على الشيخ، عندما أمسكوا بالرواية هاجوا بسبب عنوانها، ارتبك محفوظ إزاء الهجوم ولكن الشيخ تدارك الموقف مدافعًا عن تلميذه.
وعندما أنهى روايته الثانية «رادوبيس» (1943) رفضت الرقابة نشرها باعتبارها «عملًا مهيجًا» لأن الشعب يثور فيها على الملك الذي كان منصرفًا إلى نزواته الشخصية، وطلب الرقيب تغيير خاتمة الرواية. فأوضح محفوظ له أنها مجرد حكاية تاريخية، ومن الصعب تغيير نهايتها لأن في ذلك تشويهًا للتاريخ. فسمحت الرقابة بنشرها؛ خاصة أن الحكايات عن علاقات الملك (فاروق الأول) النسائية لم تكن قد انتشرت بشكل كبير بعد.
بعد صدور روايته «القاهرة الجديدة» (1945) أحيل إلى التحقيق لأنه انتقد فيها الحكومة، وقُرئت الرواية باعتبارها مجرد مقالات تنتقد رجال الحكم. في التحقيق سأله المحقق؛ أحمد حسين – شقيق الدكتور طه حسين -: «ماذا تقصد؟ فأجاب: إنها وقائع خيالية لا أقصد أشخاصًا معينين، هذه رواية مثل التي علمها لنا أخوك طه حسين». وبعد سنوات قليلة وافق محفوظ على تغيير عنوان الرواية إلى «فضيحة في القاهرة» استجابة لطلب إحسان عبد القدوس الذي أراد نشرها في سلسلة «الكتاب الذهبي»، وخشي أن يُفهم من العنوان القديم أن الرواية تنتقد مجتمع الثورة (23 يوليو 1952) الجديد.
وعندما تقدم بروايته «السراب» (1948) للحصول على جائزة مجمع اللغة العربية، رفضها المجمع لأسباب «أخلاقية»، وقال له أحد الأعضاء: «أفهم ما كتبته بوضوح، ولكن بيئتنا هنا لن تقبل ذلك. إننا مؤسسة رسمية، وإذا شجعنا هذا الأدب فإن هذا يعني أننا نعترف رسميًّا به، ونحن لا نستطيع أن نتحمل هذه المسؤولية». ولم تكن تلك هي المشكلة الوحيدة التي سببتها له الرواية، إذ اعتقد أحد رواد مقهى كان يتردد عليه محفوظ وكانت بينهما معرفة أنه يقصده بشخصية بطل الرواية (كامل رؤبة لاظ) العاجز جنسيًّا، فحمل مسدسًا وقرر قتله، فامتنع محفوظ عامًا كاملًا عن المرور بجوار المقهى، ولإنهاء المشكلة اتصل بحامل المسدس الثائر ليشرح له الاختلافات الشاسعة بينه وبين الشخصية الموجودة في الرواية، وطلب منه أن يتأكد من ذلك بقراءة الرواية.

ومر صدور «بداية ونهاية» (1949) بهدوء، ولكن بعد قيام الثورة التقى به أنور السادات في مكتب إحسان عبد القدوس. قال له السادات: «أنا زعلان منك». فقال نجيب: «ليه لا سمح الله؟». فرد السادات معاتبًا: «كيف تجعل الضابط في «بداية ونهاية» ينتحر؟ أنت لا تعرف أن الضابط هو نحن؟».
كما مر نشر «الثلاثية» بهدوء باستثناء بعض المقالات النقدية التي اعتبرته كاتبًا بورجوازيًّا، ولكن محفوظ سيعود في الستينيات ليكتب أجرأ أعماله، رواية تفضح الديكتاتورية، وتنتقد تأميم المجال العام، في تلك المرحلة: «استحوذ الخوف على الناظر ورجاله، فبثوا العيون في الأركان، وفتشوا المساكن والدكاكين، وفرضوا أقسى العقوبات على أتفه الهفوات، وانهالوا بالعصي للنظرة أو النكتة أو الضحكة، حتى باتت الحارة في جو قاتم من الخوف والحقد والإرهاب»؛ كما يكتب محفوظ في «أولاد حارتنا».
غضبت أطراف نافذة في السلطة الناصرية من «ميرامار»، و«ثرثرة فوق النيل» ومن بعض القصص القصيرة الأخرى حتى إن المشير عبد الحكيم عامر أقدم على اعتقاله لولا تدخل عبد الناصر نفسه في اللحظات الأخيرة.
وفي أوائل السبعينيات تعرضت روايتاه: «الكرنك»، و«الحب تحت المطر» لمقص الرقيب الباتر، وطالهما الحذف حد التشويه.

المشير عبد الحكيم عامر وأمامه ميكرفون المذيعة الشهيرة آمال فهمي
مع كل رواية عاصفة، وأزمة، وسط كل العواصف كان محفوظ يحمي نفسه، روايته حيادية، تبدو وكأنها لا تتهم، أو توجِّه، رواية يتحمل أبطالها عبء ما يقولون ويفعلون لا كاتبها، الكاتب هنا مجرد شاهد، حكيم غير متورط، أو إله يراقب ويسخر، ربما لهذا مرت العواصف. ولكن كانت «أولاد حارتنا» استثناءً.
هي رواية مركزية في عالم محفوظ، ما قبلها كان واقعيًا صرفًا، وما بعدها كان محاولات دائمة للتجريب، والابتعاد عن الواقعية الكلاسيكية. وحملت الرواية ما يمكن وصفه بالانتقال من مجتمع الشفاهية إلى الكتابية، حيث يستجيب الراوي لوصية عرفة أحد أبناء الحارة البررة: «أنت من القلة التي تعرف الكتابة، فلماذا لا تكتب حكايات حارتنا؟، إنها تُروى بغير نظام، وتخضع لأهواء الرواة وتحزباتهم، ومن المفيد أن تُسجل بأمانة في وحدة متكاملة ليحسن الانتفاع بها».
سجل الراوي/ محفوظ الحكايات الشفهية المتوارثة ليحكي عن حلمه، بالعدل، وسيادة العلم، حلمه وحلم البشرية كلها بأن تمضي الحياة في الحديقة والناي والغناء، وأن تشهد الحارة مصرع الطغيان، ومشرق النور. كانت الرواية أمثولة لعلاقتنا بالسلطة الجاثمة على أنفاس البشر، سواء أكانت هذه السلطة سياسية أو دينية أو مجتمعية، ومن هنا انزعج الجميع من قدرة رواية على تعريتهم وفضحهم. وصارت الرواية «خطيئة» محفوظ لدى الجميع.
وفي كل الوقائع، كانت «أولاد حارتنا» حالة خاصة، بحسب وصف محفوظ نفسه، لم تعد مجرد رواية طرح فيها أسئلته حول العدل والحرية، بل صارت تمثيلًا لحكايتنا مع السلطة، والرقابة، حكاية المجتمع نفسه وتوقه للتفكير خارج الخطوط الحمراء، صارت الكتاب/ الرمز لمعركة ثقافية واجتماعية وسياسية، لم تنتهِ بعد، بل تتخذ كل فترة شكلًا جديدًا ومثيرًا. وكأن محفوظ وهو يكتب، كان يحقق – دون أن يدري أو يتعمد ذلك – الحلم القديم لكمال عبد الجواد (قرينه/ صورته في الثلاثية بنظر غالبية نقاده).. كان كمال: «يحلم أن يؤلف كتابًا، هذه هي الحقيقة، أي كتاب؟، لن يكون شعرًا، إذا كانت كراسة أسراره تحوي شعرًا، فمرجع ذلك إلى أن عايدة تحيل النثر شعرًا لا إلى شاعرية أصيلة فيه، فالكتاب سيكون نثرًا، وسيكون مجلدًا ضخمًا في حجم القرآن الكريم وشكله، وستحدق بصفحاته هوامش الشرح والتفسير كذلك، ولكن عم يكتب؟ ألم يحوِ القرآن كل شيء؟ لا ينبغي أن ييأس، ليجدن موضوعه يومًا ما، حسبه الآن أنه عرف حجم الكتاب وشكله وهوامشه، أليس كتاب يهز الأرض خيرًا من وظيفة وإن هزت الأرض؟! كل المتعلمين يعرفون سقراط، ولكن من منهم يعرف القضاة الذين حاكموه؟!».
عاش محفوظ، عصور سلاطين، وملوك، ورؤساء، عاصر ثورات وانقلابات، وحروبًا وطواعين، ومآسي.. عايش التقلبات السياسية والمنعطفات الحاسمة، الثورات والأنظمة والحروب، من النكسة إلى الاستنزاف وأكتوبر، من ثورة 19، إلى يوليو، وكامب ديفيد، ومن نوبل إلى الخنجر الغادر الذي استقر في رقبته. استطاع أن يصمد في وجه التقلبات والعواصف والتغيرات التي أصابت المجتمع والثقافة، واستطاع أن يصمد في وجه الحقد الأصولي. واستطاع طوال سنوات عمره التي قاربت قرنًا من الزمان، وحتى بعد رحيله، أيضًا، أن يحافظ على تأثيره وفاعليته؛ ليصبح رمزًا عابرًا للزمان.
تبدلت الموضة وانقلبت المعايير الجمالية، وتغيرت الأسماء، وانسحب كُتَّاب كبار إلى متحف «التاريخ»، فيما ظل هو في مكانه، يثير الاهتمام والإعجاب والجدل الصاخب. قاوم الشيخوخة تارة والسلطات تارة أخرى، وكتاب التقارير وصناع الطغاة، وسكاكين المتطرفين وكل الصعوبات التي كادت تحول بينه وبين الكتابة تارات وتارات.
كانت الاتهامات تزعجه، ولكنه كان يقابلها بضحكة صافية ترتفع بين الحين والآخر. عندما طلب منه أحد الصحفيين أن يتخيل بروفة لحساب الآخرة، وينصب لنفسه ميزانًا أيهما أثقل في ميزانه: الحسنات أم السيئات؟ ضحك محفوظ طويلًا قبل أن يجيب: «أنا لم أقتل في حياتي، ولم أسرق ولم أرتكب إثمًا كبيرًا. كل آثامي صغيرة وخفيفة على الميزان. وإذا كانت الحسنة بعشرة أمثالها فالميزان قطعًا في صفي».
وهكذا ظلت «أولاد حارتنا» في دائرة الضوء، منذ أن نشرت مسلسلة في «الأهرام» في صيف العام 1959 وحتى بعد رحيل محفوظ، عندما صدرت لأول مرة في مصر بمقدمة كأنها صك براءة لاهوتية لعمل فني خيالي.

الكاتب:
محمد شعير
تصميم الغلاف:
أحمد اللباد
الناشر:
دار العين
2018