في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

تمهيد أولي حول فينومينولوجيا المدينة- الجزء الثالث
ظهرت “الحكاية” بوصفها صيغة ترابط معرفي في إطار رهان التمثيل على حفظ وتأكيد ذاته، ومن ثم لا نعنى بالحكاية هنا تلك الممارسات السردية اللغوية التي عادة ما يشير إليها هذا اللفظ، فالحكاية التي نعنيها هي تلك الآلية التي تنتج الترابطات الإبستمولوجية التي تجعل اللغة نفسها ممكنة.
والحكاية هي حالة خاصة للتمثيل، إنها مدونته التي يتم عبرها إجراء وإتاحة كل ما يهدف إلى حفظ وتسجيل واستعادة ما يتعلق بالفعل القابل للتكرار داخل الحدث، ذلك الفعل الذي يشكل لحظة بروز عارم للعب القوى عبر نتوء يطالب بالاستجابة لذاته وإفساح الطريق أمامه، والحكاية تعمل هنا بوصفها شبكة تحاول الإحاطة بهذا البروز، وإطالته، وتأطيره، أي أنها تشكل طليعة التمثيل في التعاطي مع ما يعده النقطة الأكثر كثافة في شبكة تقاطعاته مع عالم القوى.
وهكذا، فضمن فئة متسعة من الممارسات الإنسانية ستحاول “الحكاية” دائمًا أن تضع توقيعها على الفعل القابل للتكرار والذي يشكل حالة مميزة وفريدة في علاقتنا بعالم القوى، ففيما يتعلق بما هو إنساني فإن مجال الفعل يظهر بوصفه منطقة السماح التي تهبها القوى لنا، أو لنقل إنه يأتي بمثابة قطعة أرض منحنا إياها هذا الإقطاعي الكوني لنقوم على زراعتها طبقًا لقوانينه ونظمه وباستخدام موارده وطاقاته ولصالح زيادة استثماراته وثرواته في النهاية، ومن ثم فمع ظهور الحكاية التي ستتصدى لمضاعفة استثمارات القوى في مجال الفعل فإن هذا يعني أننا هنا أمام حالة خاصة لعالم القوى وقد بدأ في الوعي بنفسه، والتصدي لذاته، واستثمار وجوده، وهي حالة موضوعها الرئيسي ومجال حضورها وظهورها هو “نحن”!
ستحاول الحكاية إذن أن تنشط تجاه خلق الترابطات (الاستعارية والكنائية) بين تمثيلات الفعل الإنساني داخل الحدث، وتحفيز طرق استحضاره، ولكنها بوصفها تمثيلاً في النهاية فلن تستطيع أبدًا القبض على حضور هذا الفعل، أو حجبه عن سياقات الإزاحة التي ستوالي الإطاحة به في الفضاء الإبستمولوجي، وهو ما يجعل مجهودها الرئيسي موجهًا ليس تجاه حضور الفعل ذاته، بل تجاه انتظار ظهور هذا الحضور، تجاه استباقه والترقب لاصطياده، أي أنها تخلق مسارًا محددًا ينطوي على مجموعة نقاط ذات طابع اتجاهي يمثل كل منها حدثًا قابل للظهور، بحيث سيبدأ هذا المسار بنقاط مرور تحدد ما يفترض أنه يسبق الفعل أو يمهد لظهوره، يليها نقاط عبور تستحضر الفعل وتستبقيه في مجال حضور الحكاية وتحاول تعريضه لعمليات الإطالة واستحداث المسافات، ثم أخيرًا نقاط وصول ترسم أو تحدد مآله ومصيره أو تهيئ لظهور ما يعقبه من أفعال، وهذه النقاط المترابطة التي ستبدو دائمًا وكأنها أشبه ما تكون بممرات داخلية في فضاء الحكاية هي التي تنتج ما ستدعوه الفينومينولوجيا فيما بعد بالقصد (intention).
إن تشكل الحكاية من النقاط الحدثية المترابطة على هذا النحو سيسمح لها بالتداخل والاندماج والتقاطع والانقسام، مثلما سيتيح لها أن تشكل سلاسل ممتدة من الحكايات المترابطة معًا، أو التي يؤطر بعضها بعضًا، وتلك السلاسل هي المكونات الأساسية لفضاء المعرفة الذي هو في النهاية حالة خاصة لتجمع فئات أو سلاسل الحكايات.
والتمثيل هو ما يخلق تلك النقاط الحدثية ويربط بينها عبر مسافاته أما الحكاية فهي ما تمنح هذه النقاط اتجاها دون غيره بحيث تتوافق تصنيفات وترابطات الحدث مع الفعل الذي تؤسسه الحكاية أو تنتظر لحظة ظهوره لتوجهه داخل مساراتها الخاصة، أما مع امتلاء فضاء المعرفة بسلاسل الحكايات المترابطة فيما بينها بحيث تشكل فضاء متجانس فإن هذا سيدشن إمكان توزيعها أو إعادة تصنيفها إلى نطاقات أو مجالات يتحلق كل منها حول ظاهرة بعينها، وهو ما يفضي إلى اكتمال تكوين فضاء المعرفة بوظائفه التي نألفها.
ويمكن النظر إلى الحكاية بوصفها “جاهزية” (dispositif) للفعل الإنساني، والجاهزية مصطلح يعود إلى الشأن العسكري، مثله مثل مصطلح الطليعة، وقد استخدمه “فوكو” في تحليله حول ميكروفيزياء السلطة، إلا أن المفهوم الذي يقدمه فوكو عن الجاهزية سيبدو دائمًا وكأنه مجرد حالة خاصة مشتقة من مفهوم “هيدجر” عن التقنية. ولسنا بحاجة هنا للخوض في الفارق بين المفهومين، أو بين تقنية الحكاية -على سبيل المثال- وجاهزيتها، ولنكتف بالقول بأن ما هو “جاهزي” لا يكون كذلك إلا بالنسبة إلى شيء آخر محدد وحاضر أو قابل للظهور، بمعنى أنه مجرد تأثير حادث في سياقات حضور بعينها، أي أنه أثر أو نشاط لمجال “حضور ما” ينتج عنه إعادة توزيع علاقات مجال حضور آخر، وبالتالي فما هو “جاهزي” بالنسبة لشيء ما ليس كذلك بالضرورة بالنسبة لغيره.
وكل ما هو جاهزي يعبر في النهاية عن رغبة التمثيل اليائسة في العودة إلى حالة الحضور الممتلئ، وذلك عبر استباق ظهور هذا الحضور والالتقاء معه في نقطة كثافته القصوى، وإعادة توزيعه على نحو يكفل في النهاية المزيد من قدرة التمثيل على استعادته، ومن ثم فما هو جاهزي سيقدم نفسه دائمًا بوصفه ما يمهد للظهور الممكن، وكذلك بوصفه ما يختزن أو يستولي من عالم القوى على إمكانيات تطوير شكل أو امتداد هذا الظهور بغرض ربطه بمجالات حضور بعينها واستثمار طاقاته ومساراته وترابطاته مع ما هو خارجه من المجالات الأخرى. أي أن الجاهزية في النهاية هي نفسها حالة من حالات لعب القوى المستثمر من قبل التمثيل.
إلا أنه بالرغم من كل ذلك فإن “الحكاية” حتى بوصفها جاهزية للفعل الإنساني لن تنجح أبدًا في القبض التام على فعل متعين بذاته، فالفعل الإنساني هو جانب الممارسة المحضة والتي ينتج عنها “التمثل” بوصفه الجانب الابستمولوجي لتلك الممارسة، ومن ثم فحضور الفعل يتمتع بنفس كثافة حضور “التمثل” إن لم نقل أنه يفوقه بمراحل إذ لا يظهر إلا بوصفه استجابة مباشرة لاختلاف قوى أكثر مادية وصخبًا وأقل هدوءًا من تلك التي يستجيب لها التمثل، ولو أن الحكاية قدر لها يوما أن تنجح في القبض على هذا الحضور لاستغرقتها كثافته ولاختفت باختفائه، ولذلك لا تتعاطى الحكاية إلا مع الفعل المزاح عبر عملية “الإطالة”، أو الفعل وقد بدأ في فقد كثافة حضوره وبات ممكنا ربطه بما هو خارجه، ولهذا فالمسار الذي تشقه الحكاية أو تخلقه ويخلقها لا يختص في النهاية بمعالجة فعل متعين، بل يختص بفئة أو طائفة من الأفعال الممكنة التكرار.
وإذا كانت هذه هي لحظة ظهور الحكاية، فإن حضورها المتواتر يحقق نفسه كلما صار من الممكن التقاط فعل ما وهو يخوض لحظة إزاحته أي لحظة احتضاره وإطالته التي تدفعه إلى الترابط مع مسار الحكاية والمرور عبره.
ولسنا بحاجة إلى إعادة التأكيد أن التحليل هنا لا يدور بالضرورة حول الحكاية التي تظهر عبر الوسيط اللغوي (وإن كان يشمله بالطبع)، فالحكاية قد يتم تداولها وتبادلها وتوزيعها ونشر حضورها المتعدي للذات باستخدام وسائط لغوية أو غيرها إلا أن عمليات إنتاج، وإعادة إنتاج مجال حضورها لا تنتمي قطعا إلى ما هو لغوي وحسب، بل العكس هو الصحيح، فالحكاية هي التي تشكل مجال ما هو لغوي وتتيح ظهوره بوصفه حالة خاصة لحضورها. إن الحكاية ستعبر دائمًا كل المجالات الخاصة بحضور الظواهر والأفعال والممارسات – ومنها ما هو لغوي – وستقطعها باستمرار وتؤثر فيها وتتأثر بها، مثلما ستحافظ على ترابطات الفضاء الخاص المكون لها. وهي كلها مهام تؤديها الحكاية بوصفها الحالة العامة لكل الحالات الخاصة التي تنشأ عنها، ومن ثم فما هو لغوي إذن ليس أكثر من حالة خاصة للحكاية وقد أصبحت قابلة للتبادل والتوزيع خارج مجال حضور الذات التي أنتجت داخلها.
أما تلك الاقتراحات التي فرضت هيمنتها عبر العقود السابقة والتي كانت تنادي بما هو لغوي باعتباره الأصل، أو الحالة العامة لكل ما هو معرفي، فهي ليست أكثر من استجابة لطاقة الاندفاع التي خلقتها لحظة كشف هذه الحالات عن الترابطات الجذرية التي تجمعها معا، ولكنها تظل استجابة أكثر يأسًا مما ينبغي عبر رهانها على حصر أو حجز هذه الترابطات داخل مجال اللغة.
ومع وصولنا إلى هذه المرحلة، فربما يكون قد أصبح بحوزتنا ما يكفي (هنا على الأقل) من تحليلات حول حضور الحالة العامة للكتلة فضلاً عن بعض حالاتها الخاصة، وكذلك القدر المناسب من تحليل الحالة العامة للمعرفة بآلياتها المختلفة وبعض حالاتها الخاصة الأساسية، مما يتيح لنا أن نبدأ رحلة صعود تتوجه إلى تلمس المسار الذي قاد إلى إتاحة ذلك الحدث الطارئ الذي دشن ظهور المدينة، وهو ما سنقوم به عبر التأمل في العلاقات المشتركة والمتداخلة بين حضور الكتلة وحضور ما هو معرفي.
الكتلة الأداة والحكاية: وإذا ما عدنا إلى تحليلنا لظهور “الكتلة الأداة” وتطورها فسنجد أنها ناشئة عن ممارسة تقودها حكاية ما حول فعل أصبح تكراره ممكنًا، وهكذا فما إن تسيطر الحكاية على نمط ظهور الفعل وتنجح في اصطياده وإعادة توزيعه واستعادته حتى تبدأ في المطالبة بما يحققه بانتظام في ميدان الممارسة، أي أنها تجبر لعب القوى على أن يبدأ في العمل لصالحها، إن لم نقل أنها منذ هذه اللحظة ستحاول طرح نفسها بوصفها بديلاً له.
صراع القوى: يعد لعب القوى الخصم الأساسي لاختلاف القوى، وبالتالي فهو خصم لكل اختلاف، و لكن بما أن ظهور الاختلاف هو شرط ظهور اللعب، فإن لعب القوى عبر سعيه إلى نفي اختلاف القوى، ومحوه، وتسويته، والمطالبة باختفائه، سيسعى عبر اللحظة نفسها إلى نفي ذاته، وبتر ظهوره عبر القضاء على ما يبرر بقاءه ويمنحه أفق ظهوره، وبالتالي ففي مقابل تقديم اختلاف القوى لنفسه بوصفه ما يسعى دائمًا نحو الظهور ويتطلبه ويخلقه ويستحدثه وينشره ويحفظه، فإن لعب القوى سيقدم نفسه بوصفه ما يسعى إلى العماء ويتطلبه عبر تحقيق الاختفاء وتعميمه و امتصاص كل ما يظهر وإذابته وإعادته مرة أخرى إلى عماء حقل القوى اللامتمايز، وعلى هذا النحو تتشكل دراما صراع القوى التي لا يظهر العالم؛ عالمنا! سوى بوصفه نتاجًا جانبيًّا لبعض الخلل في التوازن بين هذين المصارعين الكونيين، أو باعتباره ما يبقى من محصلة هذا الصراع، وهكذا فليس عالمنا هو ما يظهر وحسب، بل أيضًا ما يفلت من الاختفاء أو ما يتبقى حاضرًا مما يظهر، أي باختصار “ما يحفظ ظهوره” عبر صراع القوى أو على الرغم منه.
وإذا ما استطعنا هنا تكريس ما يلزم من التأمل في طبيعة صراع القوى، والاحتقان الأبدي بين طرفيها، أي اختلاف القوى ولعبها، فسيصبح بمقدورنا عندئذ أن نستوعب حالة الاستثناء الفريدة –كونيًّا– التي تقدمها الكتلة الأداة بوصفها ذلك الكيان الذي دشن بظهوره نشوء تطور غير مسبوق في العلاقة بين طرفي صراع القوى، بحيث فرض عليهما نظامًا يجبرهما على التصالح والعمل معا بتناغم محسوب.
الكتلة الأداة وصراع القوى: ولو أننا تأملنا فيما تتكون منه الكتلة الأداة فلن نجد فيها سوى ما يجعلها كتلة، أي حالة من حالات تعين اختلاف القوى، إلا أنه عندما ننظر إلى مجال حضورها الذي تشكله الحكاية، أو بوصفها مركبًا يجمع بين الكتلة/الحكاية، فسنجدها تقوم بعمل لعب القوى، فهي تنتهك تماسك اختلاف القوى المكون لكتلة أخرى وتجبره على الانصياع لتأثيرها والاستجابة له، وبعبارة أخرى فهي تجلب لعب القوى إلى حيث لم يستطع أن يصل من قبل، في نفس الوقت الذي تجرده فيه من سمته المميزة، أي الانتشار، بحيث تجعله يعمل في منطقة محدودة للغاية، وأيضا لأهداف محددة . وهكذا ستهيمن الكتلة الأداة على صراع القوى وتخفض مجال وجوده ليتحول من حدث كوني إلى امتداد لفعل تم دمجه في الحضور الإنساني، وهو ما أدى إلى استهلال ظهور التاريخ البشري كما نعرفه.
وعلى مستوى محاولات التمثيل في تأطير العالم، وتأطير مجال ظهور القوى سواء باعتبارها اختلافًا أو باعتبارها لعبًا، سيقدم مركب “الحكاية/الكتلة الأداة” أول مجال حضور للذات الإنسانية “الفاعلة” بوصفها ما يتكرر مع الفعل، ثم بوصفها ما يبقى منه أو يستقل عنه، وقد تم توحيد هذا المجال مع الفضاء العام للتمثيل بهدف تأطير كل ما يمت إلى الفعل بصلة عبر تدشين مجال حضور “إلهي” أو ثيولوجي يتكافأ مع عالم القوى بوصفه المصدر لكل فعل، وهو ما نتج عنه ظهور مجال جديد تمامًا للفعل الإنساني، أي مجال “الممارسات الطقسية والتعبدية”، والذي تحتفظ بداياته بعلامات حفرية شديدة الوضوح حول مصدر ظهوره، فالإله قديمًا لم يكتسب قط ظهوره المتعين إلا بوصفه كتلة مصمتة، سواء كتلة طبيعية، أو صنما (دمية)، ولكنه عبر ممارسات الطقس التعبدي سيبدو وكأنه قد حصل على تجويفه الداخلي الذي يمتلئ بطاقة الفعل على نحو يمكن استثارته وإطلاقه تجاه السعي نحو مقاصد بعينها.
ومن ثم نحن هنا أمام سجل أركيولوجي لظهور ما هو إلهي تتأسس طبقته الأولى عبر استعادة حضور الكتلة المجوفة (الطبيعية) بوصفها ما يتلقى الفعل، ثم دمج هذا الحضور مع آلية عمل الكتلة الأداة التي تقوم بإجبار الكتلة المصمتة على إعادة تشكيل ذاتها استجابة لأفعال معينة أي أنها تحيل تلك الكتلة المصمتة إلى كتلة مجوفة، وهو ما يؤدي إلى تراجع لعب القوى بوصفه منتجا لهذا التجويف، أما الطبقة الثانية لهذا السجل الأركيولوجي فهي تمارس شطب الطبقة الأولى وتحذف حضور الكتلة الأداة مثلما تحذف حضور ما يحيل إلى “ما هو طبيعي” في الكتلة المجوفة لتبقي فقط على كتلة مصمتة تنال تجويفها الداخلي وتحقق وضع امتلاءه عبر استجابتها للفعل الإنساني فحسب، أي عبر استجابتها للطقس التعبدي القائم على استحضار “ما هو إلهي”، وهو ما يؤشر إلى بدء محاولة إخلاء الساحة لظهور الفعل الإنساني مستقلاً عن تلك الكتلة الأداة، فعبر الطقس التعبدي سيبدو التمثيل أمام ذاته –وللمرة الأولى– وكأنه هو الذي يقوم بالفعل في الخارج دون واسطة من كتلة ما أو أي شيء آخر، والفعل هنا ليس فعلاً ميتافيزيقيًّا محضًا (مع أنه سيشكل فيما بعد الأساس لكل ما هو ميتافيزيقي) لأن موضوعه الأساسي هو الصنم/الدمية بوصفهما نمطًا من أنماط الكتلة المصمتة التي كانت الموضوع الأساسي لأغلب فئات الفعل الإنساني في هذه المرحلة.
وهكذا، يعزز ظهور الممارسة التعبدية هذا التداخل الذي لن ينفك قط بعد ذلك بين ما يتعلق بالتمثيل وما يتعلق بالفعل، وهو ما أتاح ظهور مجال “أفعال التمثيل” الذي يقدم نفسه بوصفه مصدرًا للفعل ومنافسًا من ثم للعب القوى في قدرته على استحداث استجابة الفعل تجاه الكتلة. وكما رأينا فعبر هذه المرحلة سيتأسس مجال حضور ما هو إلهي في نفس اللحظة التي سيتأسس فيها مجال الحضور الخاص للذات بوصفها فاعلاً، بحيث سيبدو وكأن أحدهما (أي الذات والإله) يأتي بمثابة نتاج لفائض حضور الآخر. وفي هذا الإطار ينبغي أن نلاحظ أننا لا نتحدث هنا عن “ما هو إلهي” بوصفه مفهومًا يتأسس ويتحدد في حقل الممارسات التعبدية فحسب، بل بوصفه ذلك المجال أو الكيان الذي كان يمثل دائمًا الحد الأقصى والذي لا يمكن تجاوزه لما يحضر، أي لمجال الحضور وهو يعاين ويتلمس نهايته أو يعاين أقصى امتداد ممكن لأفقه الخاص.
وكما قادت الحكاية ظهور “الكتلة الأداة” عندما غيرت من طبيعة علاقة الكتلة المصمتة بالحركة، فقد قامت بدور مماثل في ظهور ما هو معماري عبر تغيير علاقة “الكتلة المجوفة” بالفراغ وهو ما أدى أيضًا إلى بدء استدعاء ظهور المدينة، ذلك الظهور الذي تقلب في التاريخ ببطء شديد بوصفه مجرد مشروع حضور مؤجل باستمرار قبل أن يستطيع تحقيق نفسه وأن يستولى على مجال حضور العالم ذاته بالكامل.
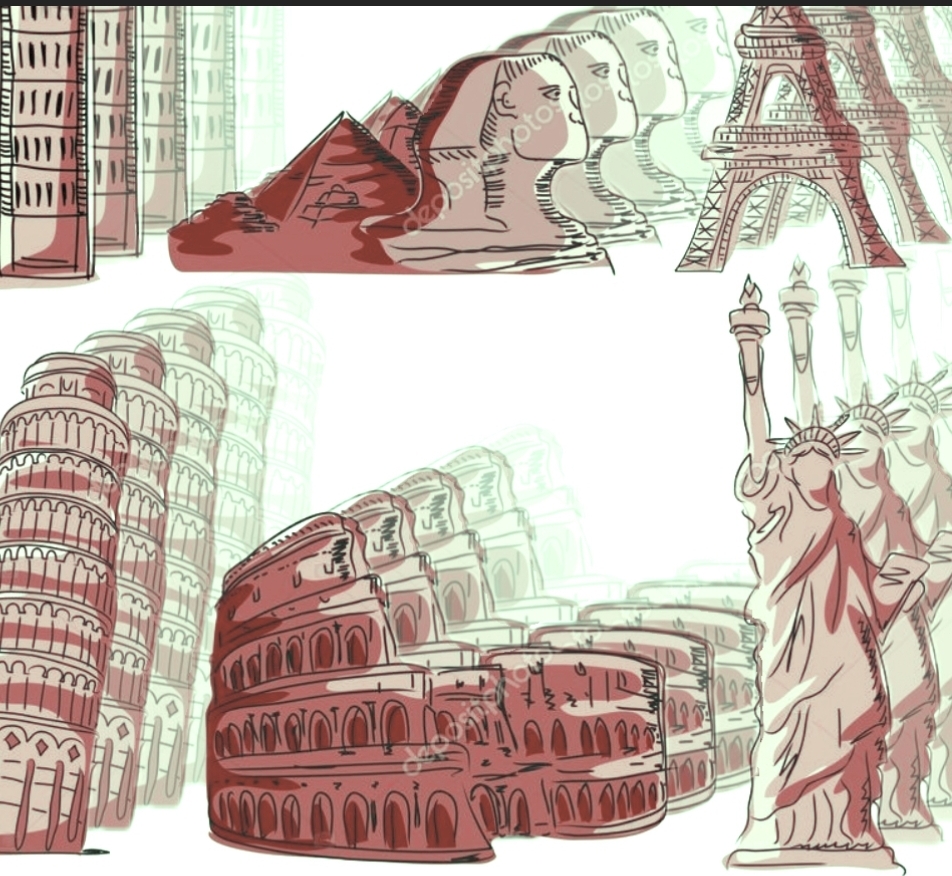
منذ البداية سيقدم المعمار نفسه بوصفه ما يسعى دائمًا لتجاوز ذاته، وسيعرف الفراغ من حوله باعتباره مجرد مسافة تؤدي إليه.
ومثلما يستخدم التمثيل الحكاية بوصفها جاهزية للفعل الإنساني، تعود الحكاية لأداء نفس الدور مع ما هو معماري، وهكذا، ففيما يقوم المعمار على انتهاك الفراغ وإزاحته أمام حضور الكتلة على نحو يؤدي إلى إعادة توزيع علاقات الحضور بالفراغ، ستنزع الحكاية إلى ملء الفراغ الداخلي للكتلة المعمارية بتمثيلات الأفعال الممكنة، بحيث إن المعمار سيتحول إلى جاهزية للفعل، أي أنه سينزع إلى إتاحة وتنمية الحكايات المتعلقة بمجال حضور أفعال معينة على حساب غيرها، وبالتالي فحيث سيخلق المعمار فراغه الداخلي ستحقق الحكاية امتلاءه، وعلى هذا النحو سيتحول الفراغ المعماري إلى فضاء إبستمولوجي محايث لحضور الكتلة، وانطلاقا من هذه اللحظة سيبدأ المعمار في الحضور بوصفه انسحابًا من الفراغ العام واعتراضًا عليه.
ولكن هذا الفراغ المعماري الذي تمت السيطرة عليه سيظل أقل بكثير من طموحات التمثيل، فهو فراغ غير كامل لأنه لا يستطيع استغراق كافة فئات الأفعال الممكنة، كما أنه غير منته لأنه يظل منفتحًا على الفراغ الخارجي اللانهائي، ومن ثم فهو يظل قابلاً للتبدد، ولمقاومة هذه الحالة سيدشن التمثيل حكاية الرحم، والتي ستعمل في الخلفية لقيادة حضور ما هو معماري، ولإكسابه ثقلا إضافيًّا إزاء خفة الفراغ التي توشك على الإطاحة به وابتلاعه.
المعمار والرحم: وعبر استعادة حضور الرحم بوصفه تأطيرًا لمجال حضور المعمار سيجرى إعادة تصنيف الأفعال الإنسانية وفقًا لاستجابتها لذلك الفراغ المحدود الذي جرت أنسنته بالكامل، وهو ما يضعنا أمام سجل أركيولوجي آخر ينبغي أن نتوقف لتحليله.
إن رحم الأم ليس سوى ذلك الفراغ الذي ستنفيه عملية الميلاد، وبمعنى آخر، فالوجود في الرحم مرهون بالسعي تجاه الميلاد، تجاه الحياة، أما صدمة الخروج منه فهي ليست رفضًا للحياة ذاتها، بل محاولة لاستعادة “سيرورة” نقص ما قبل الميلاد، وهي استعادة لا تكترث بالابتهال إلى هذا “النقص” أو نشره كأفق ديمومي ومتعال، بقدر ما هي محاولة لاستحضار حركة ذات أفق ونقطة توجه ملموسة ومعروفة وخالية من المفاجآت، لتصبح بديل أو إطار لحركة ما بعد الميلاد التي ستبدو مفعمة دائمًا بكل ما هو غامض ومتذبذب ولا يمكن الاطمئنان إليه، أي أنها في النهاية مجرد محاولة لتأطير كل ما يتعلق بالحياة عبر استعادة نقطة ظهورها الأولى حيث ستبدو وكأنها تقبل بالتكثف أو التقلص داخل فضاء محدود ومحدد.
إلا أن هذه الاستعادة ستجد الكثير مما يقلقها وهو ما استوجب شطبها عبر طبقة اركيولوجية أخرى تعمل فوقها، ففيما سيقدم الرحم نفسه بوصفه ما يؤهبنا للحياة التي تشكل نقطة انقطاع حضورنا بالنسبة له، فإن المعمار سيجبر على التبدي مفصحًا عن اختلافه الجذري بصدد هذه النقطة بوصفه ما يؤهبنا للموت الذي سيشكل نهاية حضوره بالنسبة لنا، وهنا سيبرز دور الحكاية في حل هذا التعارض وتسوية الاختلافات التي يقوم عليها، وهو ما سيتم عبر دمج بعض هذه الاختلافات في علاقات ترابط تضعها داخل إطار مجال الحضور نفسه، فيما سيجري إزاحة بعضها الآخر عبر استحداث مسافات تباعد بينه وبين مجال حضوره الخاص أو الأولي؛ بحيث يصبح من الممكن استعادته بوصفه عنصرًا في مجال آخر تمامًا، وهذا النشاط التقني للحكاية مطبقًا على مجال الحضور الذي يربط بين المعمار والرحم من جهة، ومباعدًا بين هذا المجال وبين واقعة الموت من جهة أخرى، سيؤدي إلى ظهور مجال حضور عام لما هو إنساني، والذي سيؤطر نفسه بالكامل داخل فضاء ما ينتمي للحياة، أما واقعة الموت التي جرى مباعدتها، ولا يمكن إلغاءها، فلن تجد لنفسها فرصة للحضور إلا بوصفها انفتاحًا على ما هو خارجي، وهو انفتاح يتيح الخروج مثلما يتيح العودة، ومن ثم من الممكن ربطه بأفعال الدخول والخروج المتكررة من وإلى الفراغ الداخلي الخاص بالكيان المعماري، وبذلك نصل إلى المجال الذي تم فيه إنتاج واستعادة ظاهرة “الخلود”، سواء بوصفها عود متكرر إلى مجال الفعل، أو بوصفها بقاءً دائمًا لما يعود، أي للفاعل.
وقد وزع حضور ذلك المجال الناشئ، أي الخلود، بالتساوي على كل من مجال حضور الذات، ومجال حضور ما هو إلهي، فيما سيظل كلاهما محتفظًا ببعض الخصائص التي اكتسبها مع مرحلة الكتلة الأداة، وخاصة ما يتعلق بالقدرة على الفعل. أما خاصية الحضور الإلهي المحدد والمحدود في المكان فهي لا تزال تجد ما يدعمها في ثبات الكيان المعماري ومحدوديته التي لا يمكن الالتفاف عليها، وإن كان هذا الحضور قد تمدد بعض الشيء إلى الخارج ليكافئ خطوط انتشار الفضاء الخارجي للمعمار.
وهكذا فإن الفضاء المشترك لحضور المعمار والحكاية سيدشن ظهور ميتافيزيقا الخلود مستهلاً بذلك سيطرته الكاملة علينا عبر الإلقاء بنا إلى حيث يمكن استعادتنا دائمًا، أي حيث لن يمكننا الإفلات قط، بحيث أصبحنا منذ هذه اللحظة، وبكامل مناحي وجودنا، مجرد عنصر مساعد وثانوي في ميدان صراع القوى وهو يداعب ذاته، أي ميدان ألعاب التمثيل.
المعمار والزمن: غير أن الخلود ليس هو الهبة الوحيدة التي منحنا إياها المعمار، بل هو هبة ثانوية مشتقة من عطائه الأساسي لنا، أي “الزمن” الذي سيظهر هنا مستقلاً عن أي تعين للفعل أو للعب القوى واختلافاتها، فهنا زمن مجرد لا يحدده شيء فيما يحدد هو كل شيء ويظل محافظًا على ذاته وعلى سريانه مهما تغيرت الأفعال أو الأحداث التي يمتلئ بها. وعلى هذا النحو يقدم التمثيل أولى حالاته الفريدة من التأطير الكلي والمطلق للفضاء الذي ينبغي أن يتموضع فيه كل ما يظهر، وهو يقدمه بحيث لا يستطيع صراع القوى –من وجهة نظر التمثيل- أن يطاله أو يؤثر فيه.
وبالرغم من ذلك، فعلى مستوى المكان يظل المعمار البدائي، والقروي، أو إجمالاً معمار ما قبل المدينة، مجرد اعتراض جزئي على الفراغ، أو مجرد انسحاب خجول واعتزال مؤقت لما هو أساسي ولا يمكن تجاهله، فالكثير من الأفعال أو الأنشطة الإنسانية اللازمة لمواصلة الحياة تظل مرتبطة بالحركة في هذا الفراغ الطبيعي العام (الصيد، الرعي، الزراعة.. إلخ)، أي أنها توجد حيث تتلاشى سيطرة المعمار – بوصفه جاهزية- على الفعل الإنساني، وهو ما تتم مقاومته عبر السيطرة على الفضاء الزمني لتلك الأفعال، وكذلك عبر نشر فضاء الحكاية ومجال حضورها حول كيانات المعمار، في كثافة تأخذ بالتخلخل كلما تباعدت المسافات، فهناك حيث سيفقد ما هو معماري حضوره و سيطرته ستعمل الحكاية (أسفل عباءة ما هو زمني) حول مجال حضور الكتلة الأداة فقط.