في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

سيرك مخبول على هامش الزمن والمدينة
مع تتر نهاية فيلم عمر الزهيري “ريش” الحائز على الجائزة الكبرى في مهرجان كان في أسبوع النقاد، يجتاحك فيض جارف من المشاعر المتناقضة والمربكة؛ فالفيلم مليء بالحيل والفخاخ العقلية، ينقلك من حالة الضحك الخافت إلى السكون ثم الصدمة ثم الاندهاش، في حركة دائرية، فما إن تبدأ في الاستغراق في الضحك على مشهد عبثي لقرد يقفز ليلتصق بزجاح سيارة مهرب يغني بصوت قبيح وهو يلاحق ساحرًا وهميًّا حوَّل رجل إلى فرخة، حتى تصطدم بمشهد آخر غارق في القسوة. وربما لو مشيت وراء خيط القصة الرئيسي ستتعاطف مع البطلة الرئيسية التي تمسك بزمام الحبكة من أول الفيلم حتى نهايته الصادمة، ولكن مهلاً، لا أعتقد بأي حال من الأحوال أن الزهيري وهو يصنع فيلمه كان يريدك أن تشاهد حدوتة قهر تقليدية عن بشر مهمشين سحقتهم الظروف وفرمتهم آلة العمل وداسهم وحش البيروقراطية الخرافي.
دعنا من الحبكة أو القصة أو الحدوتة، أو كما تحب أن تسميها، الأمر هنا ليس متعلقًا بالأحداث رغم تسارع الإيقاع وعدم سقوط الفيلم في منزلق البطء أو الترهل. المخرج صنع عالمه شديد الخصوصية مزج فيه ما بين الجدية والتجهم والعبث والسخرية بطعم الخل.
إن بشر عمر الزهيري هم بشر نسيهم الله، كأنهم جوقة ممثلين رُحل يجوبون البلاد غارقين في ثياب رثة، جلدهم تغضن بفعل أحافير الزمن، ثيابهم مبهرجة غير متناسقة باهتة الألوان كأنها ثياب مستعملة تباع على الأرصفة تحت الكباري.
قديمًا وصف زولا في روايته “جرمينال” المنجم الذي يعمل فيه العمال كأنه أخطبوط يمد أذرعه العملاقة يمتص دم الفقراء ويرسله في أنابيب إلى الشركة في المدينة لتنتعش إيرادتها، أما في حالة عمر فالمصنع الذي يتموضع في خلفية الأحداث كأنه تنين خرافي عجوز، منهك قبيح الملامح ينفث من منخاره دخانًا سامًا مترعًا بالرصاص يتسرب إلى داخل منزل الأسرة فيسمم الجو ويعمق ملامح الإرهاق والشحوب البادية على الوجوه المتعبة، عبر مشاهد ملونة بعناية شديدة يسيطر عليها اللون الأصفر، لون التراب والغبار والفقر، احتفظت الكادرات بخصوصية لونية مبهرجة ومتنافرة وإن علاها التراب، في الانتقال من مشاهد الاحتفال ثم مشاهد البحث المضني مرورًا بمشاهد محاولات الإيقاع بالمرأة ورحلة البحث عن حل لأزمة الزوج، ثم البحث عن عمل، يستعرض الفيلم أماكن شديدة الواقعية، ولكنها شديدة الغرائبية في نفس الوقت، ربما وجدت في مكان ما أو زمان ما ولكنها مبعثرة في الذاكرة فأعاد الفيلم تشييدها كي يجد المشاهد صعوبة في استدعاء عوالم مشابهة مكتملة من ذاكرته. وضع الفيلم قواعده لعب جديدة ربما شاهدنا أجواء شبيهة في أفلام المخرجين روي أندرسون أو أكي كياروزماكي مع إضافة صبغة شديدة المحلية في “ريش”.
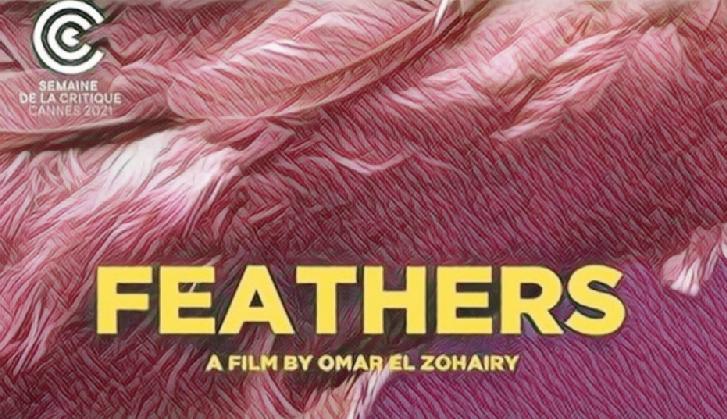
الخلطة التي صنع منها الفيلم تفرض أسلوبية جديدة هي خلاصة وعصارة خبرات مختلفة وعوالم متعددة لا تتعالى عن المنتج الفني المصري في كل تجلياته؛ حتى مسرح القطاع الخاص الساخر أو برامج الكاميرا الخفية، أو حتى الفنون البسيطة كالساحر والسيرك والأراجوز. والكاركترات والوجوه والأماكن كلها تشبه أماكن قابعة في الذاكرة ولكنها لها شكلها الخاص. والسيارات المستخدمة تنتمي لحقبة زمانية معينة، ولكنك تعجز كمشاهد عن الإمساك بخيط الزمن، فالزمن قابع في ذهن الزهيري وحده، والمؤدون من اختياره، معظمهم لم يسبق لهم أن مثلوا أو ظهروا أمام كاميرا من قبل.. اختارهم بروح صاحب سيرك جوال أو مدير جوقة مسرحية تؤدي عروضًا في الشوارع، أو فنان مخبول يملك عربة شعبية مزينة بلمبات إضاءة نصفها معطوب والنصف الأخر تتراقص إضاءته، يمسك عصا عاجية يصرخ في الجمهور، يضحكه، يسخر منه، يفرقع بعصاه في الهواء فتخرج جوقته من العربة تؤدي مشاهد تثير السخرية، لكنها تثير الهلع والحزن والتقزز في نفس اللحظة، وكأنك بصريًّا دخلت عالم المخرج البولندي هاس في فيلم مصحة الساعة الزجاجية0 (The Hourglass sanatorium)
ويفاجئك الزهيري عندما تعرف أنه اختار بعضًا من ممثليه الذين ظهروا في لقطات خاطفة من رؤيتهم في الشارع بالمصادفة، وذلك لكي تكتمل صورة العالم الذي شيده في خياله وأخرجه على الشاشة بقواعده.
تسلح فيلم “ريش” بالعبث ليرسم واقعًا حياتيًّا مزريًا. هو فيلم لا يمجد الفقر ولا يرى فيه جماليات بل يحتقره ويبصق عليه. رغم أن التداعي المهيمن على روح الفيلم قد شيِّد بقدر من الدقة، حتى إنك قد تمسك نفسك متلبسًا بالإعجاب بجماليات التداعي، فإنه لا ينحاز للقبح بل يجسد الفقر والقهر بسوريالية شديدة الدراما ثرية بصريًّا بشكل صادم وغاطس حتى أذنيه في قار السخرية اللزج.
بعد مشاهدتك للفيلم لا ريب أنك ستحاول لا إراديًّا أن تنفض عن ثيابك غبار دخان المصانع الذي أعمى أبطال الفيلم، أو تمسح عن شفتيك السائل الأبيض الذي انساب من الزوج الذي أفقده الساحر في ليلة عبثية آدميته، وحوَّله إلى فرخة ثم أصبح تمثالاً ميتًا بلا حراك.
هل موقع الأحداث التي جرت كان على هامش المدينة؟ هل المكان يشبه الأحزمة التي تطوق مدننا الخانقة؟ نعم بكل تأكيد، وبلا أدني شك هناك أماكن أكثر بؤسًا وبشاعة وانحطاطًا من التي ظهرت في ريش، ولكنها في ريش كانت أكثر وضوحًا، إذ ضرب فيها الزهيري فرشاة ألوانه فوق الواقع الذي علاه التراب. وشخوص الفيلم كائنات ميكانيكية حوَّلتهم الآلة الرأسمالية إلى روبوتات خربة تذكرك بجملة أتت على لسان أحد شخصيات قصص “بشر نسيهم الله” لألبير قصيري “إن أنوار ما يسمى بالحضارة قد أعمتنا وحولتنا لمجموعة من العميان يتخبطون”.
ربما عمل مخرج “ريش” فترة طويلة في عالم الإعلانات جعله يتفرس كثيرًا في الوجوه ويدقق فيها ويتعامل معها كشخص مهووس بجمع التحف واللوحات والقطع الفنية، ولذلك عندما بدأ مشروعه السينما الطويل الأول “ريش” كان عليه أن يرتحل ويسافر إلى قرى وصعيد مصر ويبحث عن ممثلين أغلبهم لم يسبق له أن وقف أمام الكاميرا. كان يريد وجوهًا تصلح للعب بقواعده الخاصة، وجوهًا موجودة في خياله، ولم يسبق لأحد أن شاهدها من قبل وهنا كانت البراعة والحذق، وكان الخلطة التي مزجت ما بين العبث والدراما أو التي جعلت العبث واقعًا ممكنًا، كما قال أحد النقاد المرموقين تعليقًا على الفيلم، وأزيد عليه أن الفيلم هو شريط سوريالي عمق مرارة الحقيقة.


حافظت الشخصية الرئيسية طول الفيلم على جمود ملامحها التي تشي ببؤس غائر كبئر لا قرار له.. الزوج رجل متسلط بخيل شحيح منسحق أمام رئيسه يحاول أن يمارس سلطة عبثية بلا عقل، وفي أحد أكثر المشاهد عبثًا وتفجيرًا للضحك يشترى نافورة بلاستيكية عجيبة الشكل يضعها في وسط بيته البائس الجدب ويكرر جملة “بتدي شكل جميل وفي نفس الوقت شيك” بينما يعيش زوجته وأطفاله في فقر مدقع، ولكنه اهتم أن تكون عنده نافورة بتدي شكل للمكان وفي نفس الوقت شيك. بعد أن يتحول الزوج إلى فرخة بفعل خطأ من ساحر محلي غريب، تُجبَر الزوجة على رحلة قاسية تحاول فيها تعويض غياب الأب.. هذه الأوديسا البائسة للمرأة التي لا تحمل اسمًا، بل وجهًا يحمل بؤس الكون وهي تنتقل من مكان لآخر تجابه الثقب والفراغ الذي تركه الزوج بعد أن مُسخ لطائر. تلتقي رجالاً عابثين يشبهون مهرجي السيرك، يلعبون البلياردو ويثرثرون ويتحرشون ويغنون بصوت قبيح أو يجلسون يحدقون في الفراغ بلا مبالاة.. تنظف أرضيات بيوت قاسية، وتتعرض للطرد، ويقول لها رجل لا نلمح وجهه بوضوح ولكن بصوت معدني وإلقاء مفتعل “حركة غبية جدًا جدًا.. ملفك حيتبعت للبوليس ومش حتشتغلي في بيوت محترمة تاني”. وتذهب في مشهد مرعب لا يبارح الذاكرة لتعالج الفرخة في مستشفى بيطري أشبه بمشرحة شبه مهجورة تُقطع فيها جثث الموتى وتلقى للجوارح.
يستكمل الزهيري سخريته المريرة وجلده للبيروقراطية الجوفاء التي بدأها في فيلم القصير السابق “افتتاح الحمام”(ما بعد وضع حجر الاساس لمشروع الحمام بالكيلو 375) حيث لا ترحم مقصلة البيروقراطية أحد، وبدم بارد يتخلى زملاء العمل عن زميلهم الذي تحول لفرخة كي يتم إثبات أنه هو الفرخة، أو أن هناك أي علاقة تربطه بالكائن الذي مسخه الساحر الفاشل.
هنا يكتمل الموازييك لسلطة يمارسها بشر متداعون في أماكن علاها الصدأ، ومكاتب نخرها السوس وأوراق حكومية بالية أطرافها متآكلة، ويسيطر اللون الأصفر عليها، وكأنما الزمن قد بال عليها، ولا ينسى الزهيري أن يضع عليها شعارات تفجر السخرية أكثر كشعار الطاقة الذرية.
أن تأكل البيج ماك في كشك صدأ قريب من شريط قطار أو يقفز قرد على زجاج سيارتك، أو يشعل رجل فجأة النار في نفسه، كلها مشاهد تقفز من خلفك، ومن أمامك وتباغتك طول الفيلم الذي استعان الزهيري فيه بشريط صوت قد يبدو للوهلة الأولى متنافرًا مع المكان والزمان والحدث، ولكن الحقيقة أنه يعمق أكثر وأكثر الدراما العبثية لهؤلاء البشر الذي نسيهم الله. فمن الصعب أن تنسى موسيقى عمر خورشيد التي تعزف في الفضاء الموحش المحيط بالمصنع، أو جورج وسوف وهو يغني أغنية نجاة الصغيرة في قهوة يرتادها عجائز أشبه بالموتى، أو المحب الولهان الذي استغل غياب صديقه ليغازل زوجته المكلومة بصوت أجش خشن، ويغني لها أغنية على وش القمر على صوت القمر على كل الشجر حكتبلك يا حبيبي، هكتبلك ع الشوارع وع الفجر اللي راجع. وموسيقى حكايتي مع الزمان بنفس مختلف تصاحب رحلة البطلة وتعطي لها بُعدًا ملحميًّا شعبيًّا.
هذا الفقر غير المفهوم الذي يخنق العالم وهذه البيروقراطية التي تقبع فوق أنفاسنا كمؤخرة قرد سمين، فلا مكان هنا لتمجيد الفقر، ولا الاحتفاء بشظف العيش، وإنما دفعك دفعًا لكراهية الظلم والتسلط والبيروقراطية والبؤس والتلوث الذي يحيط بالمدينة في فرجة بصرية وقصة تمزج ما بين الجدية والعبث أو لنسميها مجازًا “ميلانكوليا عبثية شديدة الجدية تفجر الضحك وتثير الأسى وتلطم المشاهد على وجهه”.