في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

في مجلتنا الجديدة نشاركك مقالات وأفكار تبحث عن الجمال والحرية، وتفتح مساحات لاكتشاف سرديات جديدة بعيدًا عن القوالب الجاهزة.

زلة لسان مدفوعة بالغرور، دفعت أحمد مراد إلى ارتكاب الإثم الثقافي الأكبر؛ وهو “البحبحة في الكلام” عن أعمال نجيب محفوظ. وإذا كان الشعراوي عند عموم المصريين نصبًا ورمزًا من العجوة، فنجيب محفوظ عند عموم وهوامش الإنتلݘنسيا المصرية وإعلامها نصب آخر لا يجوز في حضرته إلا التهليل.
مراد الذي يطمح أن يكون نصبًا هو الآخر، ظن أنه قد صعد سلم المجد وتربع على سطوح الرموز الثقافية، وأصبح في موقع يؤهله لتقييم الرموز والأصنام الأخرى، لكن حينما بدأ الهجوم عليه بسبب تصريحاته، تراجع وظهر في الفيديوهات والبرامج معتذرًا ملقيًا بالتهمة على الصحافة، ثم أصدر أخيرًا بيانًا أعلن فيه توكيل محاميه بمقاضاة كل من يتكلم أو يلوك سيرته، من أشباه المثقفين ومعاول الهدم التي لا تفيد المجتمع.
فكيف وصلنا إلى هذا المشهد الختامي الهزلي من المسرحية المسماة “البست سيلر” في مواجهة الرموز الثقافية. كل هذا وعشرات الألغاز الأخرى في الفقرات المقبلة.
1
في مقال زينة الحلبي “العنف المضمر في النقد الأدبي المعاصر“ تتوقف عند لقاء تليفزيوني قديم يجمع عميد الأدب العربي طه حسين بمجموعة من الكتاب الشباب وقتها؛ منهم يوسف السباعي وأنيس منصور ونجيب محفوظ. في اللقاء يوجه طه حسين نقدًا قاسيًا لهؤلاء الكتاب بسبب ما اعتبره جهلهم بتراث الأدب العربي. وتري زينة في اللقاء “دلالات عدَّة حول مكوّنات الخطاب النقدي كما تجلى في تلك المرحلة. فقد جسَّد طه حسين في الحلقة دور الأديب الذي راكم رأس مال رمزيًّا لا يخوِّله الحكم على من جاء بعده وحسب، بل أيضًا تأديب كل من خرج عن النهج الأدبي الذي وضعه، أي الانغماس العضوي بالتراث العربي واستقاء مكوِّنات منه تنهض بالعرب نحو حداثة قائمة على التواصل مع لغات الغرب وآدابه“. وهو الدور الذي يعتبر امتدادًا لعلاقة الشيخ بمريديه في جامعة الأزهر.
استمرت علاقة الأستاذ بمريديه بعد طه حسين، فنجيب محفوظ نفسه تحوَّل لأيقونة التف حولها كُتَّاب جيل الستينيات؛ جميعهم ظهروا تحت إشراف آباء قدموهم إلى الحياة الثقافية مهما كانت حالات تمردهم. فرواية “تلك الرائحة” لصنع الله إبراهيم على سبيل المثال، ظهرت بمقدمة ليوسف إدريس ويحيي حقي. ولعبت علاقات الأستاذ والمريد دورًا أساسيًّا في وعي جيل الستينيات. واستمر هذا النمط من علاقات القوة الثقافية في الأجيال التالية حتى تضاءل تأثيره وتلاشي تقريبًا مع جيل التسعينيات الذي رفع شعار “قتل الأب”.
استبدل جيل التسعينيات من الكتاب بعلاقة الأستاذ بالمريد، نمطًا آخر من الجماعات أو “الشلل الأدبية”. ومع دخولنا الألفية كانت المؤسسات الثقافية قد تخشبت وابتعدت عن دوائر التأثير. فالنقد الأكاديمي انغلق على ذاته في الجامعة. وبدلًا من النشر من خلال وزارة الثقافة ومعاييرها الأدبية ظهرت دور النشر الخاصة، أو كما تستشهد زينة الحلبي بتيريزا بيبي “ابتعاد الكُتَّاب الجدد عن دور النشر الرسمية، وخوضهم غمار روايتهم الأولى في دور نشر صغيرة هامشية محدودة الانتشار. فأدى التحول في اقتصاد النشر في مصر إلى تكاثر نصوص سردية تضع العامية في صلب النقد السياسي. لعلّ أبرز هذه التجارب اللغوية وأكثرها إثارة للسجال هي أن تكون عباس العبد (2003) لأحمد العايدي، ولصوص متقاعدون (2009) لحمدي أبو جليل، ونساء الكرنتينا لنائل الطوخي (2013)، وغيرها من الروايات التي أضاءت فيها العامية على سرديات طبقية ومحلية كانت قد شذَّت عن أقانيم المكرس الأدبي العربي”.

الطبعة الأولى من رواية أحمد مراد الأولى وعلى الغلاف تصنيف “رواية سينمائية” الذي جري حذفه في الطبعات التالية
كل هذا التجارب خرجت من دار نشر ميريت، التي كانت معملًا لتفريغ عشرات التجارب الأدبية المختلفة والمتنوعة. لا فقط ما ذكرته زينة في مقالها بل تجارب أخرى أقل تجريبًا وأكثر ميلًا إلى السرد الخطي واللغة الفصحى والبناء الدرامي البسيط، مثل أعمال علاء الأسواني، وعز الدين فشير، ويوسف زيدان، وأحمد مراد الذي نشر روايته الأولى من خلال دار ميريت للنشر.
بدأ مراد مختلفًا حتى وسط هذا الجيل. فقد اختار لروايته الأولى “فيرتيجو” قالب الرواية البوليسية الذي كان مهجورًا في الأدب العربي. لم يلتفت أحد إلى تلك الرواية في البداية إلا صنع الله إبراهيم؛ الذي أعجب باختيار مراد للقالب البوليسي، ووفقًا لشهادة أحمد مراد نفسه كان لاهتمام صنع الله بروايته أثر كبير في نفسه، حتى أن صنع الله هو من نظَّم أول ندوة لمناقشة رواية مراد.
استمر مراد في القالب البوليسي في روايته التالية “تراب الماس”. وحققت نجاحًا معقولًا، لكنها لم تصل إلى “البست سيلر” الذي كان محجوزًا في ذلك الوقت لروايات علاء الأسواني، وروايات النميمة السياسية والكتابة الساخرة.
في عام 2010 قابلت أحمد مراد للمرة الأولى لإجراء حوار معه حول روايته “تراب الماس”. ومثل صنع الله رأيت أن تفرده ينبع من هذا الخط البوليسي في أعماله، لكني تفاجأت في أثناء الحوار من غضبه الشديد لهذا التوصيف، إذ رد قائلًا “لست كاتبًا بوليسيًّا، لا أريد أن أسجن نفسي داخل قالب محدد، وفكرة الريادة التي أشار لها أستاذ صنع الله، ربما يقصد بها أن الرواية تتماشي إلى حد كبير مع “استيل” روايات الإثارة العالمية. لكن تراب الماس ليست رواية بوليسية، فالرواية البوليسية تركيبها أبسط من “تراب الماس”، في الرواية البوليسية ليس مهمًا التعرف على نفسية البطل، هواجسه، أحلامه، أو العوامل التاريخية التي ساهمت في صياغة شخصيته على العكس من رواية تراب الماس، التي أوليت فيها اهتمامًا كبيرًا لتشريح التركيب النفسي لأبطال العمل. أعتقد أن الوصف الأكثر دقة عن الرواية أنها رواية مغلفة بالإثارة أكثر من كونها رواية بوليسية”.
في حواري معه منذ أكثر من تسع سنوات، بدا واضحًا رغبة مراد في الانتماء إلى تيار أدبي، ورفضه توصيفات كاتب “البست سيلر” أو الكاتب البوليسي، في أكثر من جزء في حوارنا أكد على انتمائه لهذا الموجة الروائية الجديدة فهو ليس كاتب عابر. وعلى الرغم من دراسته السينما كان يرى فيها عنصرًا يساعده على كتابة الرواية، وحين تناقشنا في المشهدية والوصف الذي يغرق به روايته، سألته لماذا لا يكتب روايته للسينما مباشرة، فكان رده الذي سجلته “لا يوجد لدى مانع من تحويل الرواية إلى عمل سينمائي، لكن لا أريد أن أقوم أنا بهذه الخطوة، بالنسبة لي هناك الكثير من الأشياء التي يمكن ذكرها أو الكتابة عنها في الرواية لا يمكن ذكرها في السيناريو السينمائي، لذلك أنا أفضل كتابة الرواية أما تحويلها لعمل سينمائي فهو أمر مرحب به بشرط ألا أقوم أنا بكتابته”.
طبعا لم يحدث هذا، فجميع روايات مراد التي تحوَّلت إلى مسلسلات أو أفلام كتب هو السيناريو لها، وأمام النجاح الذي لاقته أعماله تحول لكتابة سيناريوهات المزيد من الأفلام. أما الرواية فقد هجر الأدب البوليسي ليتحول لكتابة الروايات التاريخية.
2
نبذ الوسط الأدبي مراد، تعاملوا معه بشكلٍ هامشي، وكان هو بطبعه بعيدًا عن دوائرهم الاجتماعية. يظهر مراد في بعض الصور القديمة في دار ميريت مع كُتَّاب التسعينيات والجيل التالي، لكنه يختفي من تلك الصور بعد 2011، إذ انتقل إلى طبقة أخرى، أو تحول هو لشخص آخر.
صدرت الطبعة الأولى من روايته “فيرتيجو” وعلى غلافها تصنيف (رواية سينمائية)، وكأنها كتف قانونية من الجماعة الثقافية بوضع مراد خارج مسار الأدب الرفيع. وفي الطبعات اللاحقة بعدما حققت الرواية نجاحًا تجاريًّا رفض مراد تصنيف رواية سينمائية، فصدرت بقية الطبعات دونه، لكنه على ما يبدو أعجبه المصطلح النقدي؛ فواظب على استخدامه في أكثر من حوار، واصفًا نفسه بأنه ابن “جيل الرواية السينمائية”.
في بدايته كان مراد مهذبًا في ردوده على النقاد، لكنه مع النجاح التجاري اكتسب الجرأة، وانتقل من الدفاع عن نفسه إلى الهجوم. في كل ندوة أو حديث تليفزيوني ينتظر مراد متحفظًا السؤال المتكرر من المحاور “هل تهتم بالنقد؟” فيرد الردود نفسها: لا أهتم بالنقد لأنه مجرد قارئ من آلاف القراء… أنا أكتب لخدمة القارئ… الكُتَّاب في مصر انفصلوا عن الواقع في السبعينيات والثمانينيات، لكننا الجيل الذي أعاد الناس إلى القراءة.
3
حين قابلت أحمد مراد منذ أكثر من تسع سنوات، قبل ركوبه موجة البست سيلر، طلب أن نلتقي في كافيه “سيلانترو”. وعلى مدى عملي لأكثر من 15 عامًا في الصحافة الثقافية لم أقابل أي كاتب غير أحمد مراد في مثل هذه الكافيهات؛ التي ظهرت كأماكن لطبقة متوسطة جديدة تفصل نفسها عن المقهى البلدي العادي. هل لتفضيل مراد للـ”كافيه” عن المقهى أو البار، سبب آخر في حقد المثقفين والكُتَّاب على مراد؟ أم أنه اختيار يعبر عن سر خفي داخل مراد الذي وصف نفسه ذات مرة بــ”دكتور جيكل ومستر هايد“.
في نهاية حوارنا، وفي الدردشة الأخيرة قبل الوداع، رمى لي مراد معلومة أنه يعمل مُصورًا في رئاسة الجمهورية. لم آخذ الأمر على محمل الجد وقتها، بل إنني لم أصدقها إلا بعد قيام ثورة يناير؛ إذ ظهر في حوار مع صحيفة الجارديان وتحدث عن ازدواجية حياته، قائلًا “كنت أحس بنفسي مثل دكتور جيكل ومستر هايد، شخص بحياة مزدوجة: في النهار أقضي وقتي في أوساط حسني مبارك، الرجل الذى دفن أحلام المصريين على مدى ثلاثة عقود، وفى الليل أستمع إلى أصدقائي يلعنونه ويشتمونه”.
4
كنت صحفيًّا تحت التدريب؛ في الشتاء أتابع دراستي، وفي الصيف أحاول تعلم وممارسة أساسيات الصحافة في أخبار الأدب. قررت منفردًا القيام بخطوة ومجازفة؛ اتصلت بد.أحمد خالد توفيق. كنا في صيف عام 2004، عرَّفته بنفسي، وطلبت إجراء حوار صحفي معه. كنت أحادثه من منزل أسرتي في المنصورة، فاقترح أن نلتقي في طنطا حيث يسكن ويعمل.
نزلت من الميكروباص لأجده في انتظاري في الموقف. ذهبنا إلى قهوة قريبة من الموقف، كان الجميع في المقهى يعرفونه، واستغربوا قدومه في غير موعده. جلست في رهبة أمامه، عزم عليَّ بسجائر من علبته. دار الدخان والمشروبات. وفي منتصف الحوار عبر عن زهقه من “القعدة”، فاقترح أن “نكروز” بالسيارة. قاد السيارة في شوارع طنطا، ونحن نستمع إلى أغنيات وموسيقي من حقبة السبعينيات. نصف الحوار تحدثنا فقط عن الموسيقى؛ بداية من فريقه المفضل “البيتلز” وأغنيات عبد الحليم حافظ، اعتذر لي قائلًا إن لديه هذه الأيام شغفًا بأغنية “المسيح” لعبد الحليم حافظ. وسحبتنا تلك الأغنية، التي مُنعت إذاعتها لفترة لأسباب دينية، إلى الحديث عن الرقابة، فاعترف لي وقتها بأنه يفرض رقابة صارمة على نفسه في أثناء الكتابة “أنا أكتب لمراهقين، وكتبي تدخل كل البيوت، لا أريد أن أفتح مواضيع خلافية لهم، لكني أرمي لهم إشارات لأبواب ومسارات أخرى“. أخبرني أن أكثر مشاريعه قربًا إلى قلبه سلسلة روايات عالمية؛ وهي ترجمات مختصرة لعدد من كلاسيكيات الأدب، لهذا الغرض لأنها يراها كأبواب يفتحها لقراءه من المراهقين والشباب.
تحدَّث عن اكتشافه مبكرًا لأدب إدجار آلان بو، والبعد القوطي في قصائده وقصصه، وهو ما قاده بعد ذلك إلى لافكرافت؛ كاتبه المفضل.
لكن بعيدًا عن روايات الجيب قال إن لديه مشروع رواية للكبار، وأنها متعته الحقيقة. لكنه حائر في نشرها، فبالطبع لن يتمكن من نشرها لدي المؤسسة العربية الحديثة.
تحدثنا في هذا الحوار كثيرًا عن اللعب في الأدب والكتابة، بالنسبة له كان أفضل ما يقدمه قالب روايات مصرية للجيب، هو حرية التجريب؛ ففي كل رواية يسعى لتجربة شكل وأسلوب فني مختلف في البناء والتركيب. وبشغف تطرقنا إلى الروايات التفاعلية التي يمكن أن يشارك فيها القارئ في اختيار مسار الأحداث.
ثم في منتصف حديثنا، أخبرني بابتسامة أن هذا الحوار لن ينشر. وبحماسة الشباب قلت له مستحيل، فقال إن هذا لا يزعجه ولن يزعجه؛ فهو على هامش التيار الثقافي والأدبي، كما أن المؤسسة الأدبية المصرية لم تعترف بعد بأدب النوع مثل الروايات البوليسية أو روايات الرعب.
وكما تنبأ لم ينشر الحوار في أخبار الأدب، ولم أفهم حديثه عن إقطاعيات ومسارات الوسط الأدبي إلا بعد ذلك بسنوات. كان واعيًا لموقعه، وما يصنعه، وحينما قرر الانتقال من أدب المراهقين إلى الأدب الذي يحبه ويكتبه حرًا، اتجه أيضًا إلى دار ميريت؛ حيث نشرت هناك روايته الأولى “يوتوبيا”، ثم تلتها أعمال أخرى؛ منها ترجمات لروايات عالمية، وهذه المرة ترجمات كاملة بالجنس والسياسية.
5
انتقل أحمد مراد من دار ميريت إلى دار الشروق، بينما ظلت علاقته التقديرية بصنع الله إبراهيم قائمة؛ إذ صمم أغلفة الطبعات الجديدة من أعمال صنع الله إبراهيم؛ في تجسيد لحالة صداقة فريدة جمعت بين اثنين. رأى صنع الله في مراد مغامرة فنية في اختياره الأدب البوليسي، ووصف روايته الأولى “فيرتيجو“ بأنها “رواية تأسيسية لجنس من الكتابة غير موجود في أدبنا العربي، وهو الأدب البوليسي، فلا يوجد في أدبنا المعاصر رواية بوليسية بالمقومات التي نعرفها في الرواية العالمية، كما لا توجد لدينا روايات جاسوسية باستثناء ما كتبه الراحل صالح مرسي“. ورأى مراد في صنع الله أستاذًا يمنحه التقدير الذي افتقده من الوسط الثقافي.
في دار الشروق لاقت أعمال مراد نجاحًا كبيرًا، ودعمت الدار إنتاج أعمال مراد وتحويلها إلى أعمال تليفزيونية وسينمائية. ساهمت دار الشروق في إنتاج مسلسل “فيرتيجو” المأخوذ عن رواية مراد، وأغرقت السوق بأعماله. كانت الرواية الواحدة تطبع في طبعة عادية وأخرى شعبية.
انقطع مراد عن عالم ميريت، واستغنى عن اعتراف الوسط الثقافي بالنجاح الجماهيري. أصبح له جمهور كبير من الشباب والمراهقين، ليحصل هو أيضًا على هذا الشعار الرائج أخيرًا “جعل الشباب يقرأون”.
هنا ينتقل الكاتب من عالم البرج العاجي للنخبة المثقفة إلى فضاء أوسع، فيه جماهير “شباب يقرأون” يبحثون عن آباء، مرشدين، موجهين، أساتذة، وشيوخ. سريعًا تخلى مراد عن ارتداء “التي-شيرتات” وحَلَق شعره تمامًا، لم يعد يرتدى ملابس ملونة بل أصبح الرمادى والأزرق والأسود الطابع الغالب عليه مع “البدل الرسمية” التي تتناسب والوضع الاجتماعي الجديد بصفته أستاذًا “يجعل الشباب يقرأون”. قتل مراد دكتور جيكل، وأطلق العنان لمستر هايد.
أصبح لديه برنامج في الراديو، لا يفعل فيه سوى إطلاق النصائح وتحليل أعمال الآخرين، ساعة تقريبًا ينفرد بالميكروفون. هذا غير البرامج وورش تعليم كتابة السيناريو وكتابة الرواية والتصوير الفوتوغرافي. تكاثر أتباعه ومجانينه، وبعد وفاة “العرَّاب” أحمد خالد توفيق، أصبح طموحه أن يحل مكانه كعراب هو الآخر.
لكن الأهم في تحولات أحمد مراد هو هجرانه لكتابة الرواية البوليسية. لأن الرواية البوليسية لا تليق بكاتب أستاذ وشيخ الآن. لذا جاء الانتقال إلى الرواية التاريخية..
6
في روايتيه التاريخيتين “1919” و “أرض الإله”. يقدم مراد رؤية سياسية عقيمة لتاريخ مصر، وهي الرؤية التي يتبناها طاقم من الكُتَّاب يحتضنهم النظام المصري حاليًا مثل يوسف زيدان، وعبد الرحيم كمال.
في أعمال مراد التاريخية، هناك كيان أبدي خالد يسمى “مصر”. والمصريون واعون بخلود كيانهم الجمعي، ويواجهون مؤامرات متعددة دائمًا من جهات خارجية. مصر في أعمال مراد، ليست فكرة تتطور تاريخيًّا حسب وعى المصريين بذاتهم. لا، فمصر الفرعونية هي مصر القرن العشرين، والمصريون إما قادة وحكام وعسكريون يدركون هذه الحقيقة ويدافعون عنها، أو راقصون وخونة ومدنيون لا يدركون مصر ولا سرها.
مصر أيضًا هي منبع كل شيء؛ من حضارة وأديان ومهلبية، ومراد يكتب الرواية التاريخية للنفخ أكثر وأكثر في هذه الرؤية الشوفينية المنغلقة على ذاتها. لهذا يقدم في روايته “أرض الإله” خليطًا من الادعاءات الإسرائيلية والتوراتية للتاريخ المصري القديم. فيصبح أوزيريس هو النبي إدريس، أو يلتقي النبي موسي بأحمس.
ظهرت بوادر هذا الوعي السياسي والتاريخي المشوَّه مبكرًا لدى أحمد مراد. فقد أهدى روايته البوليسية “تراب الماس” إلى محمد نجيب، وحين سألته عن السبب قال إن “تنحية محمد نجيب في رأيه كانت بداية الانهيار“. فسألته:
–ولماذا لا نعتبر وصول العسكر إلى السلطة هو الخطوة الأولى، أو حتى تولى الرئيس السادات مقاليد الحكم؟
-لا أعتقد ذلك، الضباط الأحرار الذين شاركوا في صنع ثورة يوليو كان لديهم طموحات وأحلام نجحوا في تحقيق بعضها وتراجعوا عن تحقيق الآخر، ومحمد نجيب كان لديه الطموح والرغبة في أن يعود الجيش مرة ثانية إلى الثكنات وإقامة حياة مدنية حقيقية، لكن عدم حدوث هذا هو ما أدى إلى كل الكوارث التي نحياها.
-لكن هذا وعيك وفكرتك الخاصة، لماذا تفترض أن تاجرًا بسيطًا مثل حنفي الزهار يعيش لحظة تاريخية ملتبسة يفكر بهذه الطريقة؟
-محمد نجيب كان رمزًا لمرحلة كاملة، صوره كانت توزع في الشوارع مجانًا. وحنفي الزهار لم يكن منحازًا لمحمد نجيب، أو يضع صورته في المحل لأن عنده وعي أكثر من كونه شخص عادي لديه مشاعر من الانتماء والحب لشخص رئيسه محمد نجيب.
استمر هذه الوعى السياسي في أعمال مراد اللاحقة، واستفحل وتضخم في أعماله التاريخية؛ فالمصري العادي في أعماله السينمائية أو الروائية، إنسان طيب يحب بلده، ويعبر عن هذا الحب بالتفاني في تقديس رموزها التاريخية وحكامها وقادتها.
7
لم نعد في 2004، بل أصبحنا في 2010، ومن سلالة أحمد خالد توفيق خرج عشرات الكُتَّاب الذين ينحتون أسلوبه، أو يحاولون التمرد عليه، لكنهم مهتمون بتأسيس أدب الرعب وأدب الخيال العلمي والبذور التي بذرها.
في حفل إفطار نظمته إحدى دور النشر الشابة قابلته مع مجموعة من الكُتَّاب الشباب، جميعهم على الطاولة أخذوا يشكون من صعوبات نشر روايات الخيال العلمي وأدب الرعب، وعقم الوسط الثقافي ومؤسساته. لكنه في ذلك اليوم تحدث عن الفرادة والخصوصية. فانعدام الجذور العميقة لأدب الخيال العلمي وأدب الرعب لا يعنى أن نستعير كل تراكيبه من الرواية الغربية. وانفعل في أثناء حديثه “لا يمكن أن نقدم روايات تستعير الشخصيات من الروايات الغربية، لا يمكن أن نقدم روايات تحدث في مصر وأبطالها خارقين مفتولي العضلات، يجب أن نتحرر من الخيال الهوليودي“، ثم أشار إلى الحضور وأضاف ساخرًا “كلنا هنا بكروش، ليه أبطال رواياتنا يبقوا بعضلات!“.
يجمع الكثيرون حاليًا بين أحمد خالد توفيق وأحمد مراد، تحت شعار “جعل الشباب يقرأون“. وهو تلخيص مجحف لتجربة الاثنين. فليست القراءة مفتاح التقدم أو دليل الحضارة والتطور، فلا أحد يقرأ مثلًا أكثر من دراويش التيارات السلفية والجماعات الجهادية. المهم هو ماذا تقرأ؟ وماذا بعد “جعل الشباب يقرأون”؟ هل يفتح لك هذا الكاتب الباب على كتاب آخرين وعالم أكثر رحابة. أم يجعلك تقرأ ويغلق الباب خلفه على طريقة شيوخ السلفية الذي يشجعونك على القراءة وطلب العلم لكن يحرمون قراءة كتاب آخرين؟
8
بدأت موجة “البست سيلر” والأعلى مبيعًا، بعد نشر علاء الأسواني روايته “عمارة يعقوبان“، أعقبتها موجة من الكتابات الساخرة لكُتَّاب أبرزهم بلال فضل، وجلال عامر، وعمر طاهر، ثم توالت الأسماء. بعضها لمع سريعًا واختفى، وبعضها لا يزال مستمرًا.
ترافق صعود موجة “البست سيلر” مع هجوم مستمر على النقاد وعلى الحركة الأدبية. والسبب كما يوضح أحمد مراد “في منتصف الثمانينيات وحتى نهاية التسعينيات كان هناك انعزال بين النقاد والشارع، فصار الكاتب يسعى وهو يكتب لإرضاء النقاد، ولا يهتم برأي الشارع، لذلك عزف القارئ عن القراءة، لأن ما يُكتب لا يمسه، ومنذ نهاية التسعينيات وبداية الألفية الجديدة بدأ الكاتب يكتب شيئًا يمس القارئ“. لكن الآن حسب رأي مراد “هناك موجة حلوة” من الكتاب الذين يكتبون لإرضاء القراء.
في عالم “المهلبية البريئة” لأحمد مراد يتخيَّل أن سوق الكتاب هي سوق حرة، ومن ثم فأي نجاح يحققه الكُتَّاب هو نتيجة اجتهادهم، وهو أمر يعلم كل من عمل في صناعة النشر في مصر أنه غير صحيح.
لم تكن موجة “البست سيلر” لتظهر دون الاستثمارات والأموال التي ضُخَّت في سوق النشر وتوزيع الكتاب في الفترة من 2005 إلى 2010.
الجزء الأكبر من الأموال التي ضُخت في سوق الكتاب أتى من برنامج دعم صناعة الكتاب الذي موَّلته هيئة المعونة الأمريكية. ففي إطار حمى نشر الديموقراطية في عهد جورج بوش خصصت هيئة المعونة الأمريكية أكثر من عشرين مليون دولار لدعم صناعة الكتاب المصري، بهدف تشجيع دور النشر على طباعة كتب “معينة” من أجل توزيعها على مكتبات المدارس. شكَّلت هيئة المعونة الأمريكية لجنة وضعت شروطًا محددة للكتب المطلوبة، كأن تكون مشوقة وقادرة على جذب الأطفال والشباب، وأن تحمل قيم المساواة بين الجنسيين، والإسلام المنفتح، وحب أمريكا وحب الديموقراطية
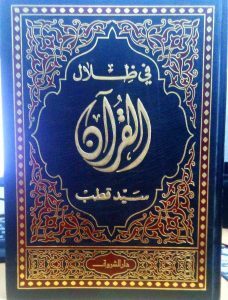
غلاف كتاب في ظلال القرآن، لسيد قطب من إصدارات دار الشروق وأحد أكثر الاصدارات مبيعا في تاريخ الدار. .. سيد قطب جعل الشباب يقرأون
.
فتحت هيئة المعونة الأمريكية الباب لدور النشر للتقدم بعروضها، لكنها وضعت عدة شروط؛ أهمها أن تكون دار النشر خاصة لا حكومية، وأن تمتلك دار النشر مطبعتها الخاصة. وبهذا لم تتمكن دور نشر حكومية وقومية من المنافسة، وكذلك دور النشر الصغيرة التي لا تمتلك مطبعتها الخاصة، وكأن المناقصة قد فصلت لتناسب دور نشر محددة. وكانت النتيجة أن حصلت دار الشروق ودار نهضة مصر على تلك الملايين. وفي مقابل هذه الملايين طبعت دار الشروق 80 ألف كتاب ووزعتها على ما يقرب من 20 ألف مدرسة، طبعًا هذه الأرقام التي أعلنت عنها هيئة المعونة الأمريكية ولا سبيل للتحقق منها.
احتاج إبراهيم المعلم إلى إعادة طلاء واجهة الدار من أجل التوقيع والحصول على ملايين الأمريكان. فالشروق حققت شهرتها وثروتها من خلال نشر الكتب العلمية والموسوعية، ودخلها الأكبر من الكتب الدينية، بداية بالغزالي، والقرضاوي، وحتى سيد قطب الكاتب الأعلى مبيعاً في تاريخ الدار و”البيست سيللر” الأول. ومن ثم لم يكن من الممكن أن يذهب إلى الأمريكان وإدارة بوش ليقدم نفسه بصفته ناشرًا حداثيًّا وتقدميًّا، فبدأت الدار خطة للاستحواذ على كتب ومؤلفات عدد من كتاب جيل الستينيات، بدأتها بشراء حقوق أعمال نجيب محفوظ مقابل مليون جنيه، بينما تنساب ملايين الدولارات إلى الشروق من جهة أخرى. وحتى بعد توقيع الاتفاق استمرت الانتقادات لتوقيع هيئة المعونة الأمريكية لعقد نشر مع ناشر المنظر الأولى للجماعات الإرهابية
ساهمت ملايين المعونة الأمريكية في توسع الدار واستحواذها على حصة أكبر من السوق، وزاد الأمر بعدما استحوذت مجموعة القلعة الاستثمارية على دار الشروق، إذ لم تكتف الشروق بالنشر بل توسعت في شبكة مكتباتها، وبجوار النشر أسست شركات الإنتاج التليفزيوني والسينمائي لتنتج أعمال كُتَّابها.
9
جميع الاستثمارات الكبرى في سوق الكتاب المصري خلال العقد الأخير تدفقت من خلال مجموعة القلعة الاستثمارية، وهي تكتل استثماري ضخم ظهر في 2004. تمتلك القلعة عدة شركات بعضها في مجال الطاقة، والنقل، واستثمارات بعشرات المليارات. إحدى تلك الشركات هي شركة “تنوير“ والتي لا يعرفها الجمهور المصري العادي، لكنها ببساطة الشركة التي تمتلك كلاً من؛ دار الشروق، وسلسلة مكتبات ديوان، وصحيفة الشروق، وصحيفة المال، وعدة مكاتب وشركات أخرى في مجال الطباعة الفنية والتجارية، وشركات إنتاج سينمائي وتليفزيوني.
اشترت مجموعة القلعة الحصة الحاكمة في دار الشروق، ورسميًّا يمتلك أحمد هيكل الحصة الحاكمة 58% من الشركة المصرية للنشر العربي. لكنهم مع هذا احتفظوا بإبراهيم المعلم كواجهة أكثر فائدة، ومطمئنة لقطاعات المثقفين والكُتَّاب. فليس من اللائق أن يكون مدير أكبر دار نشر مصرية ملياردير سبق اتهامه بالتربح والفساد ومنعه من السفر فترة مؤقتة بعد الثورة في 2011، قبل أن تعود الأمور لنصابها ويغلق ملف الاتهامات ويستمر أحمد هيكل في مناصبه، بالتالى فالأفضل الحفاظ على إبراهيم المعلم كواجهة. .
ترافق شراء القلعة لمكتبات ودار الشروق، مع توسعها في فتح أفرع جديدة لمكتبة ديوان، والتي توجهت إلى الطبقة الغنية القادرة على تحمل تكاليف دفع شراء الكتب. ونتيجة لما سبق ظهرت مسألة “البست سيلر”.
ودخلت إلى سوق الثقافة والأدب وجوه جديدة قادمة من أعلى السلم لا من أسفله. لم يصنع الجيل الجديد من كُتَّاب البست سيلر شهرته من خلال العمل لسنوات والنحت في أنواع أدبية منبوذة مثل أحمد خالد توفيق، ولم تنتشر كتبه بدافع حب القراءة أبعد من حدود مصر. بل هبطوا من أعلى بدعم دور النشر الكبرى والاستثمارات الرأسمالية وأموال المعونة الأمريكية.
وعلى الرغم من الشعبية الجارفة لأعمال د. أحمد خالد توفيق، فلم تُحوَّل أي من كتبه لأعمال سينمائية أو تليفزيونية إلا بعد وفاته، بينما في حالة أحمد مراد كانت الشروق هي المنتج لأولى المسلسلات التي أنتجت عن عمل روائي له. في خطة واضحة لفرض أسماء ووجوه محددة بصفتها “البيست سيللر”، واقناعنا أن هؤلاء الكتاب هم “ما يطلبه الجمهور”. هم الرموز والتماثيل الجديدة التى تنتصب في المدينة.
لم يعد الإنتاج الثقافي حكرًا على مؤسسات الدولة، أو مغامرات متمردة لجماعات ثقافية هامشية تحلم بتغيير العالم. بل دخل من يحكمون العالم بالفعل إلى سوق الإنتاج الثقافي ونشر الكتاب، ساحبين خلفهم نظريات التسويق والإدارة وحسابات الربح والخسارة والممارسات الاحتكارية، ومختلف قيم النهب والتهليب والبلطجة وغيرها من قيم مجتمع المال والأعمال المصري.
10
في السوق الحر، من حق الجميع الاستثمار، ومن حق الجميع أن يكتب.
في السوق الحر يمكن أن يتنافس الكُتَّاب على كعكة “البست سيلر” والقرار في النهاية للقارئ. لكن سوق النشر والكتابة في مصر ليست حرة بالتأكيد.
فمجموعة القلعة لديها استثمارات مشتركة مع السلطة في مصر، ويسمح لها بالاستثمار في قطاعات لا يسمح بها لأي مستثمر آخر. وعلى سبيل المثال دفع الانتعاش في سوق النشر والكتب مستثمرين آخرين إلى دخول السوق والمنافسة، وظهرت سلسلة مكتبات “ألف” منافسًا لمكتبات ديوان. كما ظهرت دور نشر أخرى تحاول منافسة الشروق.. لكننا جميعًا نعرف مصير هذه المشاريع.
فسلسلة مكتبات ألف تعرضت للإغلاق بتهمة الانتماء للإخوان، بينما دار الشروق الناشر الرسمي طول عقود لكتب الإخوان لم يتعرض لها أحد، بل إن أحمد هيكل كان متورطًا في قضية التلاعب في البورصة مع جمال وعلاء مبارك، وعليه أحكام بالسجن، ومع ذلك لم يلق القبض عليه ولا مرة. في الوقت الذي تقتحم فيه الشرطة مقرات ناشرين منافسين للشروق لتسألهم ما إذا كانت نسخة “الويندوز” لديهم شرعية أم مقرصنة، وتُلفَق لهم القضايا سريعًا، وفي اليوم التالي تنشر الأخبار عن تلك القضايا الملفقة في صحيفة الشروق.
يعاني ناشرون آخرون من الرقابة ومصادرة كتبهم، بل وسجن بعض الناشرين، لا لشيء إلا لنشرهم أو توزيعهم لبعض الكتب، بينما يستمر نمو الشروق واحتكارها للسوق دون أي مشكلات أمنية.
حتى داخل الشروق نفسها تعمل آلية الرقابة على تهميش كُتَّاب وإبراز آخرين، لخدمة الأجندة السياسية للنظام.
فعلى سبيل المثال كل الكُتَّاب الذين غضب عليهم نظام السيسي رُفعت كتبهم من المكتبات، وتوقفت الدار عن الترويج لها. نتحدث عن كُتَّاب صنعوا ظاهرة “البست سيلر” منذ البداية مثل علاء الأسواني، أو بلال فضل، أو حتى عز الدين فشير. فهؤلاء الكتاب الذين أصبح مصيرهم المنفى، لم يصدر قرار بمصادرة كتبهم، لكن الشروق ترفع كتبهم من واجهة مكتباتها وتتوقف عن طبعها.
في المقابل تستمر طباعة وتوزيع كتب المؤيدين للنظام والعاملين على خدمته، مثل يوسف زيدان وأحمد مراد. الذين مثَّلوا في 2014 النخبة الثقافية الجديدة التي حاول نظام السيسي تشكيلها وزراعتها، وكان يواظب على لقائها باستمرار. وهو ما التقطه أحمد مراد الذي سارع بالتصريح في 2014 قائلاً عن السيسي “شعرت أنه رجل يحب بلده جدًا، وتأكدت أن تصديه للإخوان كان هدفه مصلحة البلد، فهو في النهاية وزير الدفاع الذى يمثل أقوى منصب في البلد، فأن يتخلى عنه ويتولى منصب رئيس الدولة الذي يجعله كما يقال «في وش المدفع» فإما إنه مجنون أو إنه يحب مصلحة بلده لدرجة تعريض نفسه لأقصى أنواع الخطر من أجلها“.
طبعًا هناك كُتَّاب آخرون لم يروا في السيسي ما رآه مراد، فسجنوا ونفوا، وصودرت كتبهم، وحذفت أسماؤهم من تترات مسلسلاتهم. فأين إذن السوق الحرة؟
يدافع مراد عن نفسه بأنه لا يهتم بالنقد، لأن الجمهور واقف في ضهره؛ على طريقة محمد رمضان. لكن هل هذا صحيح؟ هل الجمهور هو من يقف في ضهره؟ وكيف يختار هذا الجمهور بحرية إذا كان لا يجد أمامه إلا ما تريد الشروق وأحمد هيكل وإدارة الفكر والإعلام بالأمن الوطني له أن يراه؟ أم تقف في ضهره جهات أخرى ترفض الكشف عن أسمائها؟
11
في مقال زينة حلبي عن العنف الأدبي وسلطة الناقد. تشير إلى الدور الذي لعبته المؤسسات الثقافية والأكاديمية في تأسيس رأس المال الرمزي للناقد. فطه حسين ليس كاتب أو ناقد، بل أستاذ جامعي ورئيس مجمع اللغة العربية، وينبع ثقل رأيه لا من كونها آراء كاتب يمكن الرد عليها، بل آراء مؤسسات ثقافية لعب العميد دورًا في تشييدها، ولا تزال رؤيته هي المهيمنة على أبنائها.
لكن هذه المؤسسات اضمحلت تمامًا طول العقود الأخرى، والمشهد الثقافي ظهرت فيه أشكال جديدة من السلطة منبعها سلطة المال والجوائز الثقافية الخليجية. وأصبحت تلك السلطة هي السلطة النقدية الحقيقة التي تحكم السوق وتوجِّه الأدب.
هذه الوجوه التي “تجعل الشباب يقرأون” وينحازون للسلطة السياسية والرأسمالية، هم الكتاب والرموز الثقافية الجديدة الذين أفرزتهم أموال مجموعة القلعة وجوائز شيوخ الخليج.
وهؤلاء لا يكتفون مثل طه حسين، بالتعبير عن آرائهم أو استخدام العنف اللفظي لتهميش الآخرين. بل إنهم قادرون على استخدام وسائل مادية أكثر عنفًا لترسيخ تربعهم على العرش الوهمي “للبست سيلر”. سواء من خلال كتابة التقارير في المنافسين، أو التهديد بالسجن لمن ينتقدونهم.
كان أقصى ما يفعله طه حسين وهو رأس السلطة الثقافية أن يحقِّر من كتابات الآخرين، أو يعلِّق عليها. لكن أحمد مراد أخيرًا وبعد حملة التعليقات والاعتراض على بعض تصريحاته أصدر بيانًا هدد فيه الجميع؛ صحفيين وإعلاميين معلنًا “لن أسمح لهواة الصيد في الماء العكر بالاستمرار، وسأغلق من جانبي باب الرد، بعد تكليف المحامي د. حسام لطفي المحامي بالنقض باتخاذ الاجراءات اللازمة…
وليس لتوقفي دلالة سوى الحرص على التفرغ لعملي، والنأي بقرائي عن متابعات ليس الغرض منها سوى النيل من مسيرة بدأتها بجهد وعرق، فيما يسعى البعض إلى سحبي بعيدًا عنها وتشتيت تفكيري بدون أي هدف قد يخدم المجتمع”.
فدكتور جيكل؛ الطيب الذي كان يسهر مع المثقفين والكتاب في دار ميريت قد مات، وللدقة قتله مستر هايد. وهو الآن يواظب على نشر صوره على صفحته على الفيسبوك معدلة بالفوتوشوب، محاطة بهالات الغموض والتأثيرات الهوليودية…

القاضي ناجى شحاتة، صاحب أكثر من 500 حكم إعدام، وأحد رموز السلطة القضائية التي هدد مراد باستخدامها ضد أشباه المثقفين
وداعًا دكتور جيكل الشاب الطيب الذي فضَّل يجلس في ركن غير المدخنين بسيلانترو، وظهر الآن مستر هايد الذي يجالس الرئيس السيسي، ولا يتحمل أي نقد.
قديمًا كانت المعارك الثقافية تحدث على صفحات الصحف والمجلات، وتولِّد عشرات النقاشات، وتكون بمثابة الدينامو المحرك للحياة الثقافية. لكن الآن لا يتحمل رموز السلطة الثقافية الجديدة، أبناء “البست سيلر” أي نقاش أو جدل. فهم مسنودون بسلطة رأس المال، وبالسلطة السياسية التي يمدحونها وتدعمهم. لا يمتلكون رأس مال ثقافي ليناقشوا ويتحملوا الاختلاف، وهم على عكس ما يروجون؛ لا يتركون المجال “للسوق المفتوحة” أو للقارئ ليفصل بينهم، بل كما ختم مراد بيانه “القانون يحكم بيني وبين حملة معاول الهدم، والوقت غالي، لا يتحمل ترهات أشباه المثقفين“
الوسوم :
11سبتمبر1919أحمد خالد توفيقأحمد مرادأحمد هيكلأدب عربيأدب مصريأرض الإلهالأدبالأعلي مبيعاًالإرهابالإنتاج الثقافيالبيست سيللرالرقابةالسق الحرالسوقالسيسيالسينماالقانونالنشرتراب الماسجمال عبد الناصرجورج بوشحجازيحرية رأى وتعبيرد.أحمد خالد توفيقدار الشروقسؤال القيمةسيزانشركة تنويرفيرتيجوما وراء الطبيعةمجموعة القلعةمحمد نجيبنجيب محفوظ