٣٤ عامًا فقط عاشتها الفيلسوفة الماركسية، ثم المتصوفة، الفرنسية سيمون فاي (1909-1943)، عمر قصير للغاية بمعيار الزمان، لكنها تركت أثرًا بالغًا، يمتد صداه إلى اللحظة المرتبكة الحالية. مارست فاي كل ما آمنت به من مبادئ ترتفع بها إلى مصاف القديسين؛ تركت عملها في التدريس لتنضم إلى عمال المناجم، تقتسم معهم أجرها الضئيل وطعامها القليل، وتثقفهم سياسيًّا، وتشارك في إضراباتهم، وتترك فوق كل هذا نحو 25 كتابًا في الفلسفة وغيرها.. وبعد نضال تقدمي مكثف، تنحو للروحانية الصوفية مبتعدة عن الماركسية، حتى إننا نجد تروتسكي وقد كتب إلى فيكتور سيرج يوم ٣٠ يوليو ١٩٣٦، يدعوه إلى قطع العلاقة مع فاي “لأنها لم تعد متحمسة للفكر الثوري، ولم تعد مناصرة لقضايا البروليتاريا” [الفلسفة بصيغة المؤنث، رشيد العلوي].. ومن بين الكثير مما يعنينا، في مدينة، من هذه السيرة الثرية، تعنينا حالة الجدل التي لا تزال فاي قادرة على إثارتها حتى الآن، والتي نتج عنها هذه المراسلات..
تتساءل فاي “لماذا خلق الله العالم؟” ثم تجيب “من أجل الحب.. لم يخلق الإله أي شيء سوى الحب نفسه ووسائل الحب”. وقد كُتبت الرسائل التالية حول مفهومي “الحب” و”المعرفة”، حين فتح صاحباها؛ أمل إدريس هارون ومينا ناجي، حوارًا عبر الإنترنت عن سيمون فاي إثر حلقة عنها في برنامج “سوشي بوك ريفيوز”. كان واضحًا منذ البداية اختلاف دلالات المفهومين عند الطرفين، والخريطة المعرفية والقيمية التي يتموضعان فيها. طرحت أمل تفسيرًا جندريًّا لاختلاف التأويلات، ومن ثَم كان المفهوم الثالث الحاضر في الرسائل هو مفهوم “الجندر” (النوع الجنسي في تجليه الثقافي).
كان الهدف المشترك، الذي تكوَّن على مراحل، هو محاولة ما يعنيه الآخر حين يتكلم عن الحب والمعرفة والجندر، بل ما يعنيه هو نفسه، وذلك بالمرور عبر بؤرة سيمون فاي كباحثة في المعرفة ومتصوفة مؤمنة بالحب.
وهذا ماجعلنا في “مدينة” نتحمس لنشر هذه المراسلات الإلكترونية، نقدم فيها فيلسوفة يعاد اكتشافها في ثقافتها، وعبر التراشق المتبادل نكتشفها بشكل مثير فكريًّا
ولدت سيمون فاي ( تنطق هكذا بالفرنسية عكس الشائع في العربية)…في باريس 3 فبراير 1909 من عائلة يهودية غنية غير متدينة وهي أخت عالِم الرياضيات الشهير أندريه فاي. سلكت فاي طريقًا غير مألوف بالنسبة إلى المثقفين الماركسيين في عصرها، وأصبحت أكثر تدينًا وميلاً إلى الروحانية مع تقدمها في السن. كانت غزيرةَ الإنتاج، لكن معظم كتاباتها لم تلفت الانتباه إلا بعد وفاتها. في خمسينيات وستينيات القرن العشرين، أصبحت أعمالها مشهورة في أوروبا وفي البلدان الناطقة بالإنجليزية. تعتبَر سيمون فاي الآن من أهم فلاسفة القرن العشرين، وقد وصفها ألبير كامو بأنها “الروح العظيمة الوحيدة في عصرنا”. تُرجم لها بالعربية كتابها الشهير “التجذر” وإن كان الكتاب محور المراسلات هو مذكراتها الروحية “الجاذبية والنعمة” غير المُترجمة، وهما يعتبران مع كتابها “في انتظار الله” أشهر أعمالها. توفيت فاي يوم 24 أغسطس 1943 في إنجلترا نتيجة تداعيات صحية لامتناعها عن الراحة والأكل المنتظم تضامنًا مع الفرنسيين المحاصرين في الحرب.
توقفت المراسلات بين أمل ومينا عند الإحساس بالوصول إلى لحظة فهم مشتركة، ربما تستأنف مستقبلاً للحظات فهم أخرى، لكن حاليًا اتفقا أن حالة المراسلات تلك ربما تكون ذات نفع على مستوى الضوء المتبادل الذي ألقي حول تلك المفاهيم، وعلى مستوى كونه مثالاً لحوار خارج النقاشات المعتادة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث سادت روح الشرح والتقارب على روح الحكم والقطع.
لم يقابل الطرفان بعضهما، لكنهما تقابلا معًا عبر فاي؛ كلٌّ بطريقته.
ا
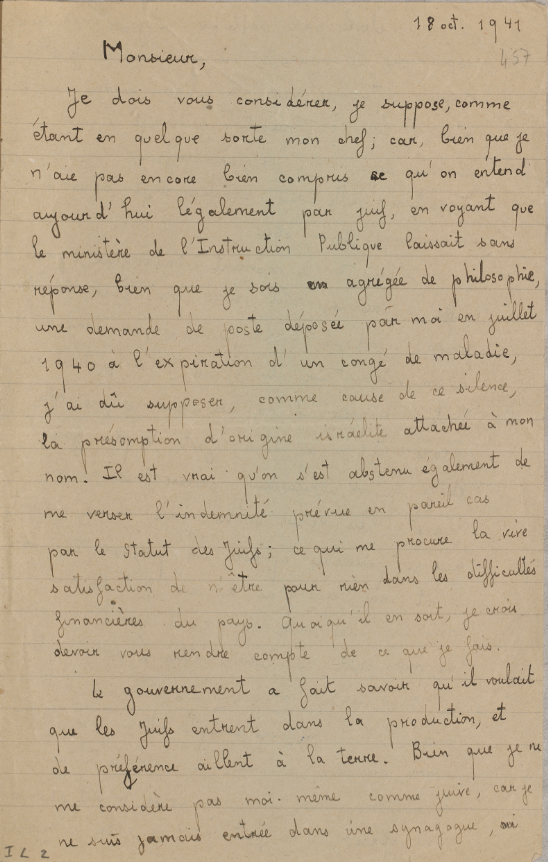
1
كان الدخول لعوالم سيمون فاي مفاجئًا، نوعًا من التصادم القدري اللطيف، والتسلل البطيء لشكل آخر من التناول الحيوي والصادق والسهل، فعند قراءة كتاب “التجذر”، رأيت على الفور أنه يمثل مانفستو تأسيسيًّا في العلاقات الإنسانية والاجتماعية، مرتبطًا بشكل مباشر بالواقع، وقابل فورًا للتنفيذ رغم بساطة طرحه للقضايا.
أي قراءة تعبث فجأة بوعينا يكون السبب غالبًا أنها تتقاطع مع إشكالية أو سؤال يتردد داخلنا، في حالتي ما أثارته قراءة فاي هي أسئلة، بالأحرى إحباطات محيطة بالأداء الأكاديمي والجو العام فيه، وطرق إنتاج المعرفة: السجالات الفكرية النرجسية الفارغة، تقعر الأطر العلمية في تناول الظواهر من ناحية ثم انغلاقها على نفسها لدرجة من الصعب فهم فروع العلم لبعضها أحيانًا من ناحية أخرى، الطريقة الوضعية لرؤية الظواهر وكيف تتمشكل باستقطاعها من سياقاتها بلا اعتبار لطرق أخرى في التعامل مع العالم، إعادة تدوير مفاهيم وأطر بشكل سخيف وغير أصيل وفيها هيمنة ما بعد استعمارية (بالمعنى الحقيقي للفظ)… إلخ
قراءة سيمون فاي أدت فجأة لرافد مختلف وملهم للمعرفة كحالة تكاملية بلا تقعر، مختلط فيها الروحي بالإنساني بالفلسفي، لأننا لو تكلمنا عن وعي ومنهجية سيمون سنجد شيئًا فريدًا غير معني بالترسخ في تقليد واضح أو يعيد تدوير الأفكار لكنه منتج للمعرفة الجادة الحقيقية، هذه الفرادة أو الانبهار أمامها يأتي من شعور مضاد بنقص مناهج أصيلة مشابهة وهنا أحب التحدث عن الأداء الفكري لسيمون فاي في نقطة أو اثنتين.
أولاً ندرك بشكل مباشر أنها عقلية رياضية جدًا، مفاهيم الثقل والفراغ والعفو أو المنح، مؤسسة بشكل رياضي، معادلات محضة في تأمل دقيق للحقائق المجردة، لكن المثير أنها في حالة تفاعل وليس مقتطعة أو معزولة عن بعضها، جمل مثل “الاحتياج للآخر ثقل يعوضه المنح أو الكرم” تصبح قضية واحدة لها أرضية واقعية متعددة الأقطاب، ثنائية المفاهيم تلك تعطي مفاتيح للتعامل مع العالم بتكامل واكتمال، يجعلني ذلك أقارن بشكل ما بينها وبين كتير من قراءات الفلسفة المجردة التي تتعرض لمفاهيم كبرى تقتطع وتشرح من الإنسان ووعيه ووجوده وتستعرضه تحت المجهر في برودة المعمل (وهي صورة رمزية مهمة في تناول العلوم للإنسان بعزل مكوناته وظواهره وحتى الباحث مفترض منه الانعزال هو الآخر ) هذا الاستعراض فيه نوع من العنف يهتم بالمشكلة والتمشكل والتوصيف أكثر مما يهتم بالحالة العضوية بين الروحي والمادي، الجزء والكل، التنظير والتجريب. هنا يأتي سؤال مهم من يخدم العلم ولأي شيء تؤدي المعرفة؟
النقطة الثانية المثيرة أن مسار سيمون الفكري واثق من نفسه ومتحقق وله طريقته الخاصة في تجربة الأفكار وليس في صراع مع بطريركية فلسفية عقلانية هيمنت (وتهمين بعنف رمزي معقد) على الحياة والعلم، ولا في صدام معها ولا امتداد لها، فلسفتها له صوت استنباطي حساس هادئ باحث عن الحقيقة أو المعنى حيث الإنسان متواصل مع مجتمع واسع ومرتبط ومترابط معه، غياب هذا الصراع بشكل علني مثير، غياب الصراع النسوي (سواء كبطريركية متماهية أو كضحية) مثير أيضًا، غياب الشعور بالاضطهاد اليهودي العميق مثير خصوصًا في فترة الحرب التي كانت فيها سيمون فاعلة، ربما لأنها نجحت في التخلص من مفهوم التعلق.
ربما تثير سيمون فاي الإعجاب للبعد الروحي في منتجها أو هذا التكامل بين الوعي والعالم بشكل لا تناقض فيه، لكن أكثر شيء تجاوبت معه أن ما تطرحه سيمون فاي يخاطب القلب فورًا، وتترك شعورًا بتعاطف لا يقدر عليه سوى وعي أمومي له نظرة واسعة للأمور، تتجاوز المادي والآني والمقتطع، ورغم غياب جندرية النص أجده يتطرق للعالم وللمفاهيم وللبنى الاجتماعية والإنسانية بتناول آخر قوي وعميق، مناف على الأقل لبطريركية العلم، تتخذ فاي طريقًا مختلفًا راغبًا في المعرفة وواعيًا بالواقع، تقول “المعرفة هي الغفران”، هل هو غفران الحزن الذي تورثه المعرفة؟ في طريقة الطرح نفسها نجد الشيء الجوهري حاضر، يخرج عقلها الرياضي ثنائيات الحضور والغياب لمفهوم ما، عندما تُعرّف الأمن تتكلم أكثر عن الخوف الذي يتحول لسم للروح، تتحدث عن الالتزام كمفهوم أعمق من ثنائية الحقوق والواجبات لأنها تحول الإنسان لموضوع وشيء، ومقابل الالتزام يجب أن يحصل الإنسان على الاحترام. معادلة بسيطة وممكنة ومتجاوزة للتقسيمات البشرية سواء طبقية أو عنصرية. تتحدث عن المخاطرة كحاجة إنسانية أساسية وتحدد إلى أي حد هي مهمة وحدود أهميتها في نصف صفحة بلا تقعر! تستخدم جمل قطعية بلا مداراة ولا تذكر لها مصدرًا، ومع ذلك نؤمن بما تقول! هذا ما أثار إعجابي واندهاشي، وبرر بشكل ما الانبهار بها: أي مسار المعرفة قبل أي شيء.
كانت مفاجأة سارة اكتشاف سيمون فاي ونموذج التزامها للحقيقة المستنيرة بقلب أبيض وروح لا تموت.
أمل
2
تحدثتِ عن سياقات الكتابة والاستقبال في نَص سيمون فاي، الجاذبية والنعمة، أو الثِقَل والنعمة كما تحبين أن تدعيه مُلتزمة بالنَص الفرنسي الأصلي. تعجبتِ من كونها لا تدخل خنادق الأقلويّة: مرة درع من الاستضعاف الديني، ومرة من الاستضعاف النوعي، كي تقول ما تحبذ. بل مرقت بلا دروعٍ، مُعرِّية روحها ذاتها، لتُلقي الجُمَل المبهرة في وجه متلقيها دون حساب.
لم تتحسَّس فاي فجوة جسدها قبل أن تكتب، أو هكذا يوحى لي. بل تحسست فجوة روحها، لتلمس عميقًا، في كل مرَّة، ذلك البئر الأسود الفارغ من النِعْمَة الإلهيّة. وبمنحى رياضي صارم، ناتج عن تصور أن العالم الروحي، أو تحديدًا تماس العالم الروحي مع العالم الدنيوي، له شروطًا دقيقة وثابتة كما للعالم الدنيوي، كدحت كي تملأه باستكشاف هذه الشروط عبر التجربة الباطنية والحدس.
 لم أفكر لحظة كونها امرأة، ولا رجل، صحيحة إشارتك إلى غياب جندرية النص، لكن هل للروح جندر؟ هذا مبحث لاهوتي يليق باللاهوتي الكبير توما الأكويني، لكن لا أظن فاي تهتم به. بل مشت على طريق الإلهي والروحاني للمس ما هو مشترك إنسانيًّا – هذا الإيمان بالكوني، الآخذ من الألم والحرمان نبراسًا. أستطيع أن أؤكد لكِ، الألم لا جندر له. ولا دين. الألم كافر.
لم أفكر لحظة كونها امرأة، ولا رجل، صحيحة إشارتك إلى غياب جندرية النص، لكن هل للروح جندر؟ هذا مبحث لاهوتي يليق باللاهوتي الكبير توما الأكويني، لكن لا أظن فاي تهتم به. بل مشت على طريق الإلهي والروحاني للمس ما هو مشترك إنسانيًّا – هذا الإيمان بالكوني، الآخذ من الألم والحرمان نبراسًا. أستطيع أن أؤكد لكِ، الألم لا جندر له. ولا دين. الألم كافر.
الوصول لوتر حسَّاس عَميق، يرن بألم من عُمقِه نظنُّه مؤسِّس لكينونتنا، وقدرة رائعة على التخاطب معه بشكل إنساني، بشكل يحفظ الكرامة، وبتسامح خارق. هذا المستوى من الكتابة: تَعرية الروح من الدروع؛ الغوص في البئر؛ سبر الكينونة والتخاطب مع الوتر الرنان، يستدعي نوعًا من القراءة التأملية الباطنية – تُسمِيها القراءة الأفقيَّة- أي الإبطاء والتروي والتفكير والاستبطان الشعوري، علاقة الزمن بالقراءة.. هل النعمة هي التروي؟
أجلتُ الحلقة مرَّات عديدة بسبب ذلك. وجاءت في وقتها تمامًا مثل كل شيء يخصها معي. فقد خاطبتني، في نفس العمر الذي ماتت به، في وقتٍ كنتُ أحتاج فيه لكلامها. رفيقة سلاح ذكية، جاءت إلى قاع الجحيم لتجلس بجانبي، وتوشوشني في أذني: سنُشغِّل عقلنا وقلبنا، معاول، هات يَدك!
البحث الجدي عن خلاص عن طريق العقل والحب معًا. لأن الحُب يصل بنا إلى الأماكن التي خذلتنا المعرفة في الوصول إليها، كما يقول توما الأكويني. لم أر أحدًا يتحدث عن الحب المسيحي بتلك الطريقة العملية والواقعية من قبل. شيء نادر فعلاً.
يقول كامو في جملة شهيرة: الطريقة الوحيدة للتعامل مع عالم غير حر هي أن تصبح حرًا تمامًا مما يجعل وجودك فعل تمرد. أظن أن الجملة تنطبق الآن، تاريخيًّا، على الحب لا الحرية. “الطريقة الوحيدة للتعامل مع عالم غير مُحب هي أن تصبح محبًا تمامًا مما يجعل وجودك فعل تمرد.” كثيرًا ما تم لومي على أني أفعل ما أحب في حياتي. يطقطقون لسانهم ويقولون ليس هكذا تُعاش الحياة. وحين أسقط يهزون رقابهم، ألم نُشر عليك؟
ربما يكون هذا التعاطف الفائق للطبيعة ناحية البشر ما أشعرني بالخجل، أعني أنه يمكن أن يحدث رغم وجود آلام عميقة، ورغم خذلانهم – من مِنا لم يُخذل؟- وكون العالم غير ما انتظرنا منه. القديس ليس من يعتزل الناس في الصحراء، بل من يبقى وسطهم ويحبهم مع ذلك! هذا التعاطف الأمومي المسيحي كما أشرتِ عندها يُقابله صرامة -ضرورية- ذكورية مع الذات؛ طحن الذات بين راحتي الألم والإرادة من أجل عطف فائق للطبيعة يمر كنسيم خلاب للعقل والقلب (قلتِ “نفحة خير كبيرة هبت على الروح”).
تدفعنا فاي أن نكون أفضل من أنفسنا، وتشير أن رغم كون القدرة على التجاوز تأتي من الخارج إلا أنه يستلزم أن نتحرك ناحيته بأنفسنا. ترتكز على تراث كتابة صوفي مسيحي وشرقي متداخل مع التراث اليوناني العقلاني. اليونانيون أدركوا أن الحب والمعرفة متكاملان ومتداخلان، بل إنهم أسموا الفلسفة باسم الحب “فيلو-صوفيا”: حُب الحكمة؛ الفلسفة تبدأ بالحب، وتنتهي به أيضًا. ولهذا السبب فاي استثنائيّة.
مينا
3
 تقول إن “الحب يصل بنا إلى الأماكن التي خذلتنا المعرفة في الوصول إليها”، أقول المعرفة تصل بنا إلى أبعد بكثير مما يقدر عليه الحب، المعرفة تتم على مراحل عناء، حزن، قطيعة، فقد الذات، تبصر، وصول وربما حب، يتطلب الأمر الصبر كما تقول أنت “طحن الذات بين راحتي الألم والإرادة” من أجل الوصول، وهناك وصول طالما هناك سعي.
تقول إن “الحب يصل بنا إلى الأماكن التي خذلتنا المعرفة في الوصول إليها”، أقول المعرفة تصل بنا إلى أبعد بكثير مما يقدر عليه الحب، المعرفة تتم على مراحل عناء، حزن، قطيعة، فقد الذات، تبصر، وصول وربما حب، يتطلب الأمر الصبر كما تقول أنت “طحن الذات بين راحتي الألم والإرادة” من أجل الوصول، وهناك وصول طالما هناك سعي.
هل يستطيع ذلك الحب. ما الحب؟ ما خطواته، إلى ماذا يصل بنا؟ هل الجميع سعداء في الحب؟ هل الجميع قادرون على الحب؟ هو مفهوم غير محدد نطلقه على الأمور والأشياء ثم نشعر الخذلان، نقول جرح الحب، غدر الحب، أُحب العالم ثم يصلبني العالم، لكنه ببساطة الجهل بحدود الذات وقدرتها والاندفاع نحو العالم بلا دفاع، المعرفة تقود لأحد تمثلات الحب، تجعل الحب ممكنًا، الحب بلا معرفة مخاطرة بالإيذاء، الحب المطلق بشكله المسيحي مؤلم على الدوام.
هناك مفاهيم أدق حول علاقاتنا بالعالم والناس: محبة، مودة، تواطؤ عميق، هناك شغف، هوس، امتلاك، تكامل، سادية، مازوخية، أومن بتلك المعاني وأفهم صيرورتها، نعم أحتاج للتعريفات المحددة التي ارتطمت بالواقع لتشكلها، وأفعل ذلك مثلما كان فاي تفعل، كانت تخرج للواقع وتجرب أفكارها به، وتعدلها طبقًا للتجربة، هكذا وجهت طاقة حياتها، لم تترك نفسها للمطلق والمبهم.
تقول الألم لا جندر له، وكافر، أقول الألم يستحق الاحترام، فهو سبيل آخر للمعرفة يجب الصبر عليه، هو أيضًا له صيرورة، يقلب عالمنا ويخرجنا من التجربة المستقرة التي نكون فيه آلهة صغيرة لنرى أشمل وأبعد، أين ستكون لو لم تكن في الجحيم ورأيت يد فاي؟ ربما الجحيم تحديدًا ما جعل ليد فاي تلك القيمة! وبالمناسبة الخذلان جزء من الحياة، الخذلان ينطو ي على معرفة، على سبيل المثال، محبط أن ندرك أنه لا يوجد مطلق، فالمطلق مغرٍ ومطمئن ويتيح الصيغ البلاغية كأن نستوعب أنه لا يوجد عالم حر/غير حر تمامًا ولا يوجد إنسان حر/غير حر تمامًا، حتى ولو قال كامو ذلك!
الروح لا جندر لها لكن التجربة تمر من خلال الإنسان، تجربة الرجل قوية ومستقرة ومتواترة تاريخيًّا، شاملة وكبيرة ومهيمنة ولها مساحات واسعة من التجريب والتدمير والمجد والقوة والتخليد، سرديته نسميها التاريخ، تجارب النساء ليست كذلك! تجاربهن تعايش وتفاوض وأحيانًا استعارة أداءات الرجل، ينجحن من خلال اعتراف الرجل ويفشلن لأنه قرر التجاهل، قليلات تتجهن للداخل، داخلهن بلا تلك الاعتمادية التاريخية، وتسعين للمعرفة بلا مرجعية لها. هذا أمر صعب وشاق لأنه يعيد اختراع كل أدوات التفكيك والبناء من خلال الذات ومن خلال الفرز لما سبق، كيف يمكن تجاهل ذلك ببساطة! فاي تجربة مختلفة لماذا لا نقول إنها امرأة (لا علم لي أنها نفت ذلك) مرتبطة بخيط من نساء متجاوزات لا نضعهن في موضع يليق لأنه ببساطة لا مفهوم حتى الآن يطلق عليهن خارج مفهوم الأنوثة (هناك بالمناسبة رجولة وذكورة وذكورية وهناك أنوثة ونسوية، أين يمكننا وضع النساء في المسافة بين الحالتين اللغويتين؟ حتى النساء القويات نطلق عليهم ماتريركية، لا مفر من التموضع مع أو تحت سلطة ما!) أقول تنتمي لنساء ذوات روح كبيرة، أموميات، بالمعني المضاد للذكورية (ما العيب في كلمة أمومية!) قادرات على صنع معرفة كبيرة، منهن شاعرات وكاتبات وأمهات بسيطات وسيدات لم يحظين بأي تعليم، هذه الأرواح التي تعتد بالآخر قبل الذات، أقول إن كونهن نساء منح التجربة بعدها القوي والنافذ، ثم كان تعاطيهن من خلال هذا الوعي الممتد بالألم والتعايش والانفتاح على العالم بقلب كريم وجعلن العالم مكانًا أفضل بلا استعراض. وهذا ما أطلق عليه أمومية تحديدًا.
ثم تقول “تعجبتِ من انبهارنا بفاي”، وأقول ما زلت أتعجب! لأن الانبهار يفترض أن نموذج المعرفة الحقيقية نادر وأن مد اليد نحو الآخر استثناء، ربما يروقكما كل الذهنية الكبيرة التي تتمتع بها وماكينة إنتاج الأفكار الطيبة، (وهذا موقف مدهش لأن جزءًا من تلك التجربة كونها أمرأه وأنتم رجال تنتجون الأفكار!) أنا أحب فقط ما قلت عنه “تمد يدًا لأحدهم في الجحيم، أحب نفحة الخير الكبيرة التي تهب على الروح”، لكن هناك دومًا من يمد اليد لأحدهم ويسحبه من الجحيم. يجب أن نمنح فاي إنسانيتها كاملة، فهذا خيارها الواعي، الملائكة والشياطين لا يختارون، الإنسان يفعل، وأفكر أنها كانت ليروق لها ذلك. لكن الامتنان العميق فضيلة أيضًا. والامتنان على قدر الاحتياج.
أتفق معك النعمة هي التروي، كل صيرورة فكرية يلزمها وقت حتى تنضج، التحول يلزمه وقت، المعرفة يلزمها وقت، المحبة يلزمها وقت، نمر خلاله بطقس أو مراحل، ثم تكون المعرفة، والمعرفة حزن، ثم غفران! ما صيرورة الحب؟
كان خلاصها عن طريق العقل وإرادة المعرفة، هي فقط لم تكن منتفخة بذاتها، لم تضيع وقتها في مشاحنات نرجسية وسفسطة استعراضية وعنف أكاديمي ذكوري يمارسه الرجال والنساء. الحب أميل لأن أعرفه بأنه الالتزام يقابله الاحترام كما صكت هي تلك الثنائية المدهشة، لكنها بالغت في ذلك الحب، مبالغة تسببت في رحيلها، كما ترى تصديق الحب المطلق يسوق للفناء.
مثير للدهشة أن ينتهي خطابك بحب اليونانيين، أيًا كان نوع الحب، فحب الحكمة كما أفهمه لا ينطوي على حب حقيقي بقدر ما ينطوي على الشغف بها والصبر عليها والتدريب مع الذات والآخرين بمعنى امتلاك الإرادة لتحمل العناء وذلك لماذا؟ من أجل المعرفة..
أمل
4
قبل أي شيء، أنا سعيد بالحوار الذي كان سببه العزيزة فاي. ملَّ الواحد من الإقرارات والبيانات الشخصية على الفيسبوك. على سبيل التغيير هناك مناقشة فكرية تتحدث عن مواضيع مهمة ومركبة.
بالمناسبة، ليس على أحدنا أن يُقنع الآخر، أو يظهر في النهاية بشكل أكثر صوابًا. بل، كما أفهم حالة الحوار عمومًا، أن نُلقي الضوء على أفكار بعضنا، وعلى منطقنا الباطن ورؤيتنا الخاصة للدنيا. هذا لا يمكن أن يحدث، كما أظن أيضًا، دون افتراض محبة أولية؛ هذا الشعور بأن الآخر يهمني، ويهمني التواصل معه، ويهمني أن يتقدم في مسعاه. كما أشعر بالاحتياج إلى نظرته وإلى أن يضيف لي، هذا بدافع محبة منفتحة ومستعدة لإنشاء ذلك التواصل. ومن هذا التواصل المُحِب ربما تُنتَج معرفة هي شيء ثالث غير طرفي الحوار وأكبر منهما. هذا مثالي الأول على صلة الحُب بالمعرفة.
يوجد مثالان آخران من كلامك. سأطرحهما في البداية قبل أن أناقش المفهومين الأساسيين محل الحوار: الحُب والمعرفة، بجانب الاستطراد في مسألة التناول الجندري لتلقي فاي والتعامل مع خطابها، الأمر الذي تعرضتِ إليه أيضًا في ردك.
“أقول تنتمي لنساء ذوات روح كبيرة، أموميات، بالمعنى المضاد للذكورية (ما العيب في كلمة أمومية!) قادرات على صنع معرفة كبيرة، منهن شاعرات وكاتبات وأمهات بسيطات وسيدات لم يحظين بأي تعليم كان، هذه الأرواح التي تعتد بالآخر قبل الذات. – أقول إنهن نساء وتعاطيهن من خلال هذا الوعي الممتد بالألم والتعايش والانفتاح على العالم بقلب كريم وجعلن العالم مكانًا أفضل بلا استعراض. وهذا ما أطلق عليه أمومية تحديدًا.”
أستهل بجملتك التي تبدأ بالحب، ليس كفعل نحوي فقط في الجملة، بل أيضًا الحب البادي تجاه تلك النساء الحاضرات في الفقرة. سؤالي: ما الدافع الذي جعلهن يفعلن هذا الفعل الاستثنائي والموقف الاستثنائي من العالم -الذكوري كما تذكرين في فقرات السابقة-؟ أي موقف “الاعتداد بالآخر قبل الذات” والتعاطي بوعي ممتد بالألم ورغم ذلك بانفتاح كريم على العالم، بل وجعله مكانًا أفضل، بلا استعراض، وأزيد أيضًا، بلا مقابل.
لا أعرف أي إجابة في الدنيا والآخرة تنفع إجابة لهذا السؤال سوى الحب. حبهن للآخرين وللعالم. هذا الحُب الذي يبدّي الآخر على الذات، والذي يظل على حبه رغم الألم ورغم كل شيء. حب بنّاء وكريم وغير استعراضي ولا يعرف الآلة الحاسبة. هذا الحب الأمومي مفتاح غال لا بد من التمسك به ككنز. كثدي يُرضِع ثقة وطمأنينة وكرمًا.
ماذا صنع هذا الحب؟ صنع “معرفة كبيرة” كما تقولين، وحتى في حالة عدم الحظي “بأي تعليم كان”. هذا مثالي الثاني على الصلة بين الحب والمعرفة. ويمكنك التوقف هنا عن القراءة مستريحة الضمير. لأنه كل شيء أود قوله في الحقيقة.
المثال الثالث “محبط أن ندرك أنه لا يوجد مطلق فالمطلق مغري ومطمئن ويتيح الصيغ البلاغية كأن نستوعب أنه لا يوجد عالم حر/غير حر تمامًا ولا يوجد إنسان حر/غير حر تمامًا، حتى ولو قال ذلك كامو!”. صلة الحب مع كامو، أو القراءة المُحبة لكامو، تُدرك أن رغم قوله جملته الشهيرة في صيغة مطلقة، لا يعني السذاجة المُتضمنة في أنه يمكن أن يوجد حرية تامة. تنبع تلك القراءة المحبة تلقائيًّا من مدى جديته في طرح المواضيع ومحبته الحارقة للإنسان في كلماته. القراءة المُحبة ستدرك أنه يعني إن على الإنسان التعامل كما لو أنه حُر تمامًا، أي أن يأخذ مبدأ الحرية مُرشدًا ومعيارًا لأفعاله بقدر ما يستطيع وبذلك يتجه نحو الحرية التي ستتجاوز في تلك الحالة حالة عبودية المجتمع/العالم القائمة.
بل وأكثر من ذلك. القراءة المُحبة هو أنه حتى لو عنى كامو ذلك -وذلك مستبعد تمامًا في رأيي- فستقرأها بشكل مغاير، بشكل مُحب يضيف معان تأخذ الكلام من يده وتدفعه إلى الأمام. القراءة المُحبة تولِّد معجزات. أحيلك في هذا الصدد لكتاب بارت الرائع والمُلهم: شذرات من خطاب مُحب Fragments d’un Discours Amoureux
“مثير للدهشة أن ينتهي خطابك بحب اليونانيين، أيًا كان نوع الحب فحب الحكمة كما أفهمه لا ينطوي على حب حقيقي بقدر ما ينطوي على الشغف بها والصبر عليها والتدريب مع الذات والآخرين بمعنى امتلاك الإرادة لتحمل العناء وذلك لماذا؟ من أجل المعرفة…”.
أظن هذه الجملة مربط فرس حوارنا المفتوح؛ فهي لا تحتوي فقط على نفي مندهش عن العلاقة المحتملة بين الحُب والمعرفة، بل تشير إلى أن المعرفة هي الكلمة المحورية عندك التي يقابلها عندي كلمة الحب. كما تشير بالطبع أننا لا نتفق على تعريف واضح للكلمتين. تتسائلين في ردك “ما الحب؟! ما خطواته، إلى ماذا يصل بنا؟ هل الجميع سعداء في الحب؟ هل الجميع قادرون على الحب؟” رغم ضرورة ووجاهة الأسئلة، إلا أنها كأنما تشير إلى مفهوم الحب المقصود كعلاقة رومانسية بين اثنين أو حالة وجدانية يمشي الواحد بها في الحياة. بالطبع، لو كان هذا معنى الحب المقصود سيكون أمرًا مثيرًا للسخرية اقترانه بالفلسفة، ولو أنه ليس خطأً بالكامل.
لكي أجيب أود أولاً الإشارة إلى أمر استوقفني في ردك، وهو اقتران المعرفة اللازم بالعناء والعذاب والحزن. تقولين بشكل صريح ومتكرر: “المعرفة عناء، حزن، قطيعة، فقد الذات، تبصر، وصول وربما حب” رغم تخفيف الربما في النهاية التي تضيف الحب واحتمالية الوصول، فالسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: إذا كانت هذه العلاقة ضرورية ولازمة، ما ضرورة كل هذا العذاب والعناء؟ لماذا أصلاً الصبر والتدريب؟ وتجيبين “من أجل المعرفة”. يمكن الرد ببساطة: طظ في المعرفة! وأعتقد أن أي شخص صادق مع نفسه لو خُيِّر بين أن يعيش سعيدًا أو عارفًا، سيختار أن يكون سعيدًا. بل تنتشر في كل مكان الآن الحكمة السينيكية بأن الجهل نعيم الذكي الذي يستمتع بحياته القصيرة دون وجع دماغ بمعرفة أشياء ستسوؤه إن بدت له. وكثيرون من يقولون: أنا لا أقرأ أنا أعيش.
بالفعل صحيح، ما فائدة أن أعرف أن فلانًا قال كذا، وأن علانًا قال كذا، إذا كان سيمنعني أن أعيش أو أن أصبح معذبًا وتعسًا كما تظهر شخصية المثقف والعالِم في الأعمال الفنية التجارية؟ وظني إجابتك ستكون أن المعرفة تحصن في مرحلة تالية من شر العالم، وتجنب الواحد الوقوع في فخاخ الخديعة والأذى، ستجعله أجدر في التعامل مع العالم. رغم الصحة الجزئية للفرضية -إذا كانت بالفعل إجابتك- فللأسف لا يمكن أن يصل الإنسان إلى مرحلة من المعرفة تجعله يفهم العالم، ولا تقيه شره. ليس لأن العالم والواقع أوسع بما لا يقاس من المعرفة الإنسانية المحدودة، أو كما يختصر شيكسبير الأمر “هناك أشياء كثيرة يا هوراشيو بين السماء والأرض تفوق حلم فلسفتك”، لكن لأن أيضًا هناك أمور في الحياة لا تنفع معها سلاح المعرفة؛ أمور لا رادع لها بالذهن والوعي.
لكن الأكثر أهمية ربما في تلك النقطة، هو التصوُّر المستبطن وراء الكلام بأن المعرفة عملية الحوز على حقيقة بصفتها مُطابَقة، أنه توجد حقيقة ما بالخارج، أو الداخل، تتطابق مع ذاتها ويمكن الحوز عليها بالكدح والعمل (لسبب ما تُحدِث تلك الحقيقة بالضرورة الحزن والأسى وقت الحوز عليها)، وهذا مفهوم للحقيقة أدى في التطبيق العملي إلى الكثير القهر والقمع والإقصاء والتعصب (الشقاء للأسف ليس من نصيب العارف فقط هنا).
الحقيقة كما أفهمها هي تكوين علاقاتي للمعنى متعدد بالضرورة، يسبب التساؤل والحركة إعادة تشكيل دائم له مع ذوات أخرى، ومن هنا تتشكَّل المعرفة دائمة التغيير والمتسقة مع ذلك. الحقيقة ليست معدنًا في جوف الأرض ننقب عنه ونحوزه فنزداد ثراءً.
أجيء الآن للمسألة الأساسية، وهي تعريف الحب وعلاقته بالمعرفة. تقولين “هناك مفاهيم أدق حول علاقاتنا بالعالم والناس: محبة، مودة، تواطؤ عميق، هناك شغف، هوس، امتلاك، تكامل، سادية، مازوخية“. تعريفي للحب يجعله مفهومًا شاملاً يتضمن تلك الأمور وغيرها. أفهم الحُب كعلاقة اندماجية مؤسسة على الرغبة في شكلها العام، وأيضًا بالمعنى الهيجلي (بصفة الرغبة هي ما تشكل الذات الإنسانية بالأساس). كل تلك “المفاهيم الأدق” بالنسبة لي هي تبديَّات وعناصر سياقية للمفهوم الشامل للحب، كعلاقة الرغبة التي تسعى إلى توحيد الذات والموضوع معًا.
ذكري لتسمية اليونانيين للفلسفة، بصفتها الشكل الرسمي والرئيسي للمعرفة، في نهاية كلامي، بأنها Philo Sophia، أي حب الحكمة، لم يكن اعتباطيًا. فاليونانيون ردُّا على موقف “طظ في المعرفة!” المنطقي والمتسق تمامًا بالمناسبة، الذي أشرت إليه في سابق كلامي، لم يجدوا غير الإجابة الوحيدة تلك: الحُب. باستخدام الفعل اليوناني Philein؛ أحَبّ، وَقَع في حُب، رَغِب في.
لا يوجد أي سبب لتحصيل المعرفة واحتمال مشاق طريقها سوى الحُب، حب المعرفة. والفلسفة بصفتها كذلك ناتجة عن غياب رغبة خاصة في موضوع -معرفي- معين، لكنها الرغبة العامة في المعرفة، (ومن هنا هي حُب وليست مجرد شغف كما أشرتِ) والتي تخلق هذه الحاجة، هذا الحرمان، الذي دونه لن ترغب، ولذلك ستحافظ عليه، كي تحافظ على نفسها، بإبعاد موضوع الرغبة “الحكمة” Sophia أو “المعرفة”Sapere، ومن هنا تختلف الفلسفة عن باقي الحقول المعرفية الأخرى لأنها توجد من غياب هدفها بالذات. لذلك قال ليوتار في صياغة ذكية بأن نتفلسف ليس معناه أن نرغب في الحكمة بل أن نرغب في الرغبة ذاتها. ويصل بذلك بأن “الفلسفة تنطوي على الحب الذي يمثل ثروتها وأداتها” (في شكل الغياب المستمر).
بكلمات أخرى السعي إلى المعرفة هو الإذعان لحركة الرغبة، ومحاولة فهمها دون حياد أو توقف. والسعي وراء الرغبة هو ما يؤدي إلى ذلك “العناء والحزن والقطيعة وفقد الذات”. والحب المسيحي باختصار -كما أفهمه بالطبع- هو معايشة ذلك الأمر إنسانيًّا. وتلك المصطلحات تسمى دينيًّا درب الآلام الذي ينتهي بالصلب، لكنه مع ذلك يشير إلى القيامة التي هي انتصار الحب (التوحد مع الإلهي).
مع استنكارك لارتباط الألم مع الحب المسيحي “الحب المطلق بشكله المسيحي مؤلم على الدوام” لكنك تتقبلينه بصدر رحب مع المعرفة، وذلك فيما يبدو لي، مرة أخرى، لأننا نعكس موقع المصطلحين. ويتضح ذلك في قولك “المعرفة تقود لأحد تمثلات الحب، تجعل الحب ممكنًا، الحب بلا معرفة مخاطرة بالإيذاء” وهي جملة صحيحة لكن مشروطة بعكسها والتي تؤسسها بالأصل. فلا معرفة ممكنة بلا حب كما فصلتُ لتوّي. بالمناسبة فعل “عَرِف” في العهد القديم تعني الفعل الجنسي. تزوجها وعرفها/لم تعرف رجلاً. المعرفة والرغبة كانا مترادفين في الثقافة العبرانيّة أيضًا.
تتحدثين عن الألم “هو أيضًا له صيرورة، يقلب عالمنا ويخرجنا من التجربة المستقرة التي نكون فيه آلهة صغيرة لنرى أشمل وأبعد“. هذا صحيح تمامًا، وكذلك الحُب الجِذري أيضًا -أيًا كان نوعه، لأن له أنواعًا كثيرة- يفعل هذا بالضبط. وهذا أمر جيد، إذ بغير ذلك ستكون كل معرفة مُرَّة وحزينة، وهذا سينتج في النهاية إرهابًا وإجرامًا -تجاه الآخر والذات- لا كرمًا وانفتاحًا وحياة أفضل. (نيتشه أشار مرارًا، عن حق، إلى ذلك). الحُب ليس التزامًا. الالتزام مفهوم يستدعيه الواجب، ويستدعي فكرة الخارجية. الحُب باطني، وليس له علاقة جوهرية بالواجب. هذا هو الفرق بين المتدين والصوفي مثلاً.
فكرة الالتزام تنبع من الحب نعم، لكن ليس هناك تطابق جوهري. بالعكس، إذا سمعت أحدًا يقول: أنا ملتزم بأولادي، أنا ملتزم بدراستي، أنا ملتزم بهذا النوع من الطعام. أسمع: أنا لا أحب أولادي، لا أحب دراستي، لا أحب هذا النوع من الطعام.
والحُب أيضًا لا يطالب بالاحترام بشكل لازم، يمكن أن يكون تحررًا من هذا “الاحترام”، الحُب الظالم مثلاً والمرغوب مع ذلك، وحضور عنصر السادو-مازوخية بدرجاته في الحب، أمثلة على ذلك. أما عن قولي إني لم أفكر في أنها امرأة، ولا رجل. فذلك لأنه أمر ثانوي بالنسبة لي؛ هي رفيق روحي، يخاطبني فأسمعه، يهمس لي وأنصت له، أحبه وأغار منه وأمسك بيده وأتعارك معه وآنسه.
لم أعد ممن يحصرون الناس، أحياء أو أموات، في أدوار ومسميات، ويرون كل شيء من منظور جزئي كأنهم يقسمون الواقع بالشوكة والسكين إلى مربعات صغيرة يتذوقونها حسب المُسمى، وإذا جاء طعمها مختلفًا تعجبوا أو اتهموها بالفساد. ألهمني جديتها وصدقها وذكاءها، دون اهتمام مسبق بالسوسيولوجيا التاريخية لكتابات النساء الفرنسيات من الطبقة العليا اليهودية في فترة ما بين الحربين. أو كونها أنثى، أو جنسًا ثالثًا أو حوتًا أو نعجة. الحبُ أن نتجاوز التمثيلات للوصول لما هو فردي، لبصمة الروح. مرة أخرى معرفة الآخر، والمعرفة عمومًا، تبدأ بالحب.
فاي بالطبع امرأة، ماذا كانت؟! لكن لم تكن تلك هذه نقطتها. لم تهتم بتنظير المركزية التاريخية لتجربة الرجل، بل عاشت تجربتها بغض النظر، دون التغطي بمفاهيم وتعريفات. بل أدركت بعمق بصريتها أن مشكلة الرجل/المرأة وكل تلك الثنائيات والتناقضات، حلها على مستوى أعمق من صراعات التمثيلات الاجتماعية، مستوى باطني وروحي.
أتخيل فاي تقول مثلاً “ألا تمارس كل القوة في متناول الواحد هو احتمال الهُوة، هذا مناقض لكل قوانين الطبيعة، النعمة وحدها يمكنها فعل ذلك.” فيقال لها بذكاء وتحنيك: آه أنتِ امرأة، حديثنا عن اتصال تجربتك بتاريخ النساء المفكرات. أظن أنها ستدير وجهها للناحية الأخرى وتقول: أوف، لم أقصد ذلك.
ما قصدته بلا نوعية الروح، بلا هوية الألم، أنهما طريق للكلي والمُشترك، وهما مدخلان بالنسبة لي للتعاطي مع خطاب فاي المناوئ والمغاير. بالطبع تشكَّل خطابها/تجربتها عن طريق كونها امرأة، لكن ذلك مجددًا ليس الهدف ولا المعيار لتحديد أطر كلامها. فالأمر كمن جاء صارخًا من وجود حريق ويشير إلى طريق نجاة فننظر إليه بتمعن: أنت ذكر غَيْري من الطبقة الوسطى ذو بشرة فاتحة من أصل قوقازي من بلد ذي تاريخ كولونيالي. هذا خوف من الالتزام بالموقف أو، على مستوى معين، عنف، عنف تجاه ندائه ولوعته، وعدمية -أكاديمية تارة وجمالية تارة أخرى- تجاه الواقع ككل.
بلغة فلسفيّة، الإصرار على الجزئي في مقابل الكلي -رجل/امرأة في مقابل الفرد – فشل في فهم دور الجزئي. هذه الصرعة الما بعد حداثيّة المتذاكية فشلت إلا في أن تدور حول نفسها. لا ترى في الإنسان إنسانًا، بل مجموعة من العوامل الاجتماعية والثقافية والتاريخية. لا تستمع إلى ما يقوله، تشرِّح خطابه في فطنة عدمية لا تؤمن بشيء في النهاية لأنها لا تثق بشيء في البداية. تسد أذنيها ظنًّا أنها لا يمكن خداعها، أو بالأحرى لا تريد أن تُخدع. كتب الصديق مهاب نصر في تعليق ما مؤخرًا عن كتَّاب من هذا النوع “مرعوبون من أن يكون قد غُرر بهم. يواجهون ذلك بالتذاكي وتصنع الجدية وحتى العدمية أحيانًا كأنهم تلقوا الإهانة منذ آدم وتوقعوها”.
خلاصها، إن كانت قد وجدت خلاصًا، ليس “عن طريق العقل وإرادة المعرفة” هذا بالضبط ما يفرقها عن غيرها. وهو بالضبط جوهر خطابها. هي تصيح “الحب الحب”، ونحن نصرُّ “الذكاء الذكاء” أو “الإرادة الإرادة”. كان ميلها للمسيحية كاثوليكيًّا وليس بروتستانتيًّا.
تكتب فاي في مذكراتها الجاذبية والنعمة “الذكاء ليس لديه ما يكتشفه، عليه فقط أن يمهد الأرض. هو نافع فقط لمهام العبودية”. و”نحن نعرف عن طريق ذكاءنا أن ما لا يفهمه الذكاء أكثر حقيقةَ مما يفهمه”. وذلك لأنها كانت تدرك أن كل تلك الأماكن المجهولة وغير المأهولة تنتظر الحب الفائق للطبيعة. الحبُ يصل إلى هذه الأماكن، عقلنا لا.
مينا
5
 سأبدأ رسالتي بالحديث عن الأداء وكيف مارسته فاي، جزء من إشكاليات العالم في رأيي هي فكرة الأداء، أمام الآخر، الذي يحول الذات لمؤد أمام جمهور في ساحة هشة من الاستنزاف، أقول ذلك لأن ما أدهشني عند فاي جزئيًّا هو هذه الذات المنسحبة للداخل المهتمة بطرح السؤال وتجريب الأطروحات بلا هذا الشكل الأدائي المرتبط بالحصول على الاعتراف والإقرار المباشر أو البطيء من ساحة الأداء، حتى إني بحثت عن صوتها كيف كانت تقرأ أو تتكلم حتى الآن لم أجد. في وثائقي عنها يقال إنها كانت تجهد من تحاوره بالأسئلة، قادرة على الحوار لساعات كما يقولون، يثير ذلك التساؤل: لماذا لم تتجه لقنوات الأداء الاستعراضي.
سأبدأ رسالتي بالحديث عن الأداء وكيف مارسته فاي، جزء من إشكاليات العالم في رأيي هي فكرة الأداء، أمام الآخر، الذي يحول الذات لمؤد أمام جمهور في ساحة هشة من الاستنزاف، أقول ذلك لأن ما أدهشني عند فاي جزئيًّا هو هذه الذات المنسحبة للداخل المهتمة بطرح السؤال وتجريب الأطروحات بلا هذا الشكل الأدائي المرتبط بالحصول على الاعتراف والإقرار المباشر أو البطيء من ساحة الأداء، حتى إني بحثت عن صوتها كيف كانت تقرأ أو تتكلم حتى الآن لم أجد. في وثائقي عنها يقال إنها كانت تجهد من تحاوره بالأسئلة، قادرة على الحوار لساعات كما يقولون، يثير ذلك التساؤل: لماذا لم تتجه لقنوات الأداء الاستعراضي.
ما أعجبني أيضًا ولو إن معرفتي بها لاتزال في البدايات، أنها تبدو بشكل مذهل شفافة لدرجة أن كل منا يرى في منتجها مرآة شخصية له، وفي ركن ما من وعيي الخاص هذا مرتبط بأناس “مكشوف عنهم الحجاب” أو المتواصلين مع وعي أشمل لو اكتفينا بحيز المعرفة بمعناها العقلاني، أنا أرى كذلك كل ما هو تطبيقي/ قابل للتطبيق/ يأتي من واقع، صادق وذكي في صيرورة صنع المعرفة، أرى شكل معرفة مغاير ربما ما زلت أتخبط في إطلاق اسم مناسب عليه، أقول أمومية، باطنية، لكن المؤكد أن سيمون تنتمي لخيط طويل من كتاب وكاتبات ونساء تعرفت عليهن ونمى بسببهم الوعي الخاص أنه توجد معرفة أخرى بطرق أخرى، نحاول التدليل عليها بالطريقة العقلانية العلمية الفلسفية.
نقطة أخيرة، منهجية الأنثروبولوجي ترتكن إلى الواقع، هناك العديد من الانتقادات للأنثروبولوجي، منها مثلاً غياب نظرية قوية فنذهب للاسترشاد بفوكو أو بورديو أو آخرين من فروع الفلسفة وعلم الاجتماع وعلم النفس، لكن بكل تأكيد الدراسة الميدانية والإثنوجرافيا اختراع أنثروبولوجي بامتياز، ومن هنا نذهب للميدان نجمع المعلومات ثم نبني عليها تحليلات ونسترشد بإطار يساعد على تنظيمها وتفسيرها وليس العكس.
أقول هذا لأمهد لنقطة الحب التي ما زلت لا أستوعبها من منطلقك، أو أحاول تفكيكها كمفهوم كما أفعل مع الأشياء. أنطلق من إقرارك الدائم بفكرة الحب كطريق نحو الآخر، كأداء يقطع الطريق على الأذى والغل، كاستراتيجية تعاطي وتفادي مع العالم. لا أستطيع هنا إلا أن أستمر في الاندهاش والاندهاش بداية تفكيك وسؤال لماذا أندهش، فالمسألة لا تعنيك فقط بقدر ما تعني لي أيضًا الفهم، أقارن بيني وبينك، لنبدأ من البداية، تجربتك الجندرية وتجربتي الجندرية، تستطيع كرجل أن تصرح بالحب للعالم، لن يفهمك أحد خطأ، سيفهمون القلب المخلص والرغبة الحقيقية في رد الكراهية والحقد والتنافس والمزاحمة، مؤكد أن هذه الاستراتيجية مثمرة والطاقة الإيجابية تجلب طاقة إيجابية، الرسالة أيضًا واضحة للجميع لا أزاحم أحدًا على شيء، أنا هنا ومع الجميع طالما كان في إطار ود، لا أريد الصراعات، لا أريد العنف، لا أريد سلبية، كل منا سيحيل ذلك ربما لمرجعية ثقافية تقليدية في رد الخاطر والدفع بالعطف أو لمرجعية دينية سواء كانت مسيحية أو إسلامية أو حتى إحدى تلك التيارات الحديثة التي تنتج أفكارًا تساعد الإنسان على تجاوز الوحدة في هذا العالم، ومؤكد سنكون (رجال ونساء) سعداء بتلك الطاقة المحبة اللطيفة الآمنة. ماذا سيحدث لو فعلت أنا ذلك؟ بشكل صريح بلا مواربة؟ سيثير ذلك كل خطاب “الهرمونات الملخبطة” وعدم التوازن الأنثوي، على الأقل شكوك خفيفة حول المنطلق والأداء، وربما يستجلب الطمع والاستباحة المجانية، وهو موقف هام لأسباب كثيرة، ما هو موقف الجميع من الحب (الذي لم أحدده بعد) لأن الحب يفترض طرفين أو أكثر، وما هو الموقف الجندري ممن يمنح الحب، بالطبع لو كنت سانت تريزا الأمر سيكون مختلفًا، أو ابن عربي، ولست هذه ولا ذاك، طيب هل يمكنني رغم ذلك أن أمنح الحب (بشكل عملي بلا تصريح) نعم، بشكل مستتر يجوز وسيكون أمرًا محببًا وسأكون “ست لطيفة وطيبة، وذوق، و”بلسم”، هكذا نطلق على المرأة المحبة في المطلق (والرجل كذلك)، لأن الحب يتطلب الاهتمام، بذل الاهتمام ومحو الأذى بالعطف، إذن المسألة أعمق من مجرد الرغبة وطرح الحب كوسيلة تعاطي مع العالم المسألة لها بعد جندري (ذكر/أنثى) وبعد ثقافي، المرأة في المستتر والرجل في العلن وهو أمر مثير جدًا للتفكير على المستوى الإجرائي البحت والرمزي. المرأة للداخل والرجل للخارج، المرأة في الفضاء المحجب والرجل في الفضاء العاري. هل يمكننا التحدث عن تمثل اجتماعي وثقافي لفسيولوجية النوع ذكر/أنثى؟ ولا يسعنا إلا التأقلم مع الثنائيات في الواقع (كما أشار بورديو في كتابه الهيمنة الذكورية).
أعود مجددًا للشكل الإمبريقي، افترضنا أن هناك شخصية ماتريركية (امرأة لها سلطة ما معنوية وعاطفية على الجميع) بالطبع يمكنها أن تمنح الحب بلا شرط أو قيد ولن يكون هناك خطاب الهرمونات ولا الهستيريا، لماذا؟ لأنها تتمتع بسلطة أو عدة سلطات، والسلطة تحصن من السقوط وتجد من يدفع عن صاحبها صفة الابتذال. ثم السلطة تُمنح أيضًا خصوصًا المعنوية، إذن تجربة الحب أيضًا هيراركية في الأخذ والعطاء ليست فقط جندرية، لكن هيراركية قائمة على السن والسلطة المعنوية للمانح، الحب يفترض دومًا اختلال توزان ما بين المانح والمستقبل، هكذا يتحقق شموله، وتكتمل رمزيته في مطلق المنح ومطلق الصد ومطلق عدم التحقق بشكل أفقي: يد تمنح ويد تستقبل/فوق وتحت وبشكل رأسي تاريخي، مطلق الاستمرار، نوع من الماضي المستمر (روميو وجوليت/ قيس وليلى /المسيح وسائر العالم/ديانا وفادي). لاحظ سخافة قصة هاري وميجان!
هنا سأقوم ببعض التنظير الشخصي الذي لا يستند بالضرورة على مصادر بقدر ما يستند على استبطان منطقي. في رأيي الشخصي الحب يمنح مسارًا ضد الموت لأنه يستطيع أن يجعلنا ننسى الحقيقة الوحيدة المؤكدة (مرور الوقت/ فناء الذات في لحظة ما لا نختارها /الوحدة في النهاية) الحب يبطئ /يسرع الوقت ويجعل له أبعادًا أخرى حسب إيقاع الآخر، لذلك عدم التوازن مهم: منح أكثر أو صد أكثر أو يجعل المبالغات حقيقية مثل الأسطورة والشِعر شاهد أصيل على الأمر وشريك أساسي، لأنه ليس فقط تنسى الوقت وتعيد تشكيله وموقعك منه، لكن أيضًا تختار رفض الواقع وتعيد تشكيله في مخيلتك وسيكون الأمر رائعًا، سيغير شعورك سواء منحت أو استقبلت الحب. الحب يفترض تحسين الأمور وتحصين النفس والحياة ضد الموت، عندما تحب رغم أن الغد غير مضمون لكن هناك آخر سيكون هناك معك، لست وحدك، هناك تأمين ما لوقت قادم، والمستقبل مجهول كما الموت، وأنت تواجه حياتك وحدك، إذن الحب يضمن لك لو جاء الغد هناك آخر يمنحك العزاء والونس، لست وحدك ولن تموت بسرعة، أحدهم سيتذكرك حتى لو رحلت، لو نجحت في أن تكون محبًا يتذكرك على الأقل جيلان أو ثلاثة أجيال في حال أنجبت. ما أجمل قصة حب مطلقة؟ هي قصة المسيح، مطلقة في منحها وفي صدها وفي خلودها وفي تواترها.
ليس معنى ذلك أني ضد الحب، أنا ضد ألا نعي به، وألا نرى سوى صورة رومانسية للغاية عن العالم وعن الحياة من خلاله. هل ذلك الوعي مفيد، لا ربما مضر الحقيقة، لكنه شغف المعرفة. وأظن هناك وظيفة أخرى للحب، يجعلنا نتحمل سخافة وثقل الوجود، عبء فعل يوجد. سيمون تتحدث عن الجاذبية أو الثقل كما أحب أن أطلق عليه، العفو هو نوع من الحب، من المنح، يخفف هذا الثقل قليلاً ويجعلنا ننسى. أظن أن الحب يجعلنا ننسى، ننسى هشاشتنا وفناءنا وثقل وجودنا..
فكرة الحب نفسها تمنح الروح السلام.
أمل
6
يثير ردك نقطتين سألتزم بهما منعًا للانجراف. الأولى هي الآخر وعلاقته بالتفكير والأداء، والثانية كلامك عن الحب. في كلتا النقطتين أرى في مركز كلامك خوفًا: كيف سيراني الآخر؟ هل سيراني هستيرية، غير متزنة، طائشة؟
عندي نظرية فيما يخص ما أدهشك عند فاي من “هذه الذات المنسحبة للداخل المهتمة بطرح السؤال وتجريب الأطروحات بلا هذا الشكل الأدائي المرتبط بالحصول على الاعتراف والإقرار المباشر أو البطيء من ساحة الأداء”، باختصار، التحدث بجدية. أو هذا ما أعنيه حين أقول “التحدث بجديّة”؛ سعيًا وجهدًا حقيقيًّا للوصول للهدف دون تكلف أو ادعاء. بعض الناس تقول “صدق” لكني أحبذ لفظة جدية لأنها تشير ربما إلى الأداء الفكري والخطابي لا مطابقة المحتوى (مع الواقع)، فمن الممكن أن أكون صادقًا ولا أزال أقول لغوًا أو تكلفًا، أو هكذا أظن.
 كيف قدرت فاي على فعل ذلك؟ كيف قدرت على التحدُّث بجديّة دون الالتفات القلق إلى صورتها عند الآخر، أو قلق الأداء هذا؟ نظريتي أن الجدية تنبع من شدة الاحتياج أو المعاناة أو الحب. من يريد بالفعل أن يحل أمرًا ملحًا وضروريًّا، سيفكر ويتحدث بالقدر الأكبر من الجدية، لن يراوغ ويصطنع، لن يتجمل ويتكلف، لن يتحدث من الخارج بشكل قشري وبارد. من هذه الزاوية أفهم ارتباط الأخلاق بجودة الكتابة، فكريًّا وجماليًّا.
كيف قدرت فاي على فعل ذلك؟ كيف قدرت على التحدُّث بجديّة دون الالتفات القلق إلى صورتها عند الآخر، أو قلق الأداء هذا؟ نظريتي أن الجدية تنبع من شدة الاحتياج أو المعاناة أو الحب. من يريد بالفعل أن يحل أمرًا ملحًا وضروريًّا، سيفكر ويتحدث بالقدر الأكبر من الجدية، لن يراوغ ويصطنع، لن يتجمل ويتكلف، لن يتحدث من الخارج بشكل قشري وبارد. من هذه الزاوية أفهم ارتباط الأخلاق بجودة الكتابة، فكريًّا وجماليًّا.
أذهب إلى كلامك عن الحب المربوط بصورة الذات عند الآخر. تقولين إني كرجل حين أقول “أحبك أيها العالم” فلن يفهمني أحد خطأ. في الحقيقة توجد مغالطة “إمبريقية” في هذا التصور، لأن الرجل، الذي يقع عليه عادة عبء إعلان الحب، يجابه مخاطر الرفض وسوء الفهم والاستغلال بل والمهانة طوال الوقت. هذا الإعلان للعواطف أو الانجذاب يُقابل كثيرًا بالسخرية والهجوم والعنف.
أما الجانب الآخر، أو خوفك من أن إعلانك الحب سيجابه بالحكم السلبي والاستهزاء والشك، فذلك لأن الحُب دومًا يحتاج إلى شجاعة، أيًا كان نوعه. وهذا ما عنيته حين قلت في رسالتي السابقة إن الحب، مثل الألم، يدفعنا خارج منطقتنا الآمنة والمريحة: ماذا لو فهمت خطأً؟ ماذا لو رُفض حبي؟ ماذا لو سُخر مني؟ ماذا لو احتُقرت؟ ماذا لو أعلنته بشكل خاطئ؟ ماذا لو كان حبي مؤذيًا؟
أتكلم في السياق الرومانسي والأسري والإنساني. الحب دائمًا مخاطرة. في كل مرة أجازف بمبادرة حب أتذكر سطرًا من صلاة يقول “اجعلني أتقبل أن يُساء فهمي”. نعم سوء الفهم مؤلم وأحيانًا مرعب. لكنه ثمن يُدفع لكل ما هو جدير بالإتيان به. لا يوجد فعل حب علني أو حتى خفي لا ثمن له، ثمن غير محسوب، وهذه خطورة الحب. تقولين لو المرأة قوية ستستطيع إعلان وممارسة الحب، هذا دليل على أن الأمر يتعلق بمدى تحمل الهجوم (أو توقع الهجوم) الناتج عن إعلان/فعل الحب أكثر من جنس الفاعل.
لفتني قولك إن السُلطة تحمي من الابتذال، لا أعرف ماذا تعنين بالضبط لكن هذا الأمر جعلني أفكر. وهو ما يستدعي أيضًا أسئلة عن لماذا قصة هاري وميجان سخيفة؟ من أين تأتي السخافة أو الابتذال في الحب؟ هذه الأسئلة مهمة. شخصيًّا كنت أشعر بالسخافة حين أعبر عن حبي لأحد (أمام أحد) ولا يبادلني نفس المشاعر أو يرد بنفس الدرجة -شبهتُ ذلك مرة بالشعور الذي ينتابك حين تلقين التحية على أحد ولا يرد عليكِ.
هناك مفهوم قريب من السخافة والابتذال وأكثر التصاقًا بالحب، وهو الكيتش. هذا الالتصاق يعذب كثيرين، فيتعاملون إما بقبول الكيتشية بصدر رحب وممارستها بمصاحبة نوع من السخرية الذاتية، أو محاولة التذاكي بالابتعاد عن أي تعبير عاطفي قد يثير الشك في كيتشيّته (في العادة يفشل ذلك المسعى ويتم اللجوء في النهاية للاختيار الأول). هناك حقيقة إذن أن الحُب يمكن تفريغه من محتواه، واستغلاله، وخلق كيتشية له تجعله نسخة رديئة من نفسه.
هل تودين في النهاية القول إن الحُب، كشعور وعلاقة وخطاب، له أبعاد اجتماعية وجندرية وهيراركية؟ نعم هذا صحيح بالطبع، لكنه لا يمكن اختزاله في تلك الأبعاد فقط. بالضبط مثل القول إن الحب غريزة البقاء الجنسية مُقنعة، هذا صحيح أيضًا لكنه ليس كل شيء. لستُ مع فريق الاختزال المادي للظواهر المعنوية.
أتفق أيضًا مع الدور الوظيفي الوجودي الذي أشرتِ إليه، يمنح مسارًا ضد الموت، وطريقة لنسيانه: الإيروس والثاناتوس مبدئا الحب والموت المتصارعين. لكن مع ممارسته أيضًا يتضح أن الأمر ليس بهذا التضاد البسيط، فالحب لا “يحصن النفس والحياة ضد الموت” دومًا. كتبتُ في السابق مثلاً مقالاً عن الحب في مواجهة قانون المدينة (أي الأعراف والتقاليد)، وتناولت ثلاثة أمثلة أتبعت الحب فهلكت بأشكال مختلفة؛ شولوميت وأنتيجون ويسوع. الحب ليس فقط مضادًا للموت بل مؤدي له أيضًا، وكما أن الموت سبب للحب فالحب سبب له. والحب الجذري (وهو ما أفرقه عن التصور الرومانسي والسطحي للحب) ليس مجرد مرهمًا لمآسي الوجود، بل يجلب أيضًا الموت في قلب الحياة. يسوع، الذي قلتِ إن له أجمل قصة حب، قال جملاً متوحشة ومرعبة عنه. الحبُ كما يمنح الروح السلام يمنحها أيضًا عصفًا مزعزعًا. أي عاشق يعرف هذا.
ولذلك -وهو تعليق أيضًا على شيء أشرتِ إليه في منتصف كلامك- لا أظن تجنب الصراعات والعنف والسلبية مسلكًا بنَّاءً. ولا يعني التوجه المحب مع العالم والآخرين تجاهل وجود تلك الأمور، بل تعني الاشتباك معها بأمل وصبر. للأسف علينا نحن، من يتخذ الحب كمبدأ حاكم ينتج المبادئ الأخرى، أن نفصله طول الوقت عن التصورات الرومانسية السطحية.
مينا
7
سأتناول بعض النقاط في ردك قبل أن أتجه لعلاقة الحب والموت. أحب كيف تحدثت عن الجدية، مفهوم كامل من الشغف أو على الأقل الاهتمام والبحث والالتزام نحو المعرفة، يكاد يكون منهجًا حقيقيًّا للتعاطي مع العالم، دائمًا ما يثير فضولي البشر الذين لديهم مشروع حقيقي طويل الأمد، يعلمون ليل نهار عليه، العلماء بالطبع، نجيب محفوظ مثلاً يثير دومًا فضولي بجديته وروتينه الجاد، هذا الانخراط بجدية في معترك حياتي ما ينطوي أيضًا على فكرة المسؤولية. أتفق، يجب أن نظل مسؤولين عما منحنا ومنحناه من وجودنا، نوع من التقييد، الذي أدرك أهميته.
النقطة الثانية هي موقع الرجل من الحب، الحقيقة أنا مهتمة منذ فترة بإيجاد صوت الرجل خارج خطاب السلطة والهيمنة والايذاء للمرأة، توصيفك للتوتر وكيف يستقبل الآخرون موقعه من الإعلان يضيف لمعرفتي عن الرجل في حالته العادية، كإنسان. في نقاش عادي مع صديقة كنا نتحدث عن الهشاشة والحساسية المؤذية وكيفية حماية الذات، تحدثنا عن العنف وإذ بها تقول “على فكرة الرجالة هشة هي كمان، وعندها هشاشة أحيانًا كبيرة” كان نوعًا من المعرفة المفاجئة وكقطعة موزاييك بدأت أرى العالم بشكل مختلف وأحاول أفهم الرجل كإنسان بعيد عن كيتش الحقوق وكيتش السلطة وكيتش الأبوية. أحيانًا أستاء كثيرًا من انعدام الثقة بين الرجل والمرأة، أفهم بشكل عميق سلوكيات المرأة العنيفة أو الرافضة أو الدافعة بالشك والتشكيك في البداية، لكنه نتاج عنف طويل ونفي متعمد لكينونة المرأة نفي جسدي ونفسي ووجودي وسوء نية متبادل وتسمم كبير في مجرى العلاقات بينهما. النماذج المريعة من عنف النساء أيضًا هي نتاج تلك السلوكيات المؤذية والعنيفة ضدها. أين موقع الحب هنا؟ الحب في مصر أكبر مصيدة أحيانًا للانكسار والتروما، حالة شديدة من العصف والشك والخوف والمخاطرة، نعلن الحب نرغب في الحب، بل نتزوج وننجب، لكننا في الغالب غير مستعدين للشراكة ولم نفكر فيها.
لكن من يصنع صورة الحب لدينا؟ عندي نظرية ما حول الموضوع، كل ما نقرأ، نشاهد، نستمع من أغاني تصف لنا الحب في حالته المقطرة، شغف خالص، عذاب خالص، تحقق خالص، تكثيف خالص، نستدير لحياتنا ثم نبحث عن ذلك الشيء المميز الخاص بنا الذي سيضيف لقصتنا جانبها المميز، يجب أن نذهب للسينما، نأكل فيشار، نسير طويلاً على الكورنيش، نتبادل أغنيات، تتلامس أيدينا، نتبادل قبلة، نتبادل وعودًا متمثلين المخيلة والخيال، أي نعيش الحب أو حالة الحب. ثم يكون هناك ما ننتظره من الآخر حسب موقعي من الخطاب المجتمعي، حقوقي /أو واجباتي بلا حقوق. في النهاية الحب يصبح علاقة لها مسمى الحب وشكل آخر من التكلس. كل علاقة تحولت للتكلس أمر حزين..
الآن أتكلم عن الحب والموت، ربما تلك النقطة فيها من العاطفية والتجربة أكثر من الفكر والتفكيك، كل هذا السجال حول المعنى الدقيق للحب وكيف نعيه مرتبط في نهاية الأمر بالنوع وبالتجربة الممتدة مع البشر حولنا.
ربما كان يجب البدء من تلك المنطقة قبل تنظير المعاش والوصول لمعان مجردة. لأنني أجهل جزء كبير من تجربتك الخاصة التي أدت لذلك اليقين بالحب، وأنت كذلك ومن هنا جاء التشابك والمراوغة والانتقال من مستوى تنظيري مجرد إلى ما نحن عليه الآن من تداخل التجربة بصياغة وطرح المفاهيم، هل يمكن الحديث عن الحب بلا صور داخلية عنه؟ هل أي فيلسوف تحدث عن الحب أو نظَّر له هل كان منفصلاً عن تجربته؟
مشاعري القوية باختصار تدور حول الموت (موت الأب الرمزي والحقيقي، حالات موت أخرى لأولاد صديقات مقربات)، وربما هو الحاضر طول الوقت في خلفية الوعي، ظلال كبيرة أتفادى المواجهة معها بجدية المسافات وتحيد المشاعر، كل يوم يمر، لا يموت فيه أحد مقرب هو يوم فزت به، لكنه فوز ماض لا يكون أبدًا في حالة آنية. أتساءل كيف كانت ترى فاي الموت؟ ربما لهذا السبب أتعجب من تبشيرك بالحب، لأن في وعيي/لاوعيي حضور الموت دائم، لا أستطيع تجاهل تلك الحقيقة ولا مراوغتها، ربما قلت حدتها مع السنين، ربما استطعت إيجاد مواضع شغف وسعادة مرتبطة بجدية البحث وترك الوقت يمر أحيانًا بهدوء، ثم أعود وأتساءل ماذا لو كانت فكرة الموت غير مسيطرة على كياني، الفقد والفناء والرحيل بلا عودة.. تأكيدك أن الحب طريق آخر للموت شيء حزين جدًا لكنه حقيقي. كنت أتصور أنه مقاومة له، على الأقل يجعلنا ننسى الموت.
ذات مرة سمعت شخصية عامة في حوار راديو يقول إنه قبل الـ35 لم يفكر ولو مرة واحدة في الموت، لم يخطر على باله مطلقًا، أتذكر بدقة أنه قال مطلقًا، كأنه غير موجود!
كيف تكون الحياة بلا فكرة الموت؟
أمل
8
“
أظنني أدركت الآن خريطة الأشياء عندك. وربما كان يجب أن نتحدث في كل ذلك حتى نصل إلى تلك النقطة. بشكل مختزل بالتأكيد، أظن إن ما كان في تصورك حين أقول كلمة “حب” هي تلك الصورة الرومانسية الحالمة سواء لشخص عاطفي وحساس يرمش عينيه في وَجد لمن حوله، أو لعاشقين يتبادلان مظاهر الحب التي وصفتها في ردك. أما المعرفة، فهي الأمر الذي إذا تم السعي إليه بجدية (وسامحيني إن قلت بحب التي تتضمن كلمة شغف التي تستخدمينها) يمكن احتمال وطأة الحياة ومرور الزمن بل ونسيان الموت.
في خريطتي للأشياء الأمر يكاد يكون معكوسًا: المعرفة لحظة زهو يشعر الإنسان فيها أنه حاز معارف تميزه عن الآخرين (بالحق أو بالباطل)، وهي لحظة ساذجة بسبب الحدود القاصرة للغاية للقدرات الإنسانية؛ ما نجهله يجعل ما نعرفه كبشرية جمعاء نكتة سخيفة. أما الحب فهو الطاقة البايو-نفسية، الملموسة، في الكائن البشري، التي تجعله يخرج عن ذاته، منطلقًا إلى موضوع حبه، الآخر، فينسى وطأة وجوده، وينسى فكرة موته أو الأقل يجعل الأمر هينًا أكثر.
بالمناسبة، لا يثير الاختلاف المفاهيمي بيننا مشكلة عندي، فأنا على قناعة أن كل واحد يسعى كي يعيش بشكل جيد، ويتجنب السقوط في الهاوية؛ كل واحد له طريقه وهذا مفهوم تمامًا. المعيار هنا بالنسبة لي هو الإخلاص والجدية، وهذا بالتأكيد عندك. تعليقي الوحيد على موضوع المعرفة، ورغم أني عقلاني تنويري، فإني خلال تجربتي الخاصة وفهمي، أرى المعرفة غير كافية لمواجهة العالم والخلاص فيه (العيش جيدًا، تجنب السقوط، إلخ..) وهذا ما قالته فاي بذكاء دون كلام شعوذي أو شعري.
علاقة الحب بالموت ليست بتلك البساطة، فهو طريق إليه أيضًا، إذا تم اتباعه للنهاية. لأنه القوة المخول لها التصدي للموت في العالم، وفي الصراع مع الموت يحدث الموت. لكن في ذلك الطريق هذا الموت له معنى مختلف، أو يكون له معنى بالأساس، على عكس الموت بلا معنى الشائع. وفي هذا انتصار على الموت. هكذا أفهم قيامة المسيح مثلاً. وفي وعيي لا أفصل بين الحب والموت، ربما كان ذلك تأثير المسيحية عليَّ. في النهاية أنا أميل للكاثوليكيّة مثل فاي، وهذا أمر آخر مشترك بيننا.
الأمر الآخر في علاقة الحب بالموت المتشابكة، أنه ما يجعل للموت وقعًا صادمًا، أعني إذا مات أحد لا نعرفه (ولا نحبه)، فنحن لا نؤذى بالفعل، ربما نشفق على أقربائه أو نشفق على أنفسنا ككائنات فانية، لكن إذا مات أحد نحبه، فإننا نؤذى حقًا، نروَّع، فموت أحد الأبوين أو أحد الأبناء هو أمر مرعب تمامًا. أعرف كثيرين يرفضون الحب فقط بسبب مسألة الفقدان تلك. وهم جادون في رفضهم تمامًا رغم احتياجهم الشديد إليه.
ولذلك أيضًا حين أشرت إلى مخاطر الحب التي يجابهها الرجل، لم أكن أعني إنها حصريًّا تخص الرجل، بصفته من عليه بالمبادرة، أو تخص سياق الحب في مصر، وهي بالتأكيد مشكلات موجودة ولا بد من تناولها. بل أعني أن كل فعل حب بشكل عام يتضمن مخاطر من ضمنها الفقدان (بالموت أو الرحيل أو الرفض أو حتى الانتهاء). وشجاعة الحب هو أن نحب رغم أننا نعرف ذلك، لأن “المحبة قوية كالموت” كما يقول نشيد الأناشيد.
أعرف أن ممارسة أو تبديات الحب عمليًّا تختلف حسب الطبقة والنوع والثقافة، لكن تلك التبديات الجزئية المختلفة ليست كل الموضوع. الحبُ أيضًا هو ما يشترك فيه الرجل والمرأة، تمامًا مثل حديثي عن الألم؛ بالتأكيد، أنثروبولوجيًا التعبير عن الألم والتعاطي معه يختلف بين الرجل والمرأة، لكن في النهاية أظن أن ألم الأسنان مثلاً واحد عندهما. بل هو ما يوحِّد بين الرجل والمرأة. تلك اليونيفرساليّة الجوهرية لمفاهيم مثل الحب والألم والفقدان، يتم تجاهلها الآن لصالح التبديات الاجتماعية والأنثروبولوجية لأسباب في رأيي سياسية (بالمعنى الواسع للكلمة).
اللحظة الوحيدة التي فكرتُ فيها أن فاي كاتبة امرأة، كانت من ثلاث أسابيع حين قال لي أحد أصدقائي إن النساء ضعيفات بالتفكير النظري. فاي جاءت على بالي فورًا وابتسمت. قلت له إني لا أرى كلامه صحيحًا وأكملت الحديث في أشياء أخرى. الحقيقة كنت أرى إصرارك على حكاية جندرية فاي، واستغرابك كيف يعجب وينبهر رجل بكتابة امرأة، بنفس الرؤية لكن معكوسة!
مينا
9
أتفق معك أن الأمر معكوس لدي فيما تسميه خريطة الأشياء، فيما ترى الحب طريق المعرفة وحافظ للنفس من الغرور والزهو ومانح للمعنى، أرى أن المعرفة ربما تقود للحب وربما تكافح سأم الوجود، ومؤكد تحجم كثيرًا الزهو والغرور والإعجاب بالذات. لا خلاف بيننا أننا نسعى للمعرفة الحقيقية كما نردد، على الأقل نحن ضد الادعاء، كل بطريقته ومسعاه، ربما لا أفهم بشكل كلي وواضح بعد لماذا أسلك بتلك الطريقة لا الأخرى، لكني أعتقد أن الأمر أكثر تعقيدًا من لفظي الحب والمعرفة، وما نستطيع قوله والتعبير عنه، على الأقل فيما يخصني.
أعترف أنني لا أستوعب ولا أفهم كيف تقوم بذلك، كيف يكون الحب مسارًا للمعرفة، أتفهم مشاعر التعاطف وردع النفس عن الزهو والتواضع والشفقة والصبر على المعرفة، لكن لفظ الحب إشكالي في تعريفه الدقيق لدي، في رسالتي السابقة أنا فقط فككته وأخذني الكلام لمحاولة فهم ما يصنع مخيلة الحب بالمعنى الدارج ولا عيب في الحب في شكله الذي وصفته على الإطلاق، في التجربة الضيقة للإنسان، الحب هنا محرك ومغير ومحول للشخصية. حاولت تمثل وفهم طريقك الخاص لإيجاد تعريف أستطيع استيعابه، لكن من المؤكد يمكنني تمثل ولو جزئيًّا ما تقوله رغم أني أتصور أن الأمر أكبر من مجرد أن الحب هو المسار والطريق.
أتفق أن هناك ابتذالاً وتسيسًا للهامش وللمفاهيم اليونيفرسالية لصالح قضية نسوية أحيانًا بشكل يثير الحنق ويسيء للقضية، وأعترف أن في داخلي جزءًا نسويًّا راديكاليًّا بشكل ما لا يتعاطف بالضرورة مع الرجل كمفهوم عام مسيطر وكممسك بالسلطة ومنتج للعنف والهيمنة، فلدي هذا الوعي الضاغط المستمر بحجم عالم الرجل ككل، تمثلاته التاريخية وتبعاته الكارثية. لدي إذن هذا الجزء الراديكالي النسوي لكن وجوده ليس عن أيديولوجية عمياء بل عن تجربتي الشخصية، نشأت بين النساء، نساء العائلة من أجيال مختلفة وحكايات عن نساء العائلة ،عندما أعرف نفسي فهو بالمقارنة بنساء وليس بنموذج ذكوري مهيمن كما تفعل النسوية أحيانًا بمحاولة استحضار نموذج قوي لنسوية مسيطرة، ثم إن التجربة المباشرة مع الرجل (كعالم ومكون من المجتمع) لم تكن دائمًا مبنية على ثقة أو ندية على الأقل في المجال العام، لكل النساء العربيات وربما كل النساء بالعالم وهذا واقع فيه مبالغات وربما تجاوزات لكنه حقيقي. ربما أفصل بشكل لاواعي بين المعروف والمجهول، ضحايا هذا العالم الذي يسيطر عليه الرجل، من النساء والرجال وليس فقط النساء، الرجل هنا مفهوم أوسع من مكونه الخاص، هو مفهوم تاريخي وتطبيقي مسيطر على صور المجتمع عن نفسه وعن كيفية السلوك كم يشير بورديو للهيمنة الذكورية.
المزج بين الحب والموت يتطلب شجاعة لا أمتلكها، ووارد أن هناك قصورًا عندي في الاستيعاب وأميل للفصل بينهما، بل والاقتراح أن الحب يسمح بمسيرة ضد اتجاه الموت.
في النهاية، لا يمكنني التقعر أمام التجربة، ببساطة شديدة، هنا مسار للمعرفة قوي ومتين وله رأس وذيل وله مستقبل، من أنا حتى أقول أو أعلق، كل منا سيد تجربته الخاصة، يحملها في كل مكان ويمنح العالم جزءًا منها، أرى روح سيمون فاي هنا، في كل مراحل التجاوز الشخصي للألم ومد اليد “بالحب” للجميع، هي أيضًا صدقت التجربة ورأت قوة الحب.
هذا الحب، أحب أن أراه البحث عما تسميه “الشيء الحلو المختبئ”، هذا السر الباطني العميق، الوهم الجميل أو الفكرة التي تقلقنا، وراء العنف الكلي اليونيفرسالي هناك الشيء الحلو المختبئ، تلاقي الأشياء الحلوة يصنع المعجزات لأننا ببساطة نكون أنفسنا ونود قطعًا التواصل الحقيقي ومنح الآخر جزءًا من هذا الشيء الحلو المختبئ.
ربما هذا ما يمنح الفضول نحو المعرفة كل السحر غير المفهوم، ربما نبحث جميعًا عن ذلك التواصل المفقود، الصوت الأولي الحقيقي، يصوره لنا الشعر جيدًا، تستجديه كل ألعاب الفلسفة ونطلق عليه الحب.
ربما هناك مساحة تفاهم ممكنة الآن، حول هذا الشيء الحلو المختبئ. هناك أيضًا القديسة، سبب كل هذا التراشق المعرفي الرائق، سيمون فاي، فشكرًا لك وشكرًا لها.







